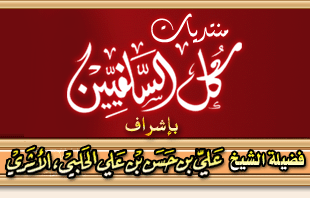


 |
 |
أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
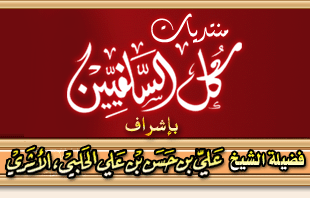 |
 |
 |
|||||
|
|||||||
| 76265 | 98094 |
|
|||||||
 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
شرح كتاب الحجّ من "صحيح الترغيب و الترهيب"
(المقال الأوّل) للشيخ الفاضل أبي جابر عبد الحليم توميات-حفظه الله- السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته فأضع بين أيدي الإخوة الكرام والأخوات الكريمات شرح كتاب الحجّ من " صحيح التّرغيب والتّرهيب " للإمام المنذريّ رحمه الله، بتحقيق لؤلؤة الشّام وحسنة الأيّام الشّيخ محمّد ناصر الدّين الألباني رحمه الله. وذلك لأنّ المسلمين على أبواب هذا المنسك العظيم، حجّ بيت الله تبارك وتعالى، فلا أنسب من أن نتدارس ما جاء فيه من النّصوص الكثيرة، والفضائل الغزيرة. الدّرس الأوّل: قال رحمه الله: ( كِتَـابُ الحَـجِّ ). الشّرح: أوّلاً: التّعريف بالحجّ: الحجّ لغة: قال ابن منظور رحمه الله: "الحجّ: القصد، حجّ إلينا فلان أي: قدم، وحجّه يحُجُّه حجًّا: قصد، وحججتُ فلاناً واعتمدته أي: قصدته، ورجل محجوج أي: مقصود" ["لسان العرب" (3/52)]. ومنه الطّريق المقصود سمّي محَجَّة، ومنه الدّليل المقصود سمّي حجّة. -أمّا الحجّ شرعا: فهو: قصد بيت الله تعالى بصفة مخصوصة، في وقت مخصوص، بشروط مخصوصة. [" التّعريفات " للجرجاني (ص 111)، وانظر: " مغني المحتاج " للشّربيني (1/459)، و" شرح منتهى الإرادات " للبهوتي (1/472)]. ثانيا: تعظيم مكانة الحجّ: دلّ الكتاب والسنّة والإجماع على تعظيم الحجّ ورفع منزلته، حتّى صار وجوب الحجّ معلوما من الدّين بالضّرورة، وهو واجب مرّة واحدة في العمر. أمّا دليل الكتاب: فقوله تعالى:{وَللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَـاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِىٌّ عَنِ الْعَـالَمِينَ} [آل عمران:97]. قال ابن العربيّ المالكيّ:" قال علماؤنا: هذا من أوكد ألفاظ الوجوب عند العرب، فإذا قال العربيّ: لفلان عليّ كذا فقد وكّده وأوجبه، قال علماؤنا: فذكر الله سبحانه الحجّ بأبلغِ ألفاظ الوجوب، تأكيداً لحقّه، وتعظيماً لحرمته، وتقوية لفرضه " ["أحكام القرآن" (1/285)]. وقال القرطبي رحمه الله: "فذكر الله الحج بأبلغ ألفاظ الوجوب تأكيداً لحقه وتعظيماً لحرمته، ولا خلاف في فريضته، وهو أحد قواعد الإسلام، وليس يجب إلاّ مرّة في العمر "[" الجامع لأحكام القرآن " (4/142)]. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " وحرفُ (على) للإيجاب، لا سيما إذا ذكر المستحقّ فقيل: لفلان على فلان، وقد أتبعه بقوله:{وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِىٌّ عَنِ الْعَـالَمِينَ} ليبيّن أنّ من لم يعتقد وجوبه فهو كافر، وأنّه وضع البيت وأوجب حجّه {لِيشْهَدُواْ مَنَـافِعَ لَهُمْ} [الحج:28]، لا لحاجة إلى الحجاج كما يحتاج المخلوق إلى من يقصده ويعظمه؛ لأن الله غني عن العالمين "[" شرح العمدة " (1/76- المناسك)]. فبلاغة هذه الآية ظاهرة من وجوه عديدة: أ) أنّ اللاّم للاستحقاق كما بيّنه شيخ الإسلام. ب) أنّه قدّم الجار والمجرور لإفادة التّوكيد تعظيما لحرمة هذا الواجب، وترهيبا من تضييعه. ج) أنّه أتى بحرف الجرّ الدالّ على الإلزام. د) نكّر السّبيل للإطلاق، فعلى أيّ سبيل أمكن وجب. هـ) وسمّى تركه كفرا، قال سعيد بن جبير رحمه الله: " لو مات جار لي وله ميسرة ولم يحجّ لم أُصلِّ عليه ". و) وأنّ الله غنيّ عن طاعة عبده إذا تركها، حميد له إن فعلها، ولم يقل: ( غنيّ عنه ) ولكنّه قال: (غنيّ عن العالمين). وأمّا دليل السنة: فقد وردت أحاديث كثيرة تدل على ذلك منها: 1-عن عبد الله بن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله صَلَّى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانِ )) [البخاري ومسلم]. 2-حديث جبريل عَلَيْهِ السَّلاَمُ المشهور وفيه: ما الإسلام ؟ قال صَلَّى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ البَيْتَ إِنْ اِسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً )) الحديث [رواه مسلم]. 3-عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: خطبنا رسول الله صَلَّى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمْ الحَجَّ فَحُجُّوا )) فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله ؟ فسكت حتّى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صَلَّى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( لَوْ قُلْتَ: نَعْمَ لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ )) [رواه مسلم]. وأمّا دليل الإجماع: فقال ابن المنذر رحمه الله:" وأجمعوا أنّ على المرء في عمره حجّة واحدة " ["الإجماع"ص16]، وممّن نقله كذلك ابن عبد البرّ في "التّمهيد" (21/52)، وابن قدامة في "المغني" (5/6)، وابن تيمية في "شرح العمدة" (1/87 المناسك)، وغيرهم رحمهم الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فكل من لم يَر حج البيت واجباً عليه مع الاستطاعة فهو كافر باتفاق المسلمين" [التفسير الكبير لابن تيمية (3/227)]. ويستحبّ الحجّ كلّ عام. ويُكره تركُه أكثر من خمس سنوات، فقد روى ابن حبّان عن أبي سعيد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنّ رسول الله صَلَّى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: (( يَقُولُ اللهُ: " إِنَّ عَبْدًا صَحَّحْتُ لَهُ جِسْمَهُ، وَوَسَّعْتُ عَلَيْهِ فِي المَعِيشَةِ تَمْضِي عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَعْوَامٍ لاَ يَفِدُ إِلَيَّ لَمَحْرُومٌ" !! )). ثالثا: متى فرض الحجّ ؟ اختلف العلماء في ذلك، فقيل: فرض سنة ست، وقيل: سنة سبع، وقيل: سنة ثمان، وقيل: سنة تسع، وقيل: سنة عشر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وسورة آل عمران إنما نزل صدرها متأخراً لما قدم وفد نجران بالنقل المستفيض المتواتر، وفيها فرض الحج، وإنما فرض سنة تسع أو عشر، لم يفرض في أول الهجرة باتفاق "[" التفسير الكبير " (7/471)]. قال ابن القيم رحمه الله: "لا خلاف أنه لم يحج بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة واحدة، وهي حجة الوداع، ولا خلاف أنها كانت سنة عشر. ولما نزل فرض الحج بادر رسول الله صَلَّى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى الحج من غير تأخير. فإن فرض الحج تأخر إلى سنة تسع أو عشر " [" زاد المعاد " (2/101)، وانظر:" الجامع لأحكام القرآن " للقرطبي (4/144)، و" الروض المربع " (3/499)]. رابعا: شروط وجوب الحجّ. اعلم أنّ شروط الحجّ خمسة، أربعة مشتركة بين الرّجال والنساء، وواحد خاصّ بالنّساء: 1) العقل. 2) البلوغ. 3) الحرّية. فلو حجّ المجنون، والصّبيّ، والعبد، صحّ حجّهم، لكن لو أفاق المجنون، وبلغ الصّبيّ، وأعتق العبد، وجب عليه الحجّ مرّة أخرى عند جميع العلماء، وذلك لما رواه الطّبراني في " الأوسط "، والحاكم، والبيهقيّ عن ابن عبّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنّ النبيّ صَلَّى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: (( أيّما عبدٍ حج ثمّ عتق فعليه حجّة أخرى، وأيّما صبيّ حجّ ثمّ بلغ الحنث فعليه حجّة أخرى.. )) ["إرواء الغليل" (4/156)]. 4) القدرة: والمقصود بالقدرة صحّة البدن، والزّاد والرّاحلة للعاجز. 5)و جود المحرَم، وهو خاصّ بالمرأة، وهذا مذهب الحنفيّة والحنابلة والشّافعيّة، خلافا للمالكيّة الّذين اكتفوا باشتراط الرّفقة الآمنة، والصّواب هو قول الجمهور، بدليل ما رواه البخاري ومسلم عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ )) فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ ؟ فَقَالَ: (( اخْرُجْ مَعَهَا )). ووجه الدّلالة من أوجه: أوّلها: أنّ اللّفظ عام، لم يستثن حالة واحدة. ثانيها: أنّه لا يُعقل أنّها تكون خرجت وحدها تريد الحجّ، فلا ريب أنّها خرجت في قافلة. ثالثها: أنّها سافرت مع أكثر الرّفاق أمنا، وهم أصحاب رسول الله صَلَّى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رابعها: أنّ زوجها كان له أعظم عذر، وهو الجهاد في سبيل الله. ومع ذلك كلّه يقول له النبيّ صَلَّى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( اخرج معها )). خامسا: هل يجب الحجّ على الفور ؟ خلاف كبير بين العلماء، والصّحيح وجوبه على الفور متى استطاع إليه سبيلا، وذلك لما رواه أحمد والبيهقي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ يَعْنِي الْفَرِيضَةَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ )). ["الإرواء" (4/168)]. فائدة: سؤال قد يُورِدُه الكثيرون، وهو حكم من استطاع الحجّ وفي الوقت نفسه يريد الزّواج، ولو حجّ فاتته القدرة على الزّواج، ولو تزوّج فاتته القدرة على الحجّ ؟ فالجواب: أنّ العلماء الّذين ذهبوا إلى أنّ الحجّ يجب على الفور قرّروا أنّ من خشِي على نفسه العنت والوقوع في المحرّم، وجب عليه الزّواج أوّلا، ثمّ إذا يسّر الله له الحجّ بعد ذلك حجّ. ومن لم يكن حاله كذلك فيحجّ ثمّ يتزوّج، والله أعلم. |
|
#2
|
|||
|
|||
|
شرح كتاب الحجّ من " صحيح التّرغيب والتّرهيب " (المقال 2) .الباب الأوّل قال رحمه الله تعالى: " 1-( التّرغيب في الحجّ والعمرة، وما جاء فيمن خرج يقصدهما فمات ) الشّرح: مجموع ما ذكره المصنف رحمه الله في كتاب الحجّ 122 حديثا، وذكر في هذا الباب ( التّرغيب في الحجّ والعمرة ) 22 حديثا، وهذه الأحاديث تنصّ على أنّ الحجّ: أ) من أفضل الأعمال. ب) أنّه سبب لتكفير الذّنوب والخطايا حتّى يعود منه الحاجّ كيوم ولدته أمّه. ج) وأنّ العمرة إلى العمرة تكفّر ما بينهما، ولكنّ الحجّ ليس له جزاء إلاّ الجنّة. د) أنّ النبيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سمّاه جهادا. هـ) أنّه من أركان الإسلام. و) أنّه سبب لذهاب الفقر كما يُذهب الذّنوب. ز) أنّ الحاجّ وافد على الله تعالى. ح) أنّه اشتمل على جميع العبادات العظيمة. ط) أنّ العازم على الحجّ لو مات فهو باقٍ على حجّه. ونأتي على شرح الحديث الأوّل وهو في " صحيح التّرغيب والتّرهيب برقم (1094): قال رحمه الله : ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: (( إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ )). قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ: (( الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ )). قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ: (( حَجٌّ مَبْرُورٌ )). [رواه البخاري ومسلم] ). وفي هذا الحديث فوائد: الفائدة الأولى: قال النّووي رحمه الله:" ذكر في هذا الحديث الجهاد بعد الإيمان، وفي حديث أبي ذرّ لم يذكر الحجّ وذكر العتق، وفي حديث ابن مسعود بدأ بالصّلاة ثم البرّ ثمّ الجهاد، قال العلماء: اختلاف الأجوبة في ذلك باختلاف الأحوال، واحتياج المخاطبين، وذكر ما لم يعلمه السّائل والسّامعون وترك ما علموه ". الفائدة الثّانية: في الحديث دلالة على أنّ الإيمان عمل، لذلك ترجم عليه البخاري قائلا: (بَاب مَنْ قَالَ إِنَّ الْإِيمَانَ هُوَ الْعَمَلُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:{ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ }، وَقَالَ عِدَّةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:{ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ }: عَنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ). فهنا كذلك، لمّا قيل له: أيّ الأعمال أفضل ؟ قال: إِيمَانٌ بِاللهِ .. الحديث. الفائدة الثّالثة: فإن قيل: لم قدّم الجهاد وليس بركن على الحجّ وهو ركن ؟ فهناك جوابان: أنّ نفع الحجّ قاصر غالبا على الحاجّ، ونفع الجهاد متعدّ، فقدّمه في الذّكر لذلك. أو قال ذلك حيث كان الجهاد فرضَ عين، تحتاج إليه دولة الإسلام الفتيّة، فكان أهمّ منه فقدّم، والله أعلم. الفائدة الرّابعة: قوله: ( حجّ مبرور ): أي مقبول، ومنه قولهم: برّ حجّك، أي: قُبِل. وقيل: المبرور الّذي لا يخالطه إثم ولا رياء ولا سمعة، مأخوذ من البرّ أي: الطّاعة، ومنه برّ فيه يمينه أي صدق، ومنه: أبرّ الله قسمه أي: جعله صادقا. وهذه المعاني كلّها صحيحة، لأنّ المقبول هو الّذي لا يخالطه إثم ولا رياء فيه وصدق فيه الحاجّ. وذكر المصنّف طرفا من حديث رواه الإمام أحمد والطّبراني في " الأوسط "-واللّفظ له-، وأعاده تحت رقم (11)، وفيه: عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( الحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةَ )) قِيلَ: وَمَا بِرُّهُ ؟ قَالَ: (( إِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَطِيبُ الكَلاَمِ )). وفي هذا تنبيه لطيف إلى أنّ الحجّ المبرور ليس فقط بالبُعد عن المحرّمات وفعل الواجبات، بل يكون مبرورا بالحرص على أعمال البرّ، وهو إطعام الطّعام، وطيب الكلام، وكأنّه تفسير لقوله تعالى:{لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ} [البقرة:177]. الفائدة الخامسة: قال النّوويّ رحمه الله:" من علامة القبول أن يرجع خيرا ممّا كان عليه ". فنسأل الله التّوفيق والقبول. |
|
#3
|
|||
|
|||
|
شرح كناب الحجّ من " صحيح التّرغيب والتّرهيب " (المقال 3) دائما تحت الباب الأوّل، وهو: ( التّرغيب في الحجّ والعمرة، وما جاء فيمن خرج يقصدهما فمات ) الحديث الثّاني: وهو في " صحيح التّرغيب والتّرهيب " تحت رقم (1095) قال رحمه الله: " وَعَنْهُ [أي: عن أبي هُرَيْرَةَ] قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: (( مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ )). [رواه البخاري ومسلم والنّسائي وابن ماجه والتّرمذي، إلاّ أنّه قال: (( غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ))]. الفائدة الأولى: في شرح ألفاظ الحديث: - ( مَنْ حَجَّ ): جاء في رواية مسلم: (( مَنْ أَتَى هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ )) فهي مطلقة تدخل فيها العمرة كذلك، ولكنّ هذه الرّواية تقيّد ذلك الإطلاق، فيكون المقصود منها الحجّ فحسب. - ( فلم يرفُثْ ): الرّفث له ماعن أربع: 1-إذا تعدّى بـ(إلى) كان معناه الجماع، لقوله تعالى:{ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمِ} [البقرة: من الآية187]، فسّره بذلك ابن عبّاس ومجاهد وقتادة وغيرهم. 2-ويطلق أيضا على مجرّد الملامسة. 3-ويطلق على الكلام الّذي يكون مقدّمة للجماع، قال ابن عبّاس رضي الله عنه:" الرّفث ما روجع به النّساء ". لذلك قال الزجّاج والأزهريّ: هي كلمة جامعة لكلّ ما يريده الرّجل من امرأته. 4-ويطلق على الكلام القبيح - كما في " لسان العرب " -، ويؤيّده حديث: (( وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ )). فكذلك المقصود به في هذا الحديث ما هو أعمّ من الجماع. - قوله: ( وَلَمْ يَفْسُقْ ) أي: لم يأت بمعصية كغيبة وسبّ وأكل حرام وغير ذلك. وأصل الفسوق في اللّغة هو" الخروج، تقول العرب: فسقت الحبّة عن قشرها، أي: خرجت. والفسوق شرعا هو: الخروج عن طاعة الله تعالى. - وقوله صلّى الله عليه وسلّم: (( رَجَعَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ )) عموم يفيد أنّه يكفّر الكبائر والصّغائر، وذلك لما اشتمل عليه الحجّ من الأعمال الجليلة التي تكفّر الذّنوب، واطّلاع الله على عباده يوم عرفة، وكثرة الذّكر، والصّلاة، والطّواف، والوضوء، ورمي الجمار، والإهلال بالتّوحيد، والإخلاص الّذي هو تاج الأمور كلّها. لذلك جاء في رواية التّرمذي الّتي ذكرها المصنّف: (( غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ))، أي: كبيره وصغيره. وقد قال الشّيخ الألباني رحمه الله في تعليقه:" هو بهذا اللّفظ شاذّ، لكنّ المعنى واحد " اهـ. الفائدة الثّانية: الرّفث إلى النّساء مراتب: 1- فمنه ما يُنْقِصُ أجر الحاجّ ولا يُبطِلُه، كالملامسة والتّقبيل. وفي هذه الحالة أفتى ابن عبّاس رضي الله عنه ومجاهد وعليه الجمهور: بأنّ عليه ذبحَ شاة. 2- أمّا الرّفث بمعنى الجماع، ففيه تفصيل: أ) إن جامع قبل التحلّل الأوّل: فهذا حجّه باطل، وعليه ثلاثة أمور: الأوّل: إتمام حجّه. والثّاني: قضاؤه العام القابل. والثّالث: أنّه يجب عليه بُدْنةٌ أو سبعٌ من الغنم. [ومعنى التحلّل الأوّل أن يفعل اثنين من ثلاثة –وسيأتي تفصيله-: رمي الجمار يوم النّحر، وطواف الإفاضة، والحلق أو التقصير]. ب) إن جامع بعد التحلّل الأوّل: فهذا حجّه صحيح وعليه ذبح شاة. فمثلا: لو رمى الجمرة يوم النّحر وحلق أو قصّر، حلّ له كلّ شيء: فله أن يمسّ الطّيب، ويلبس ثيابه، إلاّ النّساء، فلا يجوز له إتيانهنّ حتّى يَطُوف طواف الإفاضة. أمّا لو جامع قبل طواف الإفاضة، يكون قد جامع قبل التحلّل الثّاني، فهذا تـمّ حجّه، ولا قضاء عليه، ولكن عليه دم وهو ذبح شاة. الفائدة الثّالثة: قد يسأل سائل ويقول: لماذا قال ( كيَوْمَ ) بفتح الميم، مع أنّ الكاف حرف جرّ تجر ما بعدها ؟ فالجواب: أنّ كلمة ( يوم ) إذا أضيفت إلى الجمل نزلت منزلة ( إذْ ) فيجوز فيها وجهان البناء والإعراب، فتقول: كيومِ ولدته، ويومَ ولدته. ومنه قراءة نافع:{ هذا يومَ ينفع الصّادقين صدقهم }، وقرأ الباقون: { هَذَا يَوْمُ }. والأحسن أن تُبنَى إذا جاء بعدها فعل ماض، كهذا الحديث. وتعرب بالجرّ إذا جاء بعدها فعل مضارع أو جملة اسميّة. والله تعالى أعلم. |
|
#4
|
|||
|
|||
|
شرح كتاب الحجّ (4) شرح الحديث الثّالث من ( الباب الأوّل ) برقم (1096) قال رحمه الله: 1096-وَعَنْهُ [أي: أَبِي هُرَيْرَةَ] رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (( الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ )). [رواه مالك والبخاري ومسلم والتّرمذي والنّسائي وابن ماجه]. • الفائدة الأولى: شرح ألفاظ الحديث: - ( العمرة ): العمرة معناها في اللّغة الزّيارة، لأنّ من شأن الزّائر أن يعمُر المكان. وفي الشّرع هي:" زيارة بيت الله تعالى بقصد التعبّد ". والفرق بين تعريفها وتعريف الحجّ، أنّ الحجّ هو زيارة بيت الله تعالى بقصد التعبّد في زمن خاصّ. أمّا العمرة فلا تُحدّد بزمن. - ( كفَّارة ): أي: ماحيَةٌ للذّنوب، وأصل مادّة ( كفَر ) هو التّغطية، ومن شأن الشّيء المُغطَّى أن لا يكون له أثر، ولذلك سمّي الكافر كافراً لأنّه جحد الحقّ وغطّاه ولم ينطق به ولم يعمل به. ومنه ( الكَفْر ) يطلق على المكان الّذي كثرت به الأشجار والمزارع لأنّه غُطِّي بها. ويسمّى المُزَارع ( كافراً ) لأنّه يغطّي الحبّة بالتّراب في الأرض كما قال تعالى:{ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ } أي: الزُرّاع. ومن الطّرائف أنّ أحد الدّعاة شرح هذه الكلمة على نحو ما ذكرناه في إحدى القُرى، فنبذوه ورموه بتكفير الفلاّحين !! وصدق من قال: ( لكلّ مقام مقال ). - ( الحجّ المبرور ): سبق بيان معناه، وهو أنّ البرّ في الحجّ له مرتبتان: الأولى أن يكون خاليا من الإثم، والثّانية: أن يقوم فيه صاحبه بالإحسان إلى غيره. • الفائدة الثّانية: حكم العمرة. مذهب المالكيّة والحنفيّة استحباب العمرة. ومذهب الحنابلة والشّافعيّة أنّها فرض كالحجّ، وهو الصّحيح - إن شاء الله - لدليلين: 1) حديث جبريل المشهور، ففي بعض الرّوايات قال: ما الإسلام ؟ قال صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( الإِسْلاَمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ..-حتّى قال-: وَأَنْ تَحُجَّ البَيْتَ وَتَعْتَمِرَ.. )). [أخرجه ابن خزيمة كما في " صحيح التّرغيب والترهيب " رقم (175) ]. 2) ما رواه أبو داود والنّسائي عَنْ الصُّبَيِّ بْنِ مَعْبَدٍ قال: أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ! إِنِّي كُنْتُ رَجُلًا أَعْرَابِيًّا نَصْرَانِيًّا، وَإِنِّي أَسْلَمْتُ، وَأَنَا حَرِيصٌ عَلَى الْجِهَادِ، وَإِنِّي وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَيَّ .. وَإِنِّي أَهْلَلْتَ بِهِمَا مَعًا فَقَالَ لِي عُمَرُ رضي الله عنه: هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ".["الإرواء (4/153)"] ووجه الدّلالة قوله ( وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَيَّ ) فأقرّه عمر بن الخطّاب رضي الله عنه، وهو راوي حديث جبريل السّابق، فلا شكّ أنّ فهمه مقدّم على غيره. • الفائدة الثّالثة: في حديث الباب دلالة على استحباب الاستكثار من الاعتمار، خلافا لقول من قال يُكره أن يعتمر في السَنة أكثر من مرَّة كالمالكية رحمهم الله، وخلافا لمن قال: تستحبّ مرّة في الشّهر. وغاية ما استدلّوا به أنّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يفعلها إلاّ مرّة في السّنة حين استطاع، وأفعاله تدورُ بين الوجوب والنّدب. والجواب عن ذلك من وجهين: أوّلا: إنّ المندوب لا ينحصر في أفعاله فحسب، فقد كان صلّى الله عليه وسلّم يترك الشّيء وهو يستحبّ فعله لرفع المشقّة عن أمّته. ثانيا: قد ندب صلّى الله عليه وسلّم إلى الإكثار من الاعتمار بلفظه، فثبت الاستحباب من غير تقييد. قال ابن القيّم في "الزّاد" (2/100): "وفي قوله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( العمرة إلى العمرة كفّارة لما بينهما، والحجّ المبرور ليس له جزاء إلاّ الجنّة )) دليل على التّفريق بين الحجّ والعمرة في التّكرار، وتنبيه على ذلك، إذ لو كانت العمرة كالحجّ لا تُفعل في السّنة إلاّ مرّة لسوّى بينهما ولم يفرّق. وروى الشّافعي رحمه الله عن عليّ رضي الله عنه أنّه قال:" اعتمر في كلّ شهر مرّة ". وروى وكيع: قال عليّ رضي الله عنه: " اعتمر في الشّهر إن أطقتَ مرارا ". وذكر سعيد بن منصور عن بعض ولد أنسٍ رضي الله عنه أنّ أنسا كان إذا كان بمكّة فحمّم رأسه، خرج إلى التّنعيم فاعتمر "اهـ. أي: بمجرّد ما يعتمر ويحلق، وينبت أوّل شعر رأسه، يخرج إلى التّنعيم ويعتمر مرّة أخرى [والعمرة من التّنعيم قد كثر الكلام فيها وليس الموضع موضع بسطها، ولكنّ الأثر حجّة لمن ذهب إلى جوازها، فهي لديهم ليست خاصّة بالحُيّض]. والله تعالى أعلم. |
|
#5
|
|||
|
|||
|
شرح كتاب الحجّ (5) شرح الحديث الرّابع من ( الباب الأوّل ) برقم (1097) قال رحمه الله: وَعَنْ ابْنِ شُمَاسَةَ قَالَ: حَضَرْنَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ رضي الله عنه وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ الْمَوْتِ، فَبَكَى طَوِيلًا، وَقَالَ: " فَلَمَّا جَعَلَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ فِي قَلْبِي أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: ابْسُطْ يَمِينَكَ لِأُبَايِعَكَ. فَبَسَطَ يَدَهُ، فَقَبَضْتُ يَدِي، فَقَالَ: (( مَا لَكَ يَا عَمْرُو ؟! )) قَالَ: قُلْتُ: أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ. قَالَ: (( تَشْتَرِطُ مَاذَا ؟ )). قَالَ: أَنْ يُغْفَرَ لِي. قَالَ: (( أَمَا عَلِمْتَ يَا عَمرُو ! أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ ؟! )). [رواه ابن خزيمة في "صحيحه"هكذا مختصرا. ورواه مسلم وغيره أطول منه]. • الشّرح: - قوله: ( وَعَنْ ابْنِ شُمَاسَةَ ): هو عبد الرّحمن بن شُماسة- بضمّ الشّين وفتحها- المهريّ المصريّ. -قوله: ( وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ الْمَوْتِ ): أي حال حضور الموت، وبعضهم يقول: هو في السَّوق- بفتح السّين-، وكلّ ذلك مأخوذ من قوله تعالى:{ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ }. - قوله: ( فَبَكَى طَوِيلاً ): هذه الرّواية مختصرة، وتمامها-كما في صحيح مسلم-: " وَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى الْجِدَارِ، فَجَعَلَ ابْنُهُ يَقُولُ: يَا أَبَتَاهُ ! أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَذَا ؟! أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَذَا ؟! قَالَ: فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: إِنَّ أَفْضَلَ مَا نُعِدُّ ( شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ )، إِنِّي كُنْتُ عَلَى أَطْبَاقٍ ثَلَاثٍ [أي: على مراحل وأحوال ثلاث]: لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَمَا أَحَدٌ أَشَدَّ بُغْضًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّي، وَلَا أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَكُونَ قَدْ اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ فَقَتَلْتُهُ، فَلَوْ مُتُّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَكُنْتُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ .." ثمّ ذكر الحديث. ولعلّ كثيرا منّا يتشوّق إلى معرفة ما البِشارة الّتي يقصِدها ولده ؟ الجواب تراه في الحديث الّذي رواه الإمام الرّويانيّ في " مسنده " عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنّ النبيّ صلّى الله علَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (( أَسْلَمَ النَّاسُ، وَآمَنَ عَمْرُو بْنُ العَاصِ )). [" الصّحيحة "ج1 رقم 155]. وفي رواية للإمام أحمد: (( اِبْنَا العَاصِ مُؤْمِنَانِ: هِشَامٌ وَعَمْرٌو )). - قوله: ( قَالَ: تَشْتَرِطُ بِمَاذَا ): من المقرّر أنّ أداوت الاستفهام لها الصّدارة، أي: لا يقال: ( فعلت ماذا ؟)، (ولكن يقال: ماذا فعلت ؟). فكيف جاز هنا أن تتأخّر أداة الاستفهام ؟ يمكن أن يُجاب عنه بأحد أجوبة ثلاثة: أن يقال: إنّ هذا دليل على الجواز وهو قليل. أو يقال: إنّ الأصل الاستفهام بـ( ما )، فإذا اقترنت بها ( ذا ) ضعفت فتأخّرت، وهذا جواب شيخنا عليّ حمد الله. أو يقال: إنّ ثمّة استفهامين منفصلين، فأوّلا قال له متعجّبا: تشترط ؟ ثمّ قال له: ماذا ؟ وهو كثير في كلام العرب. - ( أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ ): لقوله تعالى:{ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ }. - ( وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ ): والتّعبير بالهدم فيه مبالغة للدّلالة على محو الذّنوب، وما ارتُكِب من معاصٍ في حقّ علاّم الغيوب. أمّا المرحلة الثّانية من حياته رضي الله عنه الّتي عناها، فهي يوم صار النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أحبّ خلق الله إليه، قال: (وَلَوْ مُتُّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ). والمرحلة الثّالثة من حياته رضي الله عنه، فبعد وفاة النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، وصار بعدها واليا على مصر، قال: ( ثُمَّ وَلِينَا أَشْيَاءَ مَا أَدْرِي مَا حَالِي فِيهَا ). • فوائد الحديث: 1- في الحديث بيان لفضل عمرو بن العاص رضي الله عنه، وما كان عليه من الخوف والخشية من الله. 2- وفيه دلالة على حرص النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على تبشِيرِ من رجع إلى الله وتاب إليه، فهو القائل صلّى الله عليه وسلّم: (( بَشِّرُوا ولاَ تُنَفِّرُوا ))، ويكون ذلك ببيان محاسن الإسلام، وسعة رحمة وفضل الله. ووجه الدّلالة من الحديث، أنّه حين قال عمرو رضي الله عنه: ( أريد أن أشترط )، ما قابله بالتّعنيف، ولا أجابه بالرّفض، وأنّه ليس له أن يشترط شيئا، وأنّ المنّة لله ... إلى غير ذلك ممّا قد يفعله النّاس، ولكنّه استفسر منه برفق: ((تَشْتَرِطُ بِمَاذَا؟)) 3- قال النّوويّ رحمه الله: " وفيه استحباب تنبيه المحتضِر على إحسان ظنّه بالله سبحانه وتعالى، وذكر آيات الرّجاء وأحاديث العفو عنده، وتبشيره بما أعدّه الله تعالى للمسلمين وذكر حسن أعماله عنده، ليحسن ظنّه بالله تعالى ويموت عليه. وهذا الأدب مستحبّ بالاتّفاق، وموضع الدّلالة له من هذا الحديث قول ابن عمرو لأبيه: أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم بكذا ؟ "اهـ. وصدق رحمه الله، فقد روى مسلم عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَبْلَ وَفَاتِهِ بِثَلَاثٍ يَقُولُ: (( لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ بِاللَّهِ الظَّنَّ )). ولذلك ينبغي للمسلم أن يُوصِي أهله أنّه إذا حانت ساعة الاحتضار أن يُحضِروا أهل العلم والصّلاح، فهم أفقه النّاس بهذه الأحوال. 4-إسلام الكافر يهدم ما قبله ولو كان الذّنب متعلّقا بحقوق العباد، وكلّ ما سلبه الكافر من المسلم قبل إسلامه، فإنّه يبقى ذلك له إذا أسلم، وذلك لعموم الحديث، ولعموم قوله تعالى:{ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ }، وهو مذهب أكثر العلماء، وذلك تأليفا لقلبه على الإسلام. وإذا يسّر الله لي بسطت هذه المسألة في موضع آخر إن شاء الله. ولكن يجب عليه بمجرّد إسلامه أن يتخلّص من العقود الفاسدة كالرّبا، أو الزّواج من وثنيّة، أو الزّواج بأكثر من العدد المباح، وغير ذلك ممّا لا يُقرُّ عليه. 5- فيه فضل الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، وأنّها تهدم ما تقدّم من الذّنوب. 6- والشّاهد من الحديث، أنّ الحـجّ يمحو الله به الخطايا والذّنوب، حتّى يكون العبد - كما مرّ معنا في حديث- (( كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ )). وذلك لإخلاصه، وتوبته، وأعماله الصّالحة، وسيأتي من الأحاديث ما يُبيّن أنّ للحاجّ بكلّ خطوة يخطوها أو تخطوها دابّته حسنة وتُمحى بها خطيئة، وأنّ له بكلّ شعرة يحلقها محو خطيئة، وأنّ له بكلّ حصاة يرميها تكفير كبيرة من الكبائر، وأنّ الله يقول لأهل الموقف قائلا: ((( فَإِنِّي أُشْهِدُ نَفْسِي وَخَلْقِي أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، وَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُهُمْ عَدَدَ أَيَّامِ الدَّهْرِ، وَعَدَدَ رَمْلِ عَالِجٍ ))، ويقول الملك للحاجّ إذا انصرف من حجّه: (( اِعْمَلْ فِيمَا تَسْتَقْبِلْ، فَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا مَضَى )). فلا جرَم أنّ الحجّ يجبّ ما قبله، نسأل الله التّوفيق والسّداد. |
|
#6
|
|||
|
|||
|
شرح كتاب الحجّ (6) شرح الأحاديث: الخامس، والسّادس، والسّابع من ( الباب الأوّل )، وهو: ( التّرغيب في الحجّ والعمرة، وما جاء فيمن خرج يقصدهما فمات ) قال رحمه الله: 1098-(5) وَعَنْ الحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رضي الله عنهما قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي جَبَانٌ، وَإِنِّي ضَعِيفٌ ؟ فَقَالَ: (( هَلُمَّ إِلَى جِهَادٍ لاَ شَوْكَةَ فِيهِ، الحَجُّ )). [رواه الطّبرانيّ في "الكبير" و"الأوسط"، ورواته ثقات، وأخرجه عبد الرزّاق أيضا]. 1099-(6) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الأَعْمَالِ، أَفَلَا نُجَاهِدُ ؟ فَقَالَ: (( لَا، لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ )). [رواه البخاري وغيره، وابن خزيمة في "صحيحه"، ولفظه:] قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ! هَلْ عَلَى النِّسَاءِ مِنْ جِهَادٍ ؟ قَالَ: (( عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لاَ قِتَالَ فِيهِ، الحَجُّ وَالعُمْرَةُ )). 1100-(7) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (( جِهَادُ الْكَبِيرِ وَالضَّعِيفِ وَالْمَرْأَةِ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ )). [رواه النّسائي بإسناد حسن]. الشّرح: • شرح الغريب: - ( هَلُمَّ ): لها في لغة العرب معنيان اثنان: الأوّل: بمعنى ( أَقْبل )، كقوله تعالى:{ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا } [الأحزاب من الآية: 18]، أي: تعالوا وأقبلوا. الثّاني: بمعنى ( أَحْضِرْ )، ومنه قوله تعالى:{ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا}، أي: أَحْضِرُوا. ويعرب اسم فعل أمر بمعنى ( أقبِلْ )، أو ( أَحْضِرْ ). ولغة الحجاز - وبها جاء القرىن- أنّه لا يتصرّف، فتقول: ( هلمّ ) للواحد، والواحدة، والمثنّى المذكّر، والمثنّى المؤنّث، والجمع المذكّر والجمع المؤنّث. ولغة تميم أنّها تتصرّف، فتقول: هلمَّ، وهلمِّي، وهلمّا، وهلمُّوا، وهَلْمُمْنَ. - ( لاَ شَوْكَةَ ): أي: لا سلاح فيه، ومنه قوله تعالى:{ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ }، فالطّائفة الأولى ذات الشّوكة وهي القتال، والأخرى غير ذات الشّوكة وهي العِير. • فوائد الحديث: - الفائدة الأولى: رحمة النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بأمّته. فتراه صلّى الله عليه وسلّم - وهو في أمسّ الحاجة إلى الرّجال ليُجاهد بهم الكفّار يومئذ - يأتيه الرّجل، ويقول له: إِنِّي جَبَانٌ، وَإِنِّي ضَعِيفٌ؟ فتراه يجيبه بهدوء وحلم ليس لهما مثيل: (( هَلُمَّ إِلَى جِهَادٍ لاَ شَوْكَةَ فِيهِ، الحَجُّ )). فيعلّمنا صلّى الله عليه وسلّم أنّ النّاس معادِنٌ، وأنّه ليس كلّ النّاس على درجة سواء في أعمال البرّ، فلا يُكلّف النّاس ما لا يطيقون. فإن قال قائل: كيف عذره وأذن له بالقعود، والجهاد فرضٌ ؟ فيقال: قد أنزل الله تعالى عُذره فقال:{ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (91)} [التّوبة]. ثمّ إنّه ذكر أمرين: الضّعف والجُبن، وإنّ خروج مثل هذا قد يُثبّط المجاهدين إذا فرّ وولّى دبره وقت القتال، فمن المصلحة أن لا يُكلّف ما لا يُطَاق، وقد قيل: إذا أردتَ أن تُطاع فاطلُب ما يُستطاع. - الفائدة الثّانية: منزلة الحجّ للنّساء بمنزلة الجهاد لغيرهنّ. هذا الحديث ذكره البخاري في باب ( فضل الجهاد )، لأنّ عائشة رضي الله عنها قالت:" يَا رَسُولَ اللَّهِ ! نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الأَعْمَالِ "، وعند النسائي بلفظ: " فإنّي لا أرى عملا في القرآن أفضل من الجهاد "، ونرى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أقرّها على قولها، وكأنّ الحديث تفسيرٌ لقوله تعالى:{أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ } [التوبة:19]. فإذا ثبت أنّ الجهاد هو أفضل الأعمال للرّجال، كان الحجّ أفضل الأعمال للنّساء. - الفائدة الثّالثة: كيف يكون جواب المعلّم ؟ سألت عائشة النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: يَا رَسُولَ اللهِ ! هَلْ عَلَى النِّسَاءِ مِنْ جِهَادٍ ؟، فما قال: ( نعم )، أو: ( لا ) ولكنّه قال: (( عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لاَ قِتَالَ فِيهِ، الحَجُّ وَالعُمْرَةُ )). فتضمّن هذا الحديث الزّيادة في الإجابة على سؤال السّائل لفـائـدة، وهو من أدب المفتي إن رأى مصلحة في ذلك. ومثله في الحديث الذي رواه أهل السّنن الأربعة والإمام أحمد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلّم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنْ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِصلَّى اللهُ عليْهِ وسلّم : (( هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ )). فزاده فائدة لم يسأل عنها وهي حكم الميتة. كذلك في الحديث الذي رواه مسلم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلّم قَالَ: (( لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ )) قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً ؟ قَالَ: (( إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ )). وغير ذلك. فبيّن له معنى الكبر، وعلّمه شيئا لم يسأل عنه وهو أنّ الله جميل يحبّ الجمال. الفائدة الرّابعة: من أوجه الشّبه بين الحجّ والجهاد. فإنّ كلاّ من الحجّ والجهاد فيه: ترك للأهل والأوطان. وبذل للنّفس والمال. وفي الحجّ من الحاجة إلى الصّبر على المشاقّ والمخاوف ما في الجهاد أيضا. ويجتمعان في أمر آخر، وهو أنّ كلاّ منهما يلزم بالشّروع فيه، فإذا كان الجهاد فرض كفاية أو مستحبّا في بعض الأزمنة، ثمّ التقى الصفّان، صار عندئذ فرض عين، لقوله تعالى:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ (15)} [الأنفال]. كذلك الحجّ المسنون - أي: الزّائد عن حجّة الإسلام- فإنّه وإن كان سنّة، فإنّه يلزم ويصير فرضا بالشّروع فيه، لقوله تعالى:{ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ }، نزلت عام الحديبيّة، وكان الحجّ والعمرة يومئذ مستحبّا، ومع ذلك أمر بإتمامه. الفائدة الخامسة: استدلّ بعض أهل العلم حديث عائشة على وجوب العمرة، لأنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم شبّهها بالجهاد، والجهاد واجب. والله تعالى أعلم. |
|
#7
|
|||
|
|||
|
شرح كتاب الحجّ (7) شرح الأحاديث: الثّامن، والتّاسع، والعاشر والحادي عشر من ( الباب الأوّل )، وهو: ( التّرغيب في الحجّ والعمرة، وما جاء فيمن خرج يقصدهما فمات ) قال رحمه الله: 1101-وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سُؤَالِ جِبْرَائِيلَ إِيَّاهُ عَنِ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ: (( الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَحُجَّ وَتَعْتَمِرَ، وَتَغْتَسِلَ مِنَ الجَنَابَةِ، وَأَنْ تُتِمَّ الوُضُوءَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ )). قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَنَا مُسْلِمٌ ؟ قَالَ: (( نَعَمْ )). قَالَ: صَدَقْتَ. [رواه ابن خزيمة في "صحيحه"، وهو في الصّحيحين وغيرهما بغير هذا السّياق]. وتقدّم في "كتاب الصّلاة" و"الزّكاة" أحاديث كثيرة تدلّ على فضل الحجّ والتّرغيب فيه، وتأكيد وجوبه، لم نُعدها لكثرتها، فليراجعها من أراد شيئا من ذلك. الشّــرح: هذا الحديث -كما قال المصنّف رحمه الله- أصله في الصّحيحين بغير هذا اللّفظ، وهو المشهور بحديث جبريل عليه السّلام. -( الإِسْلاَمُ ): إذا ذُكِر مع الإيمان كما في هذا الحديث، كان معناه الشّعائر الظّاهرة: النّطق بالشّهادتين، وإقام الصّلاة، وإيتاء الزّكاة، وصوم رمضان، وحجّ البيت الحرام. أمّا إذا أُفرِد فيدخل فيه الإيمان كذلك. لذلك قالوا: إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. -( تشْهَدَ ): الشّهادة لها أربع مراتب كما ذكر ابن القيّم رحمه الله في " مدارج السّالكين " (3/450): المرتبة الأولى: العلم، فلا بدّ أن يتعلّم المسلم معنى الشّهادة، لقوله تعالى:{ إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ}. المرتبة الثّانية: النّطق بها. المرتبة الثّالثة: إعلام غيره بها. المرتبة الرّابعة: التزامه بمضمونها. الفوائد المستنبطة من الحديث: - الفائدة الأولى: في الحديث بيان منزلة الحجّ، وأنّه من أعظم شعائر الإسلام الظّاهرة، ولذلك قال عمر رضي الله عنه:" فليمت يهوديّا أو نصرانيّا ! فليمت يهوديّا أو نصرانيّا ! فليمت يهوديّا أو نصرانيّا !: من وجد سعة ولم يحجّ ". وقال سعيد بن جبير رحمه الله:" لو مات جار لي وله ميسرة ولم يحجّ، لم أُصلِّ عليه ". - الفائدة الثّانية: وفي الحديث أيضا دليل على وجوب العمرة. وقد سبق بيان ذلك. - الفائدة الثالثة: فيه تعظيم أمر الطّهارة، حيث قرن ذكرها مع أركان الإسلام، لقوله: ( وَتَغْتَسِلَ مِنَ الجَنَابَةِ، وَأَنْ تُتِمَّ الوُضُوءَ )، وذلك لأنّ الطّهارة شرطٌ من شروط الصّلاة، فأخذت حكمها ومنزلتها. بل هي من أعظم الأمانات، فقد روى الطّبراني بإسناد جيّد عن أبي الدّرداء رضي الله عنه قال: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَدَاءُ الأَمَانَةِ ؟ قَالَ: (( الغُسْلُ مِنَ الجَنَابَةِ، إِنَّ اللهَ لمَ ْيَأْمَنْ ابْنَ آدَمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ دِينِهِ غَيْرِهَا )). [صحّحه الشّيخ الألباني في " صحيح التّرغيب والتّرهيب"(369)]. *** *** *** قال رحمه الله: 1102-وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( الْحَجُّ جِهَادُ كُلِّ ضَعِيفٍ )). [رواه ابن ماجه عن أبي جعفر عنها]. هذا الحديث سبق أن شرحنا ما يشبهه، وفيه بشارة للنّساء والعجزة. وهو يدلّ على سعة رحمة الله تعالى بعباده، حيث جعل لهم بدلا عمّا يعجزون عنه، كما جعل التّسبيح والتّهليل عِوضا للفقراء عمّا لا يستطيعونه من الأعمال الصّالحة، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ الْفُقَرَاءُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ مِنْ الْأَمْوَالِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَا وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ ! يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَلَهُمْ فَضْلٌ مِنْ أَمْوَالٍ يَحُجُّونَ بِهَا وَيَعْتَمِرُونَ وَيُجَاهِدُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ ؟! قَالَ: (( أَلَا أُحَدِّثُكُمْ إِنْ أَخَذْتُمْ أَدْرَكْتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ، وَلَمْ يُدْرِكْكُمْ أَحَدٌ بَعْدَكُمْ، وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِ، إِلَّا مَنْ عَمِلَ مِثْلَهُ ؟ تُسَبِّحُونَ وَتَحْمَدُونَ وَتُكَبِّرُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ )). *** *** *** قال رحمه الله: 1103-وَعَنْ مَاعِزٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: (( إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَحْدَهُ، ثُمَّ الْجِهَادُ، ثُمَّ حَجَّةٌ بَرَّةٌ، تَفْضُلُ سَائِرَ الْأَعْمَالِ كَمَا بَيْنَ مَطْلَعِ الشَّمْسِ إِلَى مَغْرِبِهَا )). [رواه أحمد والطّبرانيّ، ورواة أحمد إلى ماعز رواة "الصّحيح". وماعز هذا صحابيّ مشهور غير منسوب]. الشّرح: - قوله: ( وعن ماعِزٍ ) ليس هو ماعز بن مالك رضي الله عنه الّذي رُجم في زمان النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فذاك أسلميّ، وهذا كما وردت نسبته في بعض الرّوايات أنّه البكائيّ. - ( حجّة برَّة ): البرّة أي: المبرور، كما يقال: فلان برٌّ، أي: مبرور. وأوّل درجات الحجّ المبرور: أن يسلَم من الإثم واللّغو والرّفث. وقد سبق أن شرحنا مثل هذا الحديث أوّل الباب. وبيّن هنا أنّ الحجّة المبرورة بينها وبين سائر الأعمال الصّالحة كما بين المشرق والمغرب. كناية عن علوّ مرتبتها. ولمّا كان الحجّ المبرور له درجة عُليا، يقود إلى الحياة العُليا، ذكر الحديث التّالي وهو حديث جابر رضي الله عنه. *** *** *** 1104-وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةَ )). قِيلَ: وَمَا بِرُّهُ ؟ قَالَ: (( إِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَطِيبُ الكَلَامِ )). [رواه أحمد، والطّبرانيّ في "الأوسط" بإسناد حسن، وابن خزيمة في "صحيحه"، والبيهقيّ، والحاكم مختصرا، وقال: "صحيح الإسناد"]. الشّرح: - ( الْحَجُّ الْمَبْرُورُ ): كما سبق أن ذكرنا أنّ الحجّ المبرور درجتان: أولاهما: مراعاة الواجبات واجتناب المحرّمات، وهي بمنزلة درجة الإسلام. ثانيهما: مراعاة المستحبّات، وذلك بإطعام الطّعام، وطيب الكلام، وهي بمنزلة الإحسان. - وقد قيل:" ثلاث من المروءة في السّفر: خدمة الإخوان، وإطعام الطّعام، وممازحة الخلاّن في غير ما يُغضِب الرّحمن ". هذا في كلّ سفر، فكيف بالسّفر إلى بيت الله الحرام، وخدمة ضيوف الرّحمن ؟ - (لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةَ ): وأكرِمْ به من جزاء ! وإنّ الّذي يخرج قاصدا أيّ بيت من بيوت الله، ليسجد لله، ويتضرّع إلى الله، وعده المولى بالجنّة، فقد روى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (( مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ، أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنْ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ )). والنُّزُل هو ما يُعَدُّ للضّيف إذا نزل، يُعدّ الله له جنّةً عرضها السّماوات والأرض، فكيف إذن بمن خرج قاصدا أعظم بيوت الله، لينزل ضيفا على مولاه ؟ |
|
#8
|
|||
|
|||
|
شرح كتاب الحجّ (8) شرح الحديث الثّاني عشر من ( الباب الأوّل )، وهو: ( التّرغيب في الحجّ والعمرة، وما جاء فيمن خرج يقصدهما فمات ) قال رحمه الله: 1105-وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ )). [رواه التّرمذي، وابن خزيمة وابن حبّان في "صحيحيهما"، وقال التّرمذي: "حديث حسن صحيح"]. شرح الحديث: - ( تَابِعُوا بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ ): أي قاربوا بينهما إمّا بالتمتّع، أو بفعل أحدهما إثر الآخر. قال الطّيبي رحمه الله:" أي إذا اعتمرتم فحُجُّوا، وإذا حججتم فاعتمروا ". - ( فَإِنَّهُمًَا ): أي الحجّ والاعتمار. - ( يَنْفِيَانِ الفَقْرَ ): أي: يزيلان الفقر إمّا: حقيقةً، وذلك بالغنى الّذي يحصُل بسببهما. وإمّا حكماً: بأن يبارك الله تعالى في رزق العبد، أو يرزقه غنى النّفس والقناعة، فيعيش في الظّاهر عيش الفقراء، وفي الباطن يستمتع استمتاع الأغنياء. وقد فسّر بعض السّلف بالقناعة وغنى النّفس قولَه تعالى:{ ووَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى}، لأنّ الآية لا شكّ في أنّها مكّية، ولم يكن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم يومها له شيء من المال. - ( وَالذُّنوُبَ ): أي: جميعها صغائرها وكبائرها، كما قال في الحديث الآخر: (( عَادَ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ )). ويؤيّد ذلك قوله: - ( كَمَا يَنْفِي الكِيرُ ):-بكسر الكاف-، وهو ما ينفخ فيه الحدّاد لإشعال النّار، وما يفعل ذلك إلاّ لتصفية صحيح المعادن من زائفها، فكذلك الحجّ والعمرة، يصفّيان العبدَ من الخطايا والذّنوب، ويهذّبان نفسه من المثالب والعيوب. - ( خَبَثَ الحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ ): أي وسخها، وهو ما تلقيه النّار من وسخ الفضّة والنّحاس وغيرهما إذا أُذيبا. وبذلك يصير الذّهب خالصا، والفضّة خالصة، والحديد خالصا، كذلك العبد يعود من حجّه وعمرته خالصا من كلّ آفة. - ( وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ ): سبق شرحه. الفوائد المستنبطة: - الفائدة الأولى: فيه حجّة لمن ذهب إلى تفضيل التمتّع، وبالأمر بالمتابعة استدلّ من قال يوجويه. - الفائدة الثّانية: فيه أنّ الحجّ والعمرة من أسباب الرّزق الحلال، خلافا لمذهبِ ضِعافِ الإيمان، الّذين يرون أنّ الحجّ والعمرة مذهبةٌ للمال ومفسدة للحال ! فقلبوا الحقائق والموازين، وأضاعوا صحيح المفاهيم. فتقوى الله تبارك وتعالى خير جالب للرّزق، قال تعالى:{وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} [الأعراف:96]، وقال:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً (2) )وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِب (3)} [الطّلاق: من الآية3]، وقال:{وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقاً} [الجـنّ:16] ونظير ضياع هذا المفهوم، أنّهم أضاعوا الصّلاة حرصا على الرّزق زعموا ! وجهِلوا -أو تجاهلوا- أنّ الصّلاة من أعظم أسباب الرّزق الحلال، قال تعالى مبيّنا سبب انصراف النّاس عن الصّلاة:{ وَلا تَمُدَّنَ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى } [طـه:131].. ثمّ قال:{وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نَسْأَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى} [طـه:132]، فانظر كيف بيّن أنّ الرّزق الحلال لا طريق إليه إلاّ بإقام الصّلاة والصّبر عليها، وأمر الأهل بها.. وروى التّرمذيو أبو داود والنّسائي عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ يَقُولُ: (( ابْغُونِي ضُعَفَاءَكُمْ فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ )) زاد النّسائي في رواية سعد رضي الله عنه: (( بِدَعْوَتِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ )). وثالثٌ انشغل بالتّجارة ليل نهار عن صلة الأرحام، وغفل أنّ صلة الأرحام من أوسع أبواب الرّزق، روى البخاري ومسلم عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ يَقُولُ: (( مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ )). ورابع: ألهاه طلب الرّزق عن طلب العلم، ونسي أنّ العلم من أسباب الرّزق، ومن عجيب تفسير ابن عبّاس رضي الله عنه لقوله تعالى:{أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا} [الرعد: من الآية41] قال ابن عبّاس رضي الله عنه: " تنقص خيرات الأرض بموت علمائها ". ويؤيّد ذلك ما رواه التّرمذي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ أَخَوَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِي النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ وَالْآخَرُ يَحْتَرِفُ، فَشَكَا الْمُحْتَرِفُ أَخَاهُ إِلَى النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ فَقَالَ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ: (( لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ )). وخامس ظنّ الزّواج في رحاب الله، وفي ظلال سنّة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من أسباب الفقر !! وغفل عن قوله تعالى:{وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [النور:32]، فهذا الحسن البصريّ رحمه الله شكى إليه رجل الفقرَ ؟ فأوصاه بالزّواج، ثمّ تلا عليه الآية. ولكنّه الشّيطان يخوّف النّاس من الفقر والحاجة، ويفتح لهم أبواب الشّهوات والحرام، كما قال تعالى:{الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [البقرة:268].. وأمّة بكاملها انشغلت بجمع حطام الدّنيا، فأضاعت الجهاد في سبيل الله، ونسيت أنّه من أسباب رزقها، ففي مسند الإمام أحمد بسند صحيح عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ: (( جُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ )). وقال تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:28]. والله أعلم، وأعزّ وأكرم. |
|
#9
|
|||
|
|||
|
شرح كتاب الحجّ (12) دائما تحت ( الباب الأوّل )، وهو: ( التّرغيب في الحجّ والعمرة، وما جاء فيمن خرج يقصدهما فمات ) الحديث التّاسع عشر: قال رحمه الله: 1112-ورُوِيَ عَنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: " كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِ مِنَى، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَرَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ، فَسَلَّمَا، ثُمَّ قَالاَ: يَا رَسُولَ اللهِ ! جِئْنَا نَسْأَلُكَ. فَقَالَ: (( إِنْ شِئْتُمَا أَخْبَرْتُكُمَا بِمَا جِئْتُمَا تَسْأَلاَنِي عَنْهُ فَعَلْتُ، وَإِنْ شِئْتُمَا أَنْ أُمْسِكَ وَتَسْأَلاَنِي فَعَلْتُ )). فَقَالاَ: أَخْبِرْنَا يَا رَسُولَ اللهِ ! فَقَالَ الثَّقَفِيُّ لِلْأَنْصَارِيِّ: سَلْ ! فَقَالَ: أَخْبِرْنِي يَا رَسُولَ اللهِ ! فَقَالَ: (( جِئْتَنِي تَسْأَلُنِي عَنْ مَخْرَجِكَ مِنْ بَيْتِكَ تَؤُمُّ البَيْتَ الحَرَامَ، وَمَا لَكَ فِيهِ، وَعَنْ رَكْعَتَيْكَ بَعْدَ الطَّوَافِ، وَمَا لَكَ فِيهِمَا، وَعَنْ طَوَافِكَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَمَا لَكَ فِيهِ، وَعَنْ وُقُوفِكَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، وَمَا لَكَ فِيهِ، وَعَنْ رَمْيِكَ الجِمَارَ وَمَا لَكَ فِيهِ، وَعَنْ نَحْرِكَ وَمَا لَكَ فِيهِ مَعَ الإِفَاضَةِ )). فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ لَعَنْ هَذَا جِئْتُ أَسْأَلُكَ. قَالَ: (( فَإِنَّكَ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ تَؤُمُّ البَيْتَ الحَرَامَ لاَ تَضَعُ نَاقَتُكَ خُفًّا وَلاَ تَرْفَعُهُ إِلاَّ كَتَبَ اللهُ لَكَ بِهِ حَسَنَةً، وَمَحَا عَنْكَ خَطِيئَةً. وَأَمَّا رَكْعَتَاكَ بَعْدَ الطَّوَافِ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ. وَأَمَّا طَوَافُكَ بِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ كَعِتْقِ سَبْعِينَ رَقَبَةً. وَأَمَّا وُقُوفُكَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، فَإِنَّ اللهَ يَهْبِطُ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيُبَاهِي بِكُمُ المَلاَئِكَةَ، يَقُولُ: عِبَادِي جَاؤُونِي شُعْثًا مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ يَرْجُونَ رَحْمَتِي، فَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُكُمْ كَعَدَدِ الرَّمْلِ أَوْ كَقَطْرِ المَطَرِ أَوْ كَزَبَدِ البَحْرِ لَغَفَرْتُهَا، أَفِيضُوا عِبَادِي مَغْفُورًا لَكُمْ، وَلِمَنْ شَفَعْتُمْ لَهُ. وَأَمَّا رَمْيُكَ الجِمَارَ فَلَكَ بِكُلِّ حَصَاةٍ رَمَيْتَهَا تَكْفِيرُ كَبِيرَةٍ مِنَ المُوبِقَاتِ. وَأَمَّا نَحْرُكَ فَمَدْخُورٌ لَكَ عِنْدَ رَبِّكَ. وَأَمَّا حِلاَقُكَ رَأْسَكَ فَلَكَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَلَقْتَهَا حَسَنَةٌ، وَيُمْحَى عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةٌ. وَأَمَّا طَوَافُكَ بِالبَيْتِ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّكَ تَطُوفُ وَلاَ ذَنْبَ لَكَ، يَأْتِي مَلَكٌ حَتَّى يَضَعَ يَدَيْهِ بَيْنَ كَتِفَيْكَ، فَيَقُولُ: اِعْمَلْ فِيمَا تَسْتَقْبِلْ، فَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا مَضَى )). [رواه الطّبراني في "الكبير" والبزاّر، واللّفظ له، وقال: وقد روي هذا الحديث من وجوه، ولا نعلم له أحسن من هذا الطّريق]. (قال المملي) رضي الله عنه: وهي طريق لا بأس بها، رواتها كلّهم موثّقون. ورواه ابن حبان في "صحيحه" ويأتي لفظه في "الوقوف" إن شاء الله تعالى. الفوائد: - الفائدة الأولى: قوله: ( مَسْجِدِ مِنَى ): هو مسجد الخيف بمنَى، وقد روى الطّبراني عن ابن عبّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مرفوعا: (( صَلَّى فِي مَسْجِدِ الخَيْفِ سَبْعُونَ نَبِيًّا مِنْهُمْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ )) [وهو في " صحيح التّرغيب والتّرهيب "]. - الفائدة الثّانية: قوله: ( إِنْ شِئْتُمَا أَخْبَرْتُكُمَا بِمَا جِئْتُمَا تَسْأَلاَنِي عَنْهُ فَعَلْتُ، وَإِنْ شِئْتُمَا أَنْ أُمْسِكَ وَتَسْأَلاَنِي فَعَلْتُ ): سبب قوله ذاك أنّ الثّقفي حديث عهد بإسلام، فأراد النبيّ صلَّى اللهُ علَيْهِ وَسَلَّمَ أن يُطمئن قلبه ببعض دلائل نبوّته صلَّى اللهُ علَيْهِ وَسَلَّمَ. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمة الله أنّ دلائل نبوّة النبيّ صلّى الله عليه وسلّم من أعظم أسباب زيادة الإيمان. فتدرِيس دلائل النبوّة، وذكر خصائص النبيّ صلّى الله عليه وسلّم من أعظم أسباب تعظيمه، والقيام بأمره وتفخيمه، ومن ثمََّ يحقّق المسلم الرّكن الثّاني من أركان شروط قبول العمل، وهو اتّباع النبيّ صلّى الله عليه وسلّم. - الفائدة الثّالثة: - قوله: ( وَعَنْ طَوَافِكَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ ): أي: السّعي بينهما، والتّعبير بالطّواف موافق لقوله تعالى:{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: من الآية158]. - الفائدة الرّابعة: قوله: ( لاَ تَضَعُ نَاقَتُكَ خُفًّا وَلاَ تَرْفَعُهُ إِلاَّ كَتَبَ اللهُ لَكَ بِهِ حَسَنَةً، وَمَحَا عَنْكَ خَطِيئَةً ).: فمجرّد المشي إلى الحجّ أو العمرة، ولو على دابّة، يؤجر عليه هذا العبد، وقد سبق بيانه. - الفائدة الخامسة: ( وَأَمَّا رَكْعَتَاكَ بَعْدَ الطَّوَافِ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ ): ركعتا الطّواف: سمّيت بذلك، لأنّها تليه، والطّواف عبادة مستقلّة ترتبط به هاتان الرّكعتان، والطّواف أمر زائد على تحيّة المسجد، أمّا حديث: (( تحيّة البيت الطواف )) [فلا أصل له كما في " السّلسلة الضعيفة " برقم (1012)]. أين تصلّى ؟: تُصلّى عند مقام إبراهيم عَلَيْهِ السَّلاَمُ إن أمكن، أو في أيّ مكان من المسجد. روى مسلم عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنّه قال في صفة حجّة النبيّ صلَّى اللهُ علَيْهِ وَسَلَّمَ: " ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَام فَقَرَأَ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ وكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ:{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} وَ{قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}". حكم هاتين الرّكعتين: اختلف العلماء في ذلك على قولين: فمذهب أبي حنيفة وأهل الظّاهر أنّهما واجبتان، لقوله تعالى:{وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً} [البقرة: من الآية125]. وجمهور العلماء على استحبابهما، فقد روى البخاري عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ علَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ بِمَكَّةَ وَأَرَادَ الْخُرُوجَ وَلَمْ تَكُنْ أُمُّ سَلَمَةَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَأَرَادَتْ الْخُرُوجَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيْهِ وَسَلَّمَ: (( إِذَا أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَطُوفِي عَلَى بَعِيرِكِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَفَفَعَلَتْ ذَلِكَ فَلَمْ تُصَلِّ حَتَّى خَرَجَتْ )). فأقرّها النبيّ صلَّى اللهُ علَيْهِ وَسَلَّمَ على تركهما. - وقوله: ( مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ ): مبالغة في بيان فضل هاتين الرّكعتين، لأنّ أشرف الرّقاب هم العرب من بني إسماعيل عَلَيْهِ السَّلاَمُ، حتّى إنّ العرب كانوا إذا نذروا عتق رقبة خصّوها بكونها من بني إسماعيل، وقد حثّ النبيّ صلَّى اللهُ علَيْهِ وَسَلَّمَ على عتقها، فقد روى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَتْ سَبِيَّةٌ مِنْ بَني تميم عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَ صلّى الله عليه وسلّم: (( أَعْتِقِيهَا فَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ )). فالشّاهد أنّه لمّا كانت أشرف الرّقاب شبّه النبيّ صلَّى اللهُ علَيْهِ وَسَلَّمَ ركعَتَي الطّواف بعتقها. - الفائدة السّادسة: قوله: ( وَأَمَّا وُقُوفُكَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، فَإِنَّ اللهَ يَهْبِطُ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا ): الهبوط هو النّزول، كما في " صحيح مسلم "، وممّن عبّر أيضا بالهبوط من السّلف ابن مسعود رضي الله عنه ومحمّد بن الحسن وغيرهما، كما في " شرح أصول اعتقاد أهل السنّة " لللاّلكائي. والنّزل من صفات الله الفعليّة الّتي أثبتها النبيّ صلّى الله عليه وسلّم لربّه تعالى، فال بدّ من الإيمان بها دون تمثيل ولا تكيف. وقد أطال شيخ الإسلام –كما في "المجموع" (5/241)- في بيان أنّ هذا الدّنوّ خاصّ بأهل الموقف دون غيرهم، وأنّ قربه منهم إنّما هو بسبب تقرّبهم منه، كما دلّ عليه الحديث الآخر: (( وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً )). والتّخصيص بعرفة ومثله التّخصيص بالثّلث الأخير من اللّيل، دليل على أنّه سبحانه ليس قريبا بذاته من مخلوقاته كلَّ وقت، كما يدّعيه أهل الحلول والاتّحاد، وإلاّ لما كان في هذا التّخصيص فائدة. - الفائدة السّابعة: قوله: ( أَفِيضُوا عِبَادِي مَغْفُورًا لَكُمْ، وَلِمَنْ شَفَعْتُمْ لَهُ ): أي: ولمن دعوتم له، لذلك كان موقف عرفة من مواطن الإجابة. وقد ذكر غير واحد من السّلف أنّه كان إذا دعا بعرفة، ما يمرّ عليه العام حتّى تظهر له إجابة الدّعاء. - الفائدة الثّامنة: وقوله: ( وَأَمَّا رَمْيُكَ الجِمَارَ فَلَكَ بِكُلِّ حَصَاةٍ رَمَيْتَهَا تَكْفِيرُ كَبِيرَةٍ مِنَ المُوبِقَاتِ ): أصل رمي الجمار: هو أنّه تذكير بشعائر الله الّتي شرعها الله على يد إبراهيم عليه السّلام، وقد روى أحمد وابن خزيمة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ موقوفا قَالَ: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَمَّا أُمِرَ بِالْمَنَاسِكِ عَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَسْعَى فَسَابَقَهُ فَسَبَقَهُ إِبْرَاهِيمُ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِ جِبْرِيلُ إِلَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَعَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانٌ، فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حَتَّى ذَهَبَ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْوُسْطَى، فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، ثلاثا. وقال ابن عبّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أيضا:" الشّيطان ترجمون، وملّة أبيكم تتّبعون ".. - الفائدة التّاسعة: قوله: ( وَأَمَّا نَحْرُكَ فَمَدْخُورٌ لَكَ عِنْدَ رَبِّكَ ): وما يدّخره الله تعالى لا يضيع، بل يربو كما قال تعالى:{وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ} [الروم:39]. وإذا كان الله يربّي التّمرة حتّى تصير مثل الجبل فكيف بالهدي والأضاحي ؟! - الفائدة العاشرة: قوله: ( وَأَمَّا حِلاَقُكَ رَأْسَكَ فَلَكَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَلَقْتَهَا حَسَنَةٌ، وَيُمْحَى عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةٌ ): بهذا الحديث استدلّ من فضّل الحلق على التّقصير، واستدلّوا أيضا بحديث البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيْهِ وَسَلَّمَ: (( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ ))قَالُوا: وَلِلْمُقَصِّرِينَ. قَالَ: (( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ )) قَالُوا: وَلِلْمُقَصِّرِينَ. قَالَهَا ثَلَاثًا، قَالَ: (( وَلِلْمُقَصِّرِينَ )). وقد عارض هذا بعض أهل العلم بأمره صلَّى اللهُ علَيْهِ وَسَلَّمَ لأصحابه عام حجّته بالتّقصير، فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنّ النبيّ صلَّى اللهُ علَيْهِ وَسَلَّمَ قال لهم: (( وَلْيُقَصِّرْ ثُمَّ لْيُحِلَّ )). والصّواب أنّه لا تعارض، فقد قال الحافظ في "الفتح" (3/449): " يستحبّ في حقّ المتمتّع أن يقصر في العمرة، ويحلق في الحجّ، إذا كان ما بين النّسكين متقاربا ".اهـ قال الشّيخ الألباني رحمه الله في "الإرواء" (3/283): " وهذه فائدة يغفل عنها كثير من المتمتّعين، فيحلق بدل التّقصير ".. - الفائدة الحادية عشرة: قوله: ( وَأَمَّا طَوَافُكَ بِالبَيْتِ بَعْدَ ذَلِكَ ): هو طواف الوداع كما سيأتي بيانه في الحديث التّالي. وسمّي بذلك لتوديع البيت، ويُسمّى أيضا طواف الصّدر، لأنّه عند صدور النّاس من مكّة، وهو طواف لا رمل فيه. ولا يلزم اثنين من النّاس: المكّي والحائض. أمّا المكّي: فلأنّه ملازم لمكّة. وأمّا الحائض: فلأنّه لا يصحّ منها، فلو تأخّرت حتّى تطّهر طافت. روى البخاري ومسلم عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: " أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْحَائِضِ ". وبهذا استدلّ أبو حنيفة وأحمد والشّافعي في رواية على وجوبه، وقال مالك والشّافعي فر رواية أخرى هو سنّة. وثمرة الخلاف: أنّ من قال بوجوبه يلزم تاركه دمٌ. فإذا طاف الحاجّ سافر لتوّه إلاّ شيئا من الحوائج يقضيها في طريقه لا بدّ له منها، أمّا لو اشتغل بغير ذلك فعليه إعادته. وعليه أن يستشعر بأنّه لربّما كان هذا آخر عهد له بالبيت في هذه الدّنيا. وختام الأعمال كلّها وتاجها، مغفرة الله، ورحمته الواسعة، لذلك قال: ( فَإِنَّكَ تَطُوفُ وَلاَ ذَنْبَ لَكَ، يَأْتِي مَلَكٌ حَتَّى يَضَعَ يَدَيْهِ بَيْنَ كَتِفَيْكَ، فَيَقُولُ: اِعْمَلْ فِيمَا تَسْتَقْبِلْ، فَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا مَضَى ). نسأل الله من فضله العميم، ولطفه الكريم، آمين. |
|
#10
|
|||
|
|||
|
شرح كتاب الحجّ (13) دائما تحت ( الباب الأوّل )، وهو: ( التّرغيب في الحجّ والعمرة، وما جاء فيمن خرج يقصدهما فمات ) الحديث العشرون: قال رحمه الله: 1113- ورواه الطبراني في "الأوسط" من حديث عبادة بن الصّامت رضي الله عنه وقال فيه: (( فإِنَّ لَكَ مِنَ الأَجْرِ إِذَا أَمَّمْتَ البَيْتَ العَتِيقَ: أَلاَّ تَرْفَعَ قَدَمًا أَوْ تَضَعَهَا أَنْتَ وَدَابَّتُكَ إِلاَّ كُتِبَتْ لَكَ حَسَنَةٌ، وَرُفِعَتْ لَكَ دَرَجَةٌ. وَأَمَّا وُقُوفُكَ بِعَرَفَةَ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لِمَلاَئِكَتِهِ: ( يَا مَلاَئِكَتِي مَا جَاءَ بِعِبَادِي ؟) قَالُوا: جَاؤُوا يَلْتَمِسُونَ رِضْوَانَكَ وَالجَنَّةَ. فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ( فَإِنِّي أُشْهِدُ نَفْسِي وَخَلْقِي أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، وَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُهُمْ عَدَدَ أَيَّامِ الدَّهْرِ، وَعَدَدَ رَمْلِ عَالِجٍ. وَأَمَّا رَمْيُكَ الجِمَارَ، فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ:{ فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } [السّجدة:17]. وَأمَّا حَلْقُكَ رَأْسَكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَعْرِكَ شَعْرَةٌ تَقَعُ فِي الأَرْضِ إِلاَّ كَانَتْ لَكَ نُورًا يَوْمَ القِيَامَةِ. وَأَمَّا طَوَافُكَ بِالبَيْتِ إِذَا وَدَّعْتَ، فَإِنَّكَ تَخْرُجُ مِنْ ذُنُوبِكَ كَيَوْمِ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ )). شرح الحديث: - قوله: ( أَمَّمْتَ ): بمعنى " قصدت "، ومنه التيمّم، وهو قصد الصّعيد الطّاهر. - قوله: ( البَيْتَ العَتِيقَ ) في تسمية البيت الحرام عتيقا أقوال، ذكر منها ابن الجوزي رحمه الله أربعة: 1) أحدها: لأنّ الله تعالى أعتقه من الجبابرة، أعتقه من أن يتسلط عليه جبار بالهوان إلى انقضاء الزمان، وهو قول عبد الله بن الزّبير ومجاهد وقتادة. ولا بدّ أن نبيّن ضعف الحديث الّذي رواه التّرمذي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم: (( إِنَّمَا سُمِّيَ الْبَيْتَ الْعَتِيقَ لِأَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهِ جَبَّارٌ )). 2) والثّاني: أنّ معنى العتيق " القديم "، قاله الحسن وابن زيد. يقال سيف عتيق وقد عتق أي قدم، ومعنى ذلك يوافق قول الله تعالى:{ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَهُدىً لِلْعَالَمِينَ } [آل عمران:96]، وفي صحيح البخاري عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلَ ؟ قَالَ: (( الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ )). 3) والثّالث: لأنّه لم يملك قطّ قاله مجاهد في رواية، وسفيان بن عيينة. 4) والرّابع: لأنّه أعتق من الغرق زمان الطّوفان، قاله ابن السّائب وابن جبير. وذكر القرطبي معنيين آخرين: 5) فالخامس: لأنّ الله عزّ وجلّ يعتق فيه رقاب المذنبين من العذاب. 6) والسّادس: وقيل العتق الكريم والعتق الكرم، ومنه عِتْق العبد، لأنّه خروج من ذل الرّق إلى كرم الحرية. - قوله: ( عَدَدَ رَمْلِ عَالِجٍ ): في "تحفة الأحوذي": ما تراكم من الرّمل، وهو أيضا اسم موضع كثير الرّمل. - قوله: ( وَأَمَّا رَمْيُكَ الجِمَارَ، فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ:{ فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}): لا شكّ أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ما كان ليذكر هذه الآية إلاّ لحكمة، وذلك لأنّ الجزاء من جنس العمل، وهذه الآية كانت جزاء لمن صلّى باللّيل، قال تعالى:{ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (16) فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (17)}. قال العلماء: لمّا أخفوا عملهم خوفا من الله، رزقهم الله ما يخفى على القلوب والخواطر، قال ابن القيّم في "حادي الأرواح": " وتأمّل كيف قابل ما أخفوه من قيام اللّيل بالجزاء الّذي أخفاه لهم ممّا لا تعلمه نفس، وكيف قابل قلقهم وخوفهم واضطرابهم على مضاجعهم حين يقومون إلى صلاة اللّيل بقرّة الأعين في الجنّة، وفي الصّحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم: (( قَالَ اللَّهُ: " أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ:{ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ} ". وهنا كذلك، فإنّ العبد وهو يرمي هذه الجمرات، تخفى عليه الحكمة من هذه العبادة، ومع ذلك يبذل وسعه جاهدا في أداء منسكه، فناسب أن يجازيه الله بما يخفى عليه. والله أعلم وأعزّ وأكرم. |
 |
|
|
 |
 |