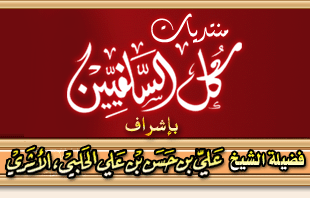


 |
 |
أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
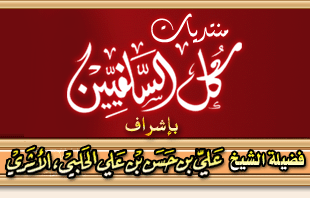 |
 |
 |
|||||
|
|||||||
| 79356 | 98094 |
|
#51
|
|||
|
|||
|
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بوركت أبا الحارث على الفوائد اللطيفة، ومن باب المذاكرة – أقول - : عندي عدد من الإضافات : الإضافة الأولى/ معنى التأويل . لغة : " آل إليه أولاً ومآلاً : رجع " (القاموس:1244) . في الكتاب والسنة : قال ابن القيم – رحمه الله - : " فالتأويل في كتاب الله سبحانه وتعالى المراد به حقيقة المعنى الذي يؤول اللفظ إليه وهي الحقيقة الموجودة في الخارج . فإن الكلام نوعان: خبر وطلب . 1) فتأويل الخبر هو الحقيقة وتأويل الوعد والوعيد هو نفس الموعود والمتوعد به وتأويل ما أخبر الله به من صفاته وأفعاله نفس ما هو عليه سبحانه وما هو موصوف به من الصفات العلى . 2) وتأويل الأمر هو نفس الأفعال المأمور بها قالت عائشة كان رسول الله يقول في ركوعه وسجوده : " سبحانك اللهم ربنا وبحمدك يتأول القرآن " . فهذا التأويل هو نفس فعل المأمور به فهذا التأويل في كلام الله ورسوله " ( الصواعق: 1/178) . عند السلف المتقدمين: قال ابن القيم – رحمه الله - : " وأما التأويل في اصطلاح أهل التفسير والسلف من أهل الفقه والحديث فمرادهم به معنى التفسير والبيان ومنه قول ابن جرير وغيره القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا يريد تفسيره " ( الصواعق: 1/178) . في اصطلاح المتأخرين: قال شيخ الإسلام :" التَّأْوِيلُ الِاصْطِلَاحِيُّ الَّذِي يَجْرِي فِي كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ مُتَأَخِّرِي أَهْلِ الْفِقْهِ وَالْأُصُولِ وَهُوَ صَرْفُ اللَّفْظِ عَنْ الِاحْتِمَالِ الرَّاجِحِ إلَى الِاحْتِمَالِ الْمَرْجُوحِ لِدَلِيلٍ يَقْتَرِنُ بِهِ " (مجموع الفتاوى : 17/359) . المشهور أن هذا النوع من التأويل قسمان: صحيح مقبول: وهو ما دل عليه الدليل المعتبر . وفاسد: وهو ما لم يدل عليه دليل . وهذا يقال عنه تحريف . وذهب بعض المحققين إلى أن التأويل غير الصحيح نوعان : تأويل فاسد : وهو ما كان دليله غير معتبر، لكونه يظن دليلاً وليس هو بدليل ويقال عنه : تحريف . لعب: وهو ما لم يكن عليه دليل أصلاً ، ويقال عنه : تلاعب وهو دهليز الباطنية . قال ابن عاشور : " قال علماء أصول الفقه إن التأويل لا يصح إلا إذا دل عليه دليل قوي ، أما إذا وقع التأويل لما يُظن أنه دليل فهو تأويل باطل فإن وقع بلا دليل أصلاً فهو لعب لا تأويل " .( التحرير والتنوير:1/471-472) . وقال الشنقيطي : " وأما حمل اللفظ على غير ظاهره لا لدليل فهذا لا يسمى تأويلاً في الاصطلاح بل يسمى لعباً لأنه تلاعب بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم . ومن هذا تفسير غلاة الروافض قوله – تعالى - : {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} قالوا: عائشة . ومن هذا النوع صرف آيات الصفات عن ظواهرها إلى محتملات ما أنزل الله بها من سلطان، كقولهم : (استوى) بمعنى : (استولى) ." (الأسماء والصفات للشنقيطي : ص/87). الإضافة الثانية / (الجَهْمية) بسكون الهاء نسبة إلى (جَهْم) وبعضهم يخطئ فيقول : الجَهَمية . الإضافة الثالثة / نسبة العموم والخصوص المطلق . تعريفها: أن يجتمع لفظان في الدلالة على معنى ثم ينفرد أحدهما بالدلالة على معنى لا يدل عليه الآخر . مثل : الكلمة والاسم ، لفظان يجتمعان في الدلالة على (ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمان) . وتنفرد الكلمة بالدلالة على ( ما دل على معنى في نفسه واقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، وما دل على معنى في غيره وهو الحرف ) . فأحد اللفظين أعم مطلقاً والثاني أخص مطلقاً . تنبيه: يستدل على الأعم منهما بصحة الإخبار به عن الثاني . فما صح الإخبار به أعم وما لم يصح فهو خاص . فنقول: كل اسم كلمة . فالكلمة أعم لأنه يصح الإخبار بها عن الاسم . ولا يصح أن نقول كل كلمة اسم، فالاسم أخص . أفاد القاعدة ابن عثيمين – رحمه الله -. فائدة : العموم والخصوص الوجهي : هو أن يجتمع اللفظان في الدلالة على معنى ثم ينفرد كل لفظ بالدلالة على معنى لا يدل عليه الآخر . مثل : الحمد والشكر ، فهما لفظان يجتمعان في الثناء على الله باللسان بما أَنْعَم، وينفرد الشكر في التعظيم بالفعل، وينفرد الحمد في الثناء باللسان في غير نعمة . الإضافة الرابعة/ الطرق العقلية تدل على أن العلم بالكيفية ممتنع، لإن الكيف إنما يُعلم بالخبر المفصل الصادق أو بالمشاهدة أو بمشاهدة النظير، والله لم يخبرنا بالكيف مفصلاً، ولم نره، وهو متعال ومنزه سبحانه عن المثيل . الإضافة الخامسة/ التقابل بين التكييف والتمثيل العموم والخصوص المطلق . فالتمثيل: ذكر كيفية الصفة مقيدة بمماثل. والتكييف: ذكر كيفية الصفة مطلقاً مقيدة بمماثل أو غير مقيدة بمماثل. مثال التمثيل: أن يقول القائل: يد الله كيد الإنسان. ومثال التكييف : أن يتخيل ليد الله كيفية معينة لا مثيل لها في أيدي المخلوقين فلا يجوز هذا التخيل. فكل تمثيل تكييف ، وليس كل تكييف تمثيل . أفاده ابن عثيمين – رحمه الله - بتصرف يسير. ومن الله التوفيق . |
|
#52
|
|||
|
|||
|
من الفوائد المسلكية :
1) إن توحيد الأسماء والصفات من الإيمان بالله – تعالى – فالذي يؤمن بالله لا بد أن يؤمن به متصفاً بصفات الجلال ونعوت الكمال، له الأسماء الحسنى والصفات العلا . ومنفرداً بهذه الأوصاف {ليس كمثله شيء وهو السميع البصير}. ودون ذلك يكون العبد عابداً لغير ربه الذي خلقه ، كما قال ابن القيم : المعطل يعبد عدماً والمشبه يعبد صنماً والموحد يعبد إلهاً له الأسماء الحسنى والصفات العلا . ويقودنا هذا إلى حقيقة أخرى مهمة : 2) أن الإيمان بالأسماء والصفات على طريقة السلف يفضي إلى تعظيم الله – تعالى – وحمده وتسبيحه وإجلاله والثناء عليه . بخلاف طريقة الزائغين عنهم فهي تفضي إلى الانحلال عن الشرائع، لعدم تعظيم أصحابها لله لأنه في قلوبهم مسلوب الصفات أو كأحدهم . 3) إن حقيقة الإيمان بالله هي (محبته تعظيماً وإجلالاً)، والمحبة فرع المعرفة فمن لم يعرف محبوبه لن يحبه المحبة اللائقة به . فتعين باب الأسماء والصفات على الطريقة السلفية مدخلاً وحيداً (لمحبة الله تعظيماً) وهي حقيقة العبودية التي خلقنا للقيام بها {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} . |
|
#53
|
|||
|
|||
|
ومن الفوائد/ معرفة بطلان ضلالات الاتحادية والحلولية الغلاة ؛لأن العبد يستحيل أن يتصف بهذه الصفات ..
__________________
قال ابن تيمية:"و أما قول القائل ؛إنه يجب على [العامة] تقليد فلان أو فلان'فهذا لا يقوله [مسلم]#الفتاوى22_/249 قال شيخ الإسلام في أمراض القلوب وشفاؤها (ص: 21) : (وَالْمَقْصُود أَن الْحَسَد مرض من أمراض النَّفس وَهُوَ مرض غَالب فَلَا يخلص مِنْهُ إِلَّا الْقَلِيل من النَّاس وَلِهَذَا يُقَال مَا خلا جَسَد من حسد لَكِن اللَّئِيم يبديه والكريم يخفيه). |
|
#54
|
|||
|
|||
|
بسم الله الرحمن الرحيم بورك فيك أخي الحبيب المشرف ... أبو الحارث باسم خلف لقد أجدت وأفدت ، فجزاك الله خيراً ـــــــــــــــ ومن باب المشاركة في المذاكرة انبه على بعض المسائل : المسألة الأولى / الكاف في قوله : {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} . مع صحة التقديرين السابقين يمكن أن لا نقول بالزيادة – وهذا قول وجيه – وتكون الآية على أحد تفسيرين : التفسير الأول/ قال صالح آل الشيخ : " منهم من يقول هي بمعنى (مثل) تقدير الكلام (ليس مثل مثله شيء) ونفيُ (مثل المثل) فيه اعتراض - انتبه للكلام - نفي (مثل المثل) فيه إعراض عن إثبات (المثل) لاستحالته . يعني حينما قدرها بعضهم قدر الكاف بـ (مثل) كونه يكون المعنى (ليس مثل مثله شيء) رُدَ بأنه لو قدر بذلك لكان يمكن أن يكون فيه إثبات للمثل لأنه قال (ليس مثل مثله) فهل معنى نفي مثل المثل أن فيه إثبات المثل ؟ الجواب أنه على هذا القول ليس كذلك لأن العرب تنفي - يعني في لغتها - مثل المثل لأن وجود المثل مستحيل ولأنه لا يستحق أن يذكر ، فينفى مثل المثل مبالغة في نفي المثل ، هذا واحد " (العقيدة الواسطية) ، وبه يقول الشيخ مشهور . التفسير الثاني / "ويحتمل أنها غير زائدة. والمراد بالمثل الذات؛ كقول العرب: مثلك لا يفعل هذا، يعنون أنت لا ينبغي لك أن تفعل هذا، فالمعنى: ليس كالله شيء. ونظيره من إطلاق المثل وإرادة الذات {وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرائيلَ عَلَى مِثْلِهِ} [46/10]، أي: على نفس القرآن لا شيء آخر مماثل له " قاله الشنقيطي في الأضواء، وذكره الشيخ مشهور معتداً به . المسألة الثانية / الدليل على صحة إطلاق لفظ الصفات على الله – تعالى – الحديث الصحيح " عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث رجلاً على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بـ{ قل هو الله أحد} فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها (صفة الرحمن) وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبروه أن الله يحبه (رواه البخاري ومسلم) . المسألة الثالثة / الإلحاد في آيات الله . اعلم أن الآيات نوعان : آيات شرعية ، وآيات كونية . الآيات الشرعية : هي ما جاءت به الرسل . الآيات الكونية : هي المخلوقات . والإلحاد في الآيات الشرعية أنواع : 1) إما بتكذيبها . 2) وإما بتحريفها . 3) وإما بالمخالفة – تركاً للمأمور أو فعلاً للمحذور - ، فكل عاص ملحد . والإلحاد في الآيات الكونية أنواع : 1) إنكار أن الله هو الخالق . 2) أو بإضافتها إلى غير الله . 3) أو اعتقاد أن لله – تعالى – فيها شريكاً أو معيناً . (أفاده ابن عثيمين – بتصرف – من شرح العقيدة التدمرية) . المسألة الرابعة/ قوله : " صادقون مصدوقون " . " الصادق المصدوق ، فمعناه: 1. الصادق في قوله . 2. المصدوق فيما يأتيه من الوحي الكريم . " قاله ابن دقيق العيد . ومعنى ذلك : أن الصادق من لا يكذب على غيره . وأن المصدوق من لا يكذب غيره عليه . والمراد بالغير هنا الوحي ، أي يأتيه ملك بالأخبار الصادقة ولا يكذب عليه ، ولا تتنزل عليه الشياطين لأنهم لا يمكنون من ذلك وهم معزولون عن السمع . المسألة الخامسة / قوله – تعالى - : {سُبْحان ربِّك ربّ العِزّةِ عمّا يَصِفون وسلامٌ على المرسَلين والحمد لله ربّ العالمَين}. في الآية ملحظ لطيف فقد جمع بين قوله { والحمد لله ربّ العالمَين} الذي هو وصف الله بالكمال والإفضال مع المحبة والتعظيم ، مع قوله : { وسلامٌ على المرسَلين } فأفاد أن وصف الرسل لله – تعالى – هو الطريق الوحيد لحمد الله ومنه ذكره وعبادته . الآثار المسلكية : 1) إن الذي يؤمن بأسماء الله – تعالى – وصفاته على طريقة السلف ، ولا يلحد بها أو ينكرها فإنه يعرف الله فيذكره ويعظمه ويحبه . بخلاف الملحد فيها ، فإن الحاده يفضي به إلى الجهل بربه والغفلة عن ذكره ونسيانه . 2) ثمرة الإيمان بصفتي (السمع والبصر) لله – تعالى – دوام المراقبة وبلوغ درجة الإحسان ، كما قال ابن القيم – رحمه الله - : " المراقبة دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه فاستدامته لهذا العلم واليقين : هي المراقبة وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه ناظر إليه سامع لقوله وهو مطلع على عمله كل وقت وكل لحظة وكل نفس وكل طرفة عين والغافل عن هذا بمعزل عن حال أهل البدايات فكيف بحال المريدين فكيف بحال العارفين " (مدارج السالكين:2/65) . |
|
#55
|
|||
|
|||
|
جزيت خيرا (أخي) باسم خلف ..
وعندي سؤال: نقلتم [وهذا الاسم العظيم من جملة أسماء الله الحسنى الدالّة على عدة صفات لا على معنى مفرَد، ففيه الدلالة على كثرة صفات الله وعظمتها وكمالها... ولأجل ذا تنوعت عبارات السلف في تفسير هذا الاسم، فمنهم من قال: الصمد هو الذي ليس بأجوف ولا يأكل ولا يشرب، ومنهم من قال: هو الذي يصمد الخلائق إليه في حوائجهم ومسائلهم، ومنهم من قال: هو السيد الذي انتهى سؤدده، ومنهم من قال: هو الذي لا أحد فوقه... وكل ذلك حق، لأن هذا الاسم دالٌّ على جملة أوصاف عديدة لا على معنى مفرد..كما قرر ذلك غير واحد من أهل العلم...] لماذا (فسر علماء السلف هذا الاسم العظيم=(الصمد) ) بعدة تفاسير ؛ثم كيف لنا أنهم اتفقوا (عليها جميعها)؟ أم أن معانيها (مجتمعة)؟وهل في اللغة العربية أسماء تحمل في طيّاتها معانيَ عدّة؟ بارك الله فيكم
__________________
قال ابن تيمية:"و أما قول القائل ؛إنه يجب على [العامة] تقليد فلان أو فلان'فهذا لا يقوله [مسلم]#الفتاوى22_/249 قال شيخ الإسلام في أمراض القلوب وشفاؤها (ص: 21) : (وَالْمَقْصُود أَن الْحَسَد مرض من أمراض النَّفس وَهُوَ مرض غَالب فَلَا يخلص مِنْهُ إِلَّا الْقَلِيل من النَّاس وَلِهَذَا يُقَال مَا خلا جَسَد من حسد لَكِن اللَّئِيم يبديه والكريم يخفيه). |
|
#56
|
|||
|
|||
|
جزاك ربي خيراً إذا تفسير السلف(لهذا الاسم)؛من الكل (بالجزء)..
__________________
قال ابن تيمية:"و أما قول القائل ؛إنه يجب على [العامة] تقليد فلان أو فلان'فهذا لا يقوله [مسلم]#الفتاوى22_/249 قال شيخ الإسلام في أمراض القلوب وشفاؤها (ص: 21) : (وَالْمَقْصُود أَن الْحَسَد مرض من أمراض النَّفس وَهُوَ مرض غَالب فَلَا يخلص مِنْهُ إِلَّا الْقَلِيل من النَّاس وَلِهَذَا يُقَال مَا خلا جَسَد من حسد لَكِن اللَّئِيم يبديه والكريم يخفيه). |
|
#57
|
|||
|
|||
|
مقدمة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه . أما بعد : فقد عهد إلي أخي الحبيب المشرف الفاضل أبو الحارث باسم خلف – وفقه المولى – متابعة المشوار في مدارسة العقيدة الواسطية إحساناً منه الظن بأخيه الضعيف – غفر له مولاه – حتى لا يبقى الدرس منقطعاً ، فرأيت إجابته من باب التعاون على البر والتقوى ، وإن كنت مزجي البضاعة في العلم لكن حسبي أن أكون ناقلاً لكلام العلماء في تحرير ألفاظ هذه الرسالة النافعة ، وليس لي إلا النقل والترتيب وعلى حد قول العلامة الوادعي – رحمه الله - : :" فإننا نحن الآن ننقل من كلام أهل العلم، ومن كتب أهل العلم حتى إن كتبي لو أعطيت كل كلمة جناحا وطارت إلى موضعها لبقيت الصفحات بيضاء ."(إجابة السائل على أهم المسائل،ص565). ومن الله التوفيق . الدرس السادس قال شيخ الإسلام – رحمه الله - : " وَمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِي أَعْظْمِ آيَةٍ فِي كِتِابِهِ حَيْثُ يَقُولُ: {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ} [البقرة: 255] وَلِهَذَا كَانَ مَنْ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ فِي لَيْلَةٍ لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبُهُ شَيْطَانٌ حَتَّى يُصْبِحَ ". (مجموع الفتاوى : 3/131) الشرح : فيه عدة مسائل ، منها : المسألة الأولى / التنبيه على ما يحتاج إلى تحقيق من هذا النص من العقيدة الواسطية ، وذلك في موضعين . الموضع الأول / جاء في بعض النسخ زيادة : (أي لا يكرثه ولا يثقله) وسط آية الكرسي { وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا ـ أي لا يكرثه ولا يثقله ـ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيم } ، كما في النسخة التي عليها شرح العلامة الفوزان – حفظه الله - ، وكذلك النسخة التي علق حواشيها وأشرف على تصحيحها فضيلة العلامة الشيخ : محمد بن عبد العزيز بن مانع مدير المعارف العام – في وقته - ، وكذلك النسخة التي عليها شرح يوسف محمد الغفيص . وقد خلت نسخة مجموع الفتاوى منها ، وكذلك النسخة التي اعتمدها العلامة ابن عثيمين – رحمه الله – في شرح هذه العقيدة ، ومثلها النسخة التي عليها شرح العلامة الهراس ، وكذلك نسخة ( دار الأفكار الدولية ) ، وكذلك النسخة التي عليها شرح الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان ، وكذلك النسخة التي عليها شرح الشيخ صالح آل الشيخ . الموضع الثاني / قوله – بعد الآية - : ( وَلِهَذَا كَانَ مَنْ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ فِي لَيْلَةٍ لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبُهُ شَيْطَانٌ حَتَّى يُصْبِحَ ) . وهي ثابتة في مجموع الفتاوى ، وكذلك في النسخة التي علق حواشيها وأشرف على تصحيحها فضيلة العلامة الشيخ : محمد بن عبد العزيز بن مانع مدير المعارف العام – في وقته - ، وكذلك في النسخة التي عليها شرح العلامة الفوزان – حفظه الله - ، وكذلك النسخة التي اعتمدها العلامة ابن عثيمين – رحمه الله – في شرح هذه العقيدة ، وكذلك النسخة التي عليها شرح الشيخ صالح آل الشيخ . وخلت منها نسخ الأخرى . المسألة الثانية / معاني المفردات . 1. [سِنَةٌ] : قال ابن منظور – رحمه الله - : " قال الله - تعالى - : { لا تأْخذه سِنَةٌ ولا نوم }، أَي: لا يأْخذه نُعاسٌ ، ولا نوم . وتأْويله : أَنه لا يَغْفُل عن تدبير أَمر الخلق - تعالى وتَقَدَّسَ - . والسِّنَةُ النُّعَاس من غير نوم ، ورجل وَسْنانُ ونَعْسانُ بمعنى واحد . والسِّنَةُ نُعاسً يبدأْ في الرأْس فإِذا صار إِلى القلب فهو نوم ، وفي الحديث : " وتُوقِظ الوَسْنانَ "(*) أَي : النائم الذي ليس بمُسْتَغْرِقٍ في نومه . والوَسَنُ أَول النوم . والهاء في ( السِّنَةِ ) عوض من الواو المحذوفة " ( لسان العرب : 13/449) ، وانظر – غير مأمور - (معجم مقاييس اللغة : 6/84) ، ( تاج العروس : 36/255) . (*) قلت : يشير إلى حديث " أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأَبِي بَكْرٍ: مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ تَقْرَأُ وَأَنْتَ تَخْفِضُ مِنْ صَوْتِكَ، فَقَالَ: إِنِّي أَسْمَعْتُ مَنْ نَاجَيْتُ، قَالَ: ارْفَعْ قَلِيلاً، وَقَالَ لِعُمَرَ: مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ تَقْرَأُ وَأَنْتَ تَرْفَعُ صَوْتَكَ، قَالَ: إِنِّي أُوقِظُ الوَسْنَانَ، وَأَطْرُدُ الشَّيْطَانَ، قَالَ: اخْفِضْ قَلِيلاً " (رواه الترمذي: 447 ، وأبو داود : 1329 ، وصححه الألباني ) . 2. [نَوْمٌ] : قال ابن فارس – رحمه الله - : " النون والواو والميم أصلٌ صحيح يدلُّ على جُمودٍ وسكونِ حركة. منه النَّوم. نامَ ينام نَوْماً ومَناما " (معجم مقاييس اللغة: 5/298). و " النّوْم معروف " ( لسان العرب : 12/595) . 3. [مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ] : قال القرطبي – رحمه الله - : " قوله تعالى : {يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ} الضميران عائدان على كل من يعقل ممن تضمنه قوله : {لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ} ". وقال مجاهد : { مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ } الدنيا {وَمَا خَلْفَهُمْ} الآخرة. قال ابن عطية : وكل هذا صحيح في نفسه لا بأس به ؛ لأن ما بين اليد هو كل ما تقدم الإنسان ، وما خلفه هو كل ما يأتي بعده ؛ وبنحو قول مجاهد قال السدي وغيره " (الجامع لأحكام القرآن :3/276) ، ( تيسير الكريم الرحمن ص/ 110) . 4. [كُرْسِيُّهُ] : " الكرسي موضع القدمين ، والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى " صححه الألباني عن ابن عباس موقوفاً في "مختصر العلو للذهبي " (ص 102/36) . ورواه أبو الشيخ أيضاً في "العظمة" (2/627) عن أبي موسى موقوفاً - أيضاً -. وسنده صحيح ، قاله الألباني . وقيل : كرسيه : علمه ونسب هذا القول لابن عباس ، وهو ضعيف . قال الألباني – رحمه الله - : " ولم يصح هذا التأويل عن ابن عباس كما بينته في " الصحيحة " ( 103 ) [ الصحيح هو برقم ( 109 ) الصفحة 173 ، طبع المكتب الإسلامي ] " (تحقيق الطحاوية ص/54) . وقال أحمد شاكر – رحمه الله - : " وأما أبو منصور الأزهري فقد قال في ذكر الكرسي : "والصحيح عن ابن عباس ما رواه عمار الدهنى ، عن مسلم البطين ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس أنه قال : "الكرسي موضع القدمين ، وأما العرش فإنه لا يقدر قدره . قال : وهذه رواية اتفق أهل العلم على صحتها . قال : ومن روى عنه في الكرسي أنه العلم ، فقد أبطل" ، وهذا هو قول أهل الحق إن شاء الله " (تحقيق تفسير الطبري : 5/401) . 5. [وَلَا يَئُودُهُ] : قال القرطبي – رحمه الله - : " معناه يثقله ؛ يقال : آدني الشيء بمعنى أثقلني وتحملت منه المشقة ، وبهذا فسر اللفظة ابن عباس والحسن وقتادة وغيرهم " (الجامع لأحكام القرآن :3/287) ، ونحوه في (تفسير الطبري : 5/ 403) ، و (تفسير ابن كثير : 1/682) . وهو قول أئمة اللغة – أيضاً - ، قال ابن منظور – رحمه الله - : " آدَه الأَمرُ أَوْداً وأُوُوداً بلغ منه المجهود والمشقة وفي التزيل العزيز {ولا يؤُوده حفظهما} قال أَهل التفسير وأَهل اللغة معاً معناه : ولا يكرثه ولا يثقله ولا يشق عليه . مِن آده يؤُوده أَوْداً " ( لسان العرب :3/74) ، ونحوه في (معجم مقاييس اللغة : 1/156) . المسألة الثالثة / مقصود المصنف – رحمه الله - من المتن . أراد المصنف – رحمه الله أن يستدل بهذه الآية على أن الله – تعالى – قد وصف نفسه بصفات ثبوتية في أعظم آية في القرآن ، وما كان فيها من الصفات السلبية فهي دالة على كمال ثبوتي ، وأن مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله – تعالى ما أثبته لنفسه ، ومنها هذه الآية ، كما قال في الصفدية (2/62- 65) : " وأما السلف والأئمة - رضي الله عنهم - فلم يقولوا شيئاً من هذه الأقوال ولا بنوا على شيء من تلك الأصول المزلزلة . بل كلامهم مضمونه : أن الله سبحانه لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال لم يزل قديراً ، ولم يزل عليماً ، ولم يزل متكلماً إذا شاء ، ولم يزل فاعلاً لما شاء ، وأنه - سبحانه وتعالى - لم يعدم كمالاً ممكناً . بل هو المستحق لأنواع الكمال الممكن الوجود ، وذلك واجب له ولا يقدر العباد أن يعلموا ما يستحقه الرب من الحمد والثناء . بل قد قال أعلمهم بالله : " لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك " . والحمد والثناء إنما يكون بالأمور الوجودية أو ما يستلزم الأمور الوجودية فأما العدم المحض فلا مدح فيه ولا ثناء فإن المعدوم المحض لا يثنى عليه ولهذا لا يثني سبحانه وتعالى على نفسه إلا بالصفات الثبوتية أو ما يستلزم ذلك كقوله – تعالى -: {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ} [البقرة: 255] . وقد ثبت في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه و سلم - أن هذه الآية أعظم آية في القرآن كتاب الله . وقد وصف نفسه فيها بالصفات الثبوتية ، وذكر فيها خمسة سلوب : الأول / قوله : { لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ } فإنه يقتضي انفراده بالألوهية وذلك يتضمن انفراده بالربوبية وأن ما سواه عبد له مفتقر إليه وأنه خالق ما سواه ومعبوده وذلك صفة إثبات . الثاني / قوله : { لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ } وهذا يتضمن كمال الحياة والقيومية فإن السنة والنوم نقص في الحياة والقيومية والنوم أخ الموت ومن نام لم يمكنه حفظ الأمور فهو سبحانه منزه عن السنة والنوم تنزيها يستلزم كمال حياته وقيوميته والحياة والقيومية من الإثبات . الثالث / قوله : { مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ } فإن هذا متضمن أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه وهذا يتضمن كمال قدرته وخلقه وربوبيته وأن غيره لا يؤثر فيه بوجه من الوجوه كما يؤثر في المخلوقين من يشفع عندهم فيحملهم على الفعل بعد أن لم يكونوا فاعلين وإنما الشفاعة عنده بإذنه فهو الذي يأذن للشفيع وهو الذي يجعله شفيعا ثم يقبل شفاعته فلا شريك له ولا عون بوجه من الوجوه وذلك يتضمن كمال القدرة والخلق والربوبية والغنى والصمدية . الرابع / قوله : { وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ } فإن هذا يقتضي أنه الذي يعلم العباد ما شاء من علمه وأنه لا علم لهم إلا ما علمهم فبين أنه المنفرد بالتعليم والهداية لا يعلم أحد شيئا إن لم يعلمه إياه كما أنه المنفرد بالخلق والإحداث فهو الذي خلق فسوى وهو الذي قدر فهدى وأول ما نزل من القرآن {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْأِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْأِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5) } [سورة العلق: 1- 5]. الخامس / قوله : { وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا } أي لا يكرثه ولا يثقل عليه وهذا يقتضي كمال القدرة وتمامها وأنه لا تلحقه مشقة ولا حرج . وقال ابن عثيمين – رحمه الله - : " وهذه الآية تتضمن من أسماء الله خمسة وهي : الله ، الحي ، القيوم ، العلي ، العظيم . وتتضمن من صفات الله ستًا وعشرين صفة منها خمس صفات تضمنتها هذه الأسماء . السادسة : انفراده بالألوهية . السابعة : انتفاء السنة والنوم في حقه ، لكمال حياته وقيوميته . الثامنة : عموم ملكه ، لقوله : { لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ } . التاسعة : انفراد الله عز وجل بالملك ، ونأخذه من تقديم الخبر . العاشرة : قوة السلطان وكماله ، لقوله : { مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ } . الحادية عشرة : إثبات العندية ، وهذا يدل على أنه ليس في كل مكان ، ففيه الرد على الحلولية . الثانية عشرة : إثبات الإذن من قوله : { إِلَّا بِإِذْنِهِ } . الثالثة عشرة : عموم علم الله تعالى لقوله : { يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ } . الرابعة عشرة والخامسة عشرة : أنه سبحانه وتعالى لا ينسى ما مضى ، لقوله : { وَمَا خَلْفَهُمْ } ولا يجهل ما يستقبل ، لقوله : { مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ } . السادسة عشرة : كمال عظمة الله ، لعجز الخلق عن الإحاطة به . السابعة عشرة : إثبات المشيئة ، لقوله : { إِلَّا بِمَا شَاءَ } . الثامنة عشرة : إثبات الكرسي ، وهو موضع القدمين . التاسعة عشرة والعشرون والحادية والعشرون : إثبات العظمة والقوة والقدرة ، لقوله : { وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ } ، لأن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق . الثانية والثالثة والرابعة والعشرون : كمال علمه ورحمته وحفظه ، من قوله : { وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا } . الخامسة والعشرون : إثبات علو الله لقوله : { وَهُوَ الْعَلِيُّ } السادسة والعشرون : إثبات العظمة لله عز وجل ، لقوله : { الْعَظِيمُ } " (شرح العقيدة الواسطية – ضمن فتاوى ابن عثيمين -: 8/141 – 146) . . فأهل السنة والجماعة يثبتون جميع ما أثبته الله لنفسه على ما يليق به سبحانه . (يتبع تتمة الدرس السادس – إن شاء الله - ) . |
|
#58
|
|||
|
|||
|
جزيتم الجنة أستاذ
وجزى الله الأخ باسما خيرا على حرصه..
__________________
قال ابن تيمية:"و أما قول القائل ؛إنه يجب على [العامة] تقليد فلان أو فلان'فهذا لا يقوله [مسلم]#الفتاوى22_/249 قال شيخ الإسلام في أمراض القلوب وشفاؤها (ص: 21) : (وَالْمَقْصُود أَن الْحَسَد مرض من أمراض النَّفس وَهُوَ مرض غَالب فَلَا يخلص مِنْهُ إِلَّا الْقَلِيل من النَّاس وَلِهَذَا يُقَال مَا خلا جَسَد من حسد لَكِن اللَّئِيم يبديه والكريم يخفيه). |
|
#59
|
|||
|
|||
|
وجزاكما الله خيرا وزادكما الله برا وفضلا أبو الحارث باسم خلف عمربن محمدالبومرداسي ـــــــــــــــــــــ القسم الثاني من الدرس السادس بسم الله الرحمن الرحيم المسألة الرابعة / المعنى العام للمتن . 1. [وما وصف به نفسه] . هذه الجملة معطوفة على " ما " من قوله : " وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص " . وكل الآيات التي سيذكرها المصنف معطوفة عليها ، ونكتفي بهذه الإشارة تركاً للتكرار . [ما] موصولة بمعنى الذي . [وصف به نفسه] ويراد به ما يشمل الأسماء والصفات والأفعال ، لأنها تدخل جميعا في إطلاق اسم صفات الله . وذلك لأن الأسماء ليست أعلاما محضة بل هي من جهة أعلام دالة على الذات مترادفة من حيث دلالتها على الذات ، ومن جهة أخرى كل اسم مشتمل على صفة من صفات الله غير الصفة التي في الاسم الآخر ؛ فلهذا كانت الأسماء بهذا الاعتبار من الصفات . والأفعال كذلك ، أفعال الله - جل وعلا - تجمع بين الحدث الذي هو المصدر وبين الزمن . و (الحدث) : وصف ، مثلا في قوله {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ} هذا فعل ماض . والفعل الماضي متركب من شيئين الحدث وهو السماع ، وكون الحدث في الزمان الماضي . وكذلك الفعل المضارع {أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم} (نسمع) هذا فعل مضارع فيه الدلالة على الحدث وهو المصدر وهو السماع أو السمع وفيه دلالة على زمنه وهو الحاضر والمستقبل . (بتصرف من شرح صالح آل الشيخ: 1/94). 2. [في أعظم آية في كتاب الله] . فيه مطالب : المطلب الأول / الدليل على أن آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله ما جاء عن أُبَيِّ بنِ كَعبٍ - رضي الله عنه - ، قَالَ : قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : (( يَا أَبَا الْمُنْذِرِ ، أَتَدْري أيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ الله مَعَكَ أعْظَمُ ؟ )) قُلْتُ : { اللهُ لاَ إلَهَ إِلاَّ هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ } فَضَرَبَ فِي صَدْرِي ، وقال : (( لِيَهْنِكَ العِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ )) رواه مسلم . فائدة : وفي رواية : " لِيَهنِكَ العلمُ أبا المنذرِ! والذي نفسي بيده؛ إنّ لها لساناً وشَفَتَينِ تُقَدّسان الملِك عند ساقِ العرش. يعني: آيةَ الكرسيّ " ( رواه عبد الرزاق ومن طريقه أحمد ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم : 3410 ) . المطلب الثاني / قال ابن عثيمين – رحمه الله - : " وفي هذا الحديث دليل على أن القرآن يتفاضل ، كما دل عليه أيضا حديث سورة الإخلاص ، وهذا موضع يجب فيه التفصيل ، فإننا نقول : أما باعتبار المتكلم به فإنه لا يتفاضل، لأن المتكلم به واحد وهو الله عز وجل ، وأما باعتبار مدلولاته وموضوعاته فإنه يتفاضل ، فسورة الإخلاص التي فيها الثناء على الله عز وجل بما تضمنته من الأسماء والصفات ليست كسورة المسد التي فيها بيان حال أبي لهب من حيث الموضوع كذلك ، يتفاضل من حيث التأثير والقوة في الأسلوب ، فإن من الآيات ما تجدها آية قصيرة لكن فيها ردع قوي للقلب وموعظة ، وتجد آية أخرى أطول منها بكثير لكن لا تشتمل على ما تشتمل عليه الأولى ، فمثلا قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ } [البقرة : 282] . . إلخ ، هذه آية موضوعها سهل ، والبحث فيها في معاملات تجري بين الناس وليس فيها ذاك التأثير الذي يؤثره مثل قوله تعالى : { كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ } [آل عمران : 185] ، فهذه تحمل معاني عظيمة ، فيها زجر وموعظة وترغيب وترهيب ، ليست كآية الدين مثلا مع أن آية الدين أطول منها " (شرح الواسطية : 1/164 – 165) . قال شيخ الإسلام – رحمه الله - : " والصواب الذي عليه جمهور السلف والأئمة : إن بعض كلام الله أفضل من بعض كما دل على ذلك الشرع والعقل . . . . إلى أن قال : فالكلام وإن اشترك من جهة المتكلم به في أنه تكلم بالجميع فقد تفاضل من جهة المتكلم فيه فإن كلامه الذي وصف به نفسه وأمر فيه بالتوحيد أعظم من كلامه الذي ذكر فيه بعض خلقه وأمر فيه بما هو دون التوحيد . و – أيضاً - فإذا كان بعض الكلام خيرا للعباد وأنفع لزم أن يكون في نفسه أفضل من هذه الجهة فإن تفاضل ثوابه ونفعه إنما هو لتفاضله في نفسه وإلا فالشيئان المتساويان من كل وجه لا يكون ثواب أحدهما أكثر ولا نفعه أعظم " (درء تعارض العقل والنقل :4/9) . المطلب الثالث / وجه كونها أعظم آية في القرآن هو بما اشتملت عليه من الأسماء الحسنى والصفات العليا المقتضيه توحده في الإلهية ، وانفراده بالعبودية التي تدل عليها كلمة الإخلاص – لا إله إلا الله – التي افتتحت بها الآية المباركة ، وهي أعلى شعب الإيمان . قال شيخ الإسلام – رحمه الله - : " فَفِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً : أَعْلَاهَا قَوْلُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إمَاطَةُ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ } فَقَدْ صَرَّحَ بِأَنَّ أَعْلَى شُعَبِ الْإِيمَانِ هِيَ هَذِهِ الْكَلِمَةُ . وَأَيْضًا فَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أبي : أَتَدْرِي أَيَّ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ أَعْظَمُ ؟ قَالَ : { اللَّهُ لَا إلَهَ إلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ } فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليهنك الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ } فَأَخْبَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَنَّهَا أَعْظَمُ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ وَفِي ذَاكَ أَنَّهَا أَعْلَى شُعَبِ الْإِيمَانِ وَهَذَا غَايَةُ الْفَضْلِ فَإِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ مُجْتَمِعٌ فِي الْقُرْآنِ وَالْإِيمَانِ فَإِذَا كَانَتْ أَعْظَمَ الْقُرْآنِ وَأَعْلَى الْإِيمَانِ ثَبَتَ لَهَا غَايَةُ الرُّجْحَانِ " (مجموع الفتاوى : 24/ 233 – 234) . ولا يشبه هذه الآية آية أخرى فيما دلت عليه من المعاني ، كما قال شيخ الإسلام – رحمه الله - : " وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ وَاحِدَةٌ تَضَمَّنَتْ مَا تَضَمَّنَتْهُ آيَةُ الْكُرْسِيِّ وَإِنَّمَا ذَكَرَ اللَّهُ فِي أَوَّلِ سُورَةِ الْحَدِيدِ وَآخِرِ سُورَةِ الْحَشْرِ عِدَّةَ آيَاتٍ لَا آيَةً وَاحِدَةً " (مجموع الفتاوى : 17/130) . فدل ذلك على تميزها ، وعظم شأنها ، وشريف معناها . المطلب الرابع / يستفاد من الحديث الدال على أن آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن : أن مذهب الصحابة هو إجراء النصوص الشرعية على ظاهرها ؛ وذلك لأن معرفة أبي – رضي الله عنه – بأنها أعظم آية في القرآن ليست من جهة اللفظ ؛ لأن القرآن من جهة المتكلم واحد ، ولا تفاضل في ذلك . وإنما التفاضل من جهة المعنى ، وهذا يدل على أن معرفته بمعاني الأسماء والصفات الوادرة فيها - والتي بلغت ستة وعشرين موضعاً – كانت على ما يظهر منها من المعنى باللسان العربي المبين . ( مستفاد من شرح الحازمي على الواسطية ) . 3. [ قوله – تعالى - : {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ } الآية] . المعنى العام لـ"ـسيدة آي القرآن " (القرطبي: 3/268) ، " هذه الآية الكريمة أعظم آيات القرآن وأفضلها وأجلها، وذلك لما اشتملت عليه من الأمور العظيمة والصفات الكريمة، فلهذا كثرت الأحاديث في الترغيب في قراءتها وجعلها وردا للإنسان في أوقاته صباحا ومساء وعند نومه وأدبار الصلوات المكتوبات، فأخبر تعالى عن نفسه الكريمة بأن { لا إله إلا هو } أي: لا معبود بحق سواه، فهو الإله الحق الذي تتعين أن تكون جميع أنواع العبادة والطاعة والتأله له تعالى، لكماله وكمال صفاته وعظيم نعمه، ولكون العبد مستحقا أن يكون عبدا لربه، ممتثلا أوامره مجتنبا نواهيه، وكل ما سوى الله تعالى باطل، فعبادة ما سواه باطلة، لكون ما سوى الله مخلوقا ناقصا مدبرا فقيرا من جميع الوجوه، فلم يستحق شيئا من أنواع العبادة، وقوله: { الحي القيوم } هذان الاسمان الكريمان يدلان على سائر الأسماء الحسنى دلالة مطابقة وتضمنا ولزوما، فالحي من له الحياة الكاملة المستلزمة لجميع صفات الذات، كالسمع والبصر والعلم والقدرة، ونحو ذلك، والقيوم: هو الذي قام بنفسه وقام بغيره، وذلك مستلزم لجميع الأفعال التي اتصف بها رب العالمين من فعله ما يشاء من الاستواء والنزول والكلام والقول والخلق والرزق والإماتة والإحياء، وسائر أنواع التدبير، كل ذلك داخل في قيومية الباري، ولهذا قال بعض المحققين: إنهما الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب، وإذا سئل به أعطى، ومن تمام حياته وقيوميته أن { لا تأخذه سنة ولا نوم } والسنة النعاس { له ما في السماوات وما في الأرض } أي: هو المالك وما سواه مملوك وهو الخالق الرازق المدبر وغيره مخلوق مرزوق مدبر لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض فلهذا قال: { من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه } أي: لا أحد يشفع عنده بدون إذنه، فالشفاعة كلها لله تعالى، ولكنه تعالى إذا أراد أن يرحم من يشاء من عباده أذن لمن أراد أن يكرمه من عباده أن يشفع فيه، لا يبتدئ الشافع قبل الإذن، ثم قال { يعلم ما بين أيديهم } أي: ما مضى من جميع الأمور { وما خلفهم } أي: ما يستقبل منها، فعلمه تعالى محيط بتفاصيل الأمور، متقدمها ومتأخرها، بالظواهر والبواطن، بالغيب والشهادة، والعباد ليس لهم من الأمر شيء ولا من العلم مثقال ذرة إلا ما علمهم تعالى، ولهذا قال: { ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض } وهذا يدل على كمال عظمته وسعة سلطانه، إذا كان هذه حالة الكرسي أنه يسع السماوات والأرض على عظمتهما وعظمة من فيهما، والكرسي ليس أكبر مخلوقات الله تعالى، بل هنا ما هو أعظم منه وهو العرش، وما لا يعلمه إلا هو، وفي عظمة هذه المخلوقات تحير الأفكار وتكل الأبصار، وتقلقل الجبال وتكع عنها فحول الرجال، فكيف بعظمة خالقها ومبدعها، والذي أودع فيها من الحكم والأسرار ما أودع، والذي قد أمسك السماوات والأرض أن تزولا من غير تعب ولا نصب، فلهذا قال: { ولا يؤوده } أي: يثقله { حفظهما وهو العلي } بذاته فوق عرشه، العلي بقهره لجميع المخلوقات، العلي بقدره لكمال صفاته { العظيم } الذي تتضائل عند عظمته جبروت الجبابرة، وتصغر في جانب جلاله أنوف الملوك القاهرة، فسبحان من له العظمة العظيمة والكبرياء الجسيمة والقهر والغلبة لكل شيء، فقد اشتملت هذه الآية على توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وعلى إحاطة ملكه وإحاطة علمه وسعة سلطانه وجلاله ومجده، وعظمته وكبريائه وعلوه على جميع مخلوقاته، فهذه الآية بمفردها عقيدة في أسماء الله وصفاته، متضمنة لجميع الأسماء الحسنى والصفات العلا " ( تيسير الكريم الرحمن للعلامة السعدي ) . المسألة الخامسة / تحرير القول في معنى الأسماء الحسنى الواردة في الآية . 1. [الله] : اسم علم على المعبود بحق ، وهو الباري - تعالى - ولا يسمى به غيره . فوائد مهمة متعلقة بلفظ الجلالة : 1. الإيمان أنه أعرف المعارف على الإطلاق وبه قال (سيبويه) وفيه قصة . 2. أنه مشتق على الصحيح، وعليه فهو يتضمن صفة الإلهية . 3. أنه لا يتم الإيمان بهذا الاسم حتى نؤمن بالأثر المترتب على ما تضمنه من صفة وذلك بأن نؤمن أنه لا يستحق أن يعبد إلا الله وحده؛ لأن معنى( الإلهية) أي: استحقاقه للعبودية وحده، فهو الإله الحق لا معبود بحق سواه . والإلهية : صفة الله – تعالى – دالة على استحقاقه العبادة وحده . فتوحيد الإلهية هو اعتقاد انفراد الله – تعالى – باستحقاق العبادة ، فكل من سواه لا يستحق العبادة، وإن عبد بسبب جهل عابديه وظلمهم . بيان صفة الإلهية . [الإلهية] في اللغة : مأخوذة من ( الإله ) . و ( إله ) بمعنى : ( مألوه ، أي: معبود ) . فهي على وزن ( فِعَال ) بمعنى : ( مفعول ) . مثل : ( كتاب ) بمعنى : ( مكتوب ). و ( المألوه ) بحق : هو الذي يستحق أن يعبد . قال ابن فارس – رحمه الله - : " (ألَه) الهمزة واللام والهاء أصل واحد، وهو التعبُّد. (فالإله) : ( الله – تعالى - )، وسمّيَ بذلك لأنّه معبود . ويقال تألّه الرجُل، إذا تعبّد. قال رؤبة: للهِ دَرُّ الغانِياتِ المُدَّهِ *** سَبَّحْنَ واستَرْجَعْنَ مِن تَأَلُّهِي " (معجم مقاييس اللغة: 1/132) . والمعبود بحق هو رب العالمين وحده لا شريك له ، وما سواه وإن عبد فليس له من الإلهية شيء على الحقيقة بل هي نسبة باطلة . قال ابن منظور – رحمه الله - : " ( الإلَهُ ) : ( الله - عز وجل - ) . وكل ما اتخذ من دونه معبوداً ( إلَهٌ ) عند متخذه ، والجمع آلِهَةٌ . (والآلِهَةُ) : ( الأَصنام ) سموا بذلك لاعتقادهم أَن العبادة تَحُقُّ لها ، وأَسماؤُهم تَتْبَعُ اعتقاداتهم لا ما عليه الشيء في نفسه " (لسان العرب:13/476) . والكلمة الدالة على هذا النوع من التوحيد هي : ( لا إله إلا الله ) ، فهي تعني : لا معبود بحق إلا الله . ولما كان ( الإله ) هو ( المعبود ) تعين علينا معرفة التعبد كي لا نصرف منه شيء لغير الله – تعالى - . وهو ما نبيته في المفردة التالية : [العبادة] : اسم يدل على تذلل ومحبة لمعظم أوجبه جلاله وجماله . فيشترط في العبادة أمران : الأول/ غاية المحبة : وهي ما امتزجت بجمال المحبوب مثمرة رجاءه وطاعته . الثاني/ غاية الذل : وهو ما امتزج بإجلال المخضوع له مثمراً خوفه والكف عن نواهيه . ولهذا قال ابن القيم – رحمه الله - : وعبادة الرحمن غايةُ حبه *** مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائرٌ *** ما دار حتى قامت القطبان فالمحبة التي هي ركن العبادة هي التي أوجبها جمال المحبوب المثمر لطاعته ورجائه . والذل الذي هو ركن العبادة هو ما أوجبه جلال المخضوع له المثمر لتعظيمه وخوفه . فكل من تعظمه القلوب : (محبة لجماله) ، (وخضوعاً لجلاله) وتصرف له الأقوال والأعمال فهو إله معبود يُرجى رغبةً ويُخاف رهبةً . فإن كان أهلاً للجمال الموجب للمحبة تعظيماً ، وأهلاً للجلال الموجب للخضوع ذلاً فهو : ( الإله الحق ) الذي تقصده القلوب عند الرغبة والرهبة . وإن لم يكن أهلاً لذلك فهي : ( الآلهة الباطلة ) التي لا تضر ولا تنفع . 2. [الْحَيُّ] : اسم لله متضمن لصفة الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال ولا يعتريها نقص بوجه من الوجوه ، التي ترجع إليها جميع صفات الكمال الذاتية . قال شيخ الإسلام – رحمه الله - : " فَالْحَيُّ نَفْسُهُ مُسْتَلْزِمٌ لِجَمِيعِ الصِّفَاتِ وَهُوَ أَصْلُهَا " (مجموع الفتاوى : 18/311) . ووجه ذلك ما بينه العلامة الهراس – رحمه الله - : " فَذَكَرَ أَنَّهُ الْحَيُّ الَّذِي لَهُ كَمَالُ الْحَيَاةِ ؛ لِأَنَّ حَيَاتَهُ مِنْ لَوَازِمِ ذَاتِهِ ، فَهِيَ أَزَلِيَّةٌ أَبَدِيَّةٌ ، وَكَمَالُ حَيَاتِهِ يَسْتَلْزِمُ ثُبُوتَ جَمِيعِ صِفَاتِ الْكَمَالِ الذَّاتِيَّةِ لَهُ ، مِنَ الْعِزَّةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ وَالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالْإِرَادَةِ وَالْمَشِيئَةِ وَغَيْرِهَا ؛ إِذْ لَا يَتَخَلَّفُ شَيْءٌ مِنْهَا إِلَّا لِنَقْصٍ فِي الْحَيَاةِ ، فَالْكَمَالُ فِي الْحَيَاةِ يَتْبَعُهُ الْكَمَالُ فِي سَائِرِ الصِّفَاتِ اللَّازِمَةِ لِلْحَيِّ " (شرح الواسطية: ص/69) . * * * وحقيقة ما يدل عليه هذا الاسم أن الله – تعالى – هو " الدائم الباقي الذي له كمال الحياة والذي لا سبيل للفناء عليه " (شرح الواسطية للفوزان: ص/19) . * * * واسم الله " «الحي»: جاء مفرداً في قوله: { وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ } [58/25]، وفي قوله: { هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ } [65/40] ومقرونا في قوله: { الْحَيُّ الْقَيُّومُ } في ثلاثة مواضع [255/2 و 2/3 و 111/20]." (المستدرك على مجموع الفتاوى : 1/50) . فهذه خمسة مواضع في القرآن ورد فيها اسم الله - عز وجل – (الْحَيُّ)، ثلاثة منها اقترنت باسمه (الْقَيُّومُ)، واثنان منها لم تقترن به. * * * وقد اجتمعت الأدلة النقلية والعقلية على إثبات أنه (الحي) سبحانه . قال شيخ الإسلام – رحمه الله - : " فيقال لا ريب أن الله حي كما نطقت بذلك كتبه المنزلة التي هي آياته القولية ، ودلت على ذلك آياته كمخلوقاته التي هي آياته الفعلية. قال تعالى {الله لا إله إلا هو الحي القيوم} وقال – تعالى -:{ وتوكل على الحي الذي لا يموت} والدلائل على حياته كثيرة منها : أنه قد ثبت أنه عالم والعلم لا يقوم إلا بحي وثبت أنه قادر مختار يفعل بمشيئته والقادر المختار لا يكون إلا حياً . ومنها : أنه خالق الأحياء وغيرهم والخالق أكمل من المخلوق فكل كمال ثبت للمخلوق فهو من الخالق فيمتنع أن يكون المخلوق أكمل من خالقه وكماله أكمل منه . ومنها : أن الحي أكمل من غير الحي كما قال – تعالى -: { وما يستوي الأحياء ولا الأموات }. فلو كان الخالق غير حي لزم أن يكون الممكن المحدث المخلوق أكمل من الواجب القديم الخالق فيكون أنقص الموجودين أكمل من أكملها " (بتصرف يسير من الجواب الصحيح : 3/208) . * * * تنبيه : الاتفاق في الاسم العام لا يقتضي الاتفاق في المسميات . قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - : " وَاتِّفَاقُهُمَا فِي اسْمٍ عَامٍّ : لَا يَقْتَضِي تَمَاثُلَهُمَا فِي مُسَمَّى ذَلِكَ الِاسْمِ عِنْدَ الْإِضَافَةِ وَالتَّخْصِيصِ وَالتَّقْيِيدِ وَلَا فِي غَيْرِهِ . فَلَا يَقُولُ عَاقِلٌ إذَا قِيلَ أَنَّ الْعَرْشَ شَيْءٌ مَوْجُودٌ وَأَنَّ الْبَعُوضَ شَيْءٌ مَوْجُودٌ : إنَّ هَذَا مِثْلَ هَذَا ؛ لِاتِّفَاقِهِمَا فِي مُسَمَّى الشَّيْءِ وَالْوُجُودِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَارِجِ شَيْءٌ مَوْجُودٌ غَيْرُهُمَا يَشْتَرِكَانِ فِيهِ بَلْ الذِّهْنُ يَأْخُذُ مَعْنًى مُشْتَرَكًا كُلِّيًّا هُوَ مُسَمَّى الِاسْمِ الْمُطْلَقِ وَإِذَا قِيلَ هَذَا مَوْجُودٌ وَهَذَا مَوْجُودٌ : فَوُجُودُ كُلٍّ مِنْهُمَا يَخُصُّهُ لَا يَشْرَكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ ؛ مَعَ أَنَّ الِاسْمَ حَقِيقَةٌ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا وَلِهَذَا سَمَّى اللَّهُ نَفْسَهُ بِأَسْمَاءِ وَسَمَّى صِفَاتِهِ بِأَسْمَاءِ ؛ وَكَانَتْ تِلْكَ الْأَسْمَاءُ مُخْتَصَّةً بِهِ إذَا أُضِيفَتْ إلَيْهِ لَا يَشْرَكُهُ فِيهَا غَيْرُهُ وَسَمَّى بَعْضَ مَخْلُوقَاتِهِ بِأَسْمَاءِ مُخْتَصَّةٍ بِهِمْ مُضَافَةٍ إلَيْهِمْ تُوَافِقُ تِلْكَ الْأَسْمَاءَ إذَا قُطِعَتْ عَنْ الْإِضَافَةِ وَالتَّخْصِيصِ ؛ وَلَمْ يَلْزَمْ مِنْ اتِّفَاقِ الِاسْمَيْنِ وَتَمَاثُلِ مُسَمَّاهُمَا وَاتِّحَادِهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَالتَّجْرِيدِ عَنْ الْإِضَافَةِ وَالتَّخْصِيصِ : اتِّفَاقُهُمَا وَلَا تَمَاثُلَ الْمُسَمَّى عِنْدَ الْإِضَافَةِ وَالتَّخْصِيصِ فَضْلًا عَنْ أَنْ يَتَّحِدَ مُسَمَّاهُمَا عِنْدَ الْإِضَافَةِ وَالتَّخْصِيصِ . فَقَدْ سَمَّى اللَّهُ نَفْسَهُ حَيًّا فَقَالَ : { اللَّهُ لَا إلَهَ إلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ } وَسَمَّى بَعْضَ عِبَادِهِ حَيًّا ؛ فَقَالَ : { يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ } وَلَيْسَ هَذَا الْحَيُّ مِثْلَ هَذَا الْحَيِّ لِأَنَّ قَوْلَهُ الْحَيَّ اسْمٌ لِلَّهِ مُخْتَصٌّ بِهِ وَقَوْلَهُ :{ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ } اسْمٌ لِلْحَيِّ الْمَخْلُوقِ مُخْتَصٌّ بِهِ وَإِنَّمَا يَتَّفِقَانِ إذَا أُطْلِقَا وَجُرِّدَا عَنْ التَّخْصِيصِ ؛ وَلَكِنْ لَيْسَ لِلْمُطْلَقِ مُسَمًّى مَوْجُودٌ فِي الْخَارِجِ وَلَكِنَّ الْعَقْلَ يَفْهَمُ مِنْ الْمُطْلَقِ قَدْرًا مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْمُسَمَّيَيْنِ وَعِنْدَ الِاخْتِصَاصِ يُقَيِّدُ ذَلِكَ بِمَا يَتَمَيَّزُ بِهِ الْخَالِقُ عَنْ الْمَخْلُوقِ وَالْمَخْلُوقُ عَنْ الْخَالِقِ وَلَا بُدَّ مِنْ هَذَا فِي جَمِيعِ أَسْمَاءِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ يُفْهَمُ مِنْهَا مَا دَلَّ عَلَيْهِ الِاسْمُ بِالْمُوَاطَأَةِ وَالِاتِّفَاقِ وَمَا دَلَّ عَلَيْهِ بِالْإِضَافَةِ وَالِاخْتِصَاصِ : الْمَانِعَةُ مِنْ مُشَارَكَةِ الْمَخْلُوقِ لِلْخَالِقِ فِي شَيْءٍ مِنْ خَصَائِصِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى . " (مجموع الفتاوى : 3/11) . (يتبع القسم الأخير من الدرس السادس – إن شاء الله - ) . |
|
#60
|
|||
|
|||
|
*هل يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ،وصف ربه عز وجل بصفة (لم يصف ربنا تعالى نفسه بها)؟=(ليس فيما لم يأذن الله تعالى بها فتنبهوا)..
* ما الفائدة من ذلك ؟
__________________
قال ابن تيمية:"و أما قول القائل ؛إنه يجب على [العامة] تقليد فلان أو فلان'فهذا لا يقوله [مسلم]#الفتاوى22_/249 قال شيخ الإسلام في أمراض القلوب وشفاؤها (ص: 21) : (وَالْمَقْصُود أَن الْحَسَد مرض من أمراض النَّفس وَهُوَ مرض غَالب فَلَا يخلص مِنْهُ إِلَّا الْقَلِيل من النَّاس وَلِهَذَا يُقَال مَا خلا جَسَد من حسد لَكِن اللَّئِيم يبديه والكريم يخفيه). |
 |
|
|
 |
 |