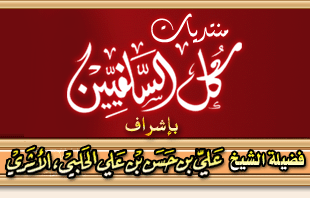


 |
 |
أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
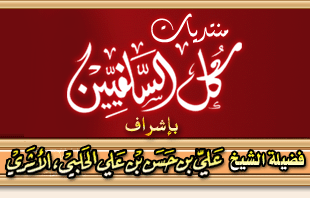 |
 |
 |
|||||
|
|||||||
| 84233 | 98094 |
|
#61
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
تماما....هذا هو المقصود
__________________
قال ابن تيمية:"و أما قول القائل ؛إنه يجب على [العامة] تقليد فلان أو فلان'فهذا لا يقوله [مسلم]#الفتاوى22_/249 قال شيخ الإسلام في أمراض القلوب وشفاؤها (ص: 21) : (وَالْمَقْصُود أَن الْحَسَد مرض من أمراض النَّفس وَهُوَ مرض غَالب فَلَا يخلص مِنْهُ إِلَّا الْقَلِيل من النَّاس وَلِهَذَا يُقَال مَا خلا جَسَد من حسد لَكِن اللَّئِيم يبديه والكريم يخفيه). |
|
#62
|
|||
|
|||
|
3. [الْقَيُّومُ] : اسم لله – تعالى – متضمن لصفة القيومية الدالة على غناه الذاتي لكماله المطلق ، وفقر جميع المخلوقات إليه في إيجادها وإعدادها وإمدادها ، فهو :" القائم المقيم لما سواه " (الجواب الصحيح :3/209) . والقيوم : لغة : ( فيعول ) من صيغة مبالغة . " أصله القيووم فلما اجتمعت الياء والواو والسابق ساكن جعلتا ياء مشددة " (الزاهر في معاني كلام الناس :1/85) . فهو " المبالغ في القيام بكل ما خَلَقَ وما أراد ، فَيْعُولٌ من ا لقيامِ " (المخصص لابن سيده : 5/226) . قال ابن منظور – رحمه الله - : " والقَيُّومُ من أَسماء الله المعدودة وهو القائم بنفسه مطلقاً لا بغيره ، وهو مع ذلك يقوم به كل موجود حتى لا يُتَصوَّر وجود شيء ولا دوام وجوده إلا به " ( لسان العرب :12/496) . فهو " الَّذِي قَامَ بِنَفْسِهِ ، وَاسْتَغْنَى عَنْ جَمِيعِ خَلْقِهِ غِنًى مُطْلَقًا لَا تَشُوبُهُ شَائِبَةُ حَاجَةٍ أَصْلًا ؛ لِأَنَّهُ غِنًى ذَاتِيٌّ ، وَبِهِ قَامَتِ الْمَوْجُودَاتُ كُلُّهَا ، فَهِيَ فَقِيرَةٌ إِلَيْهِ فَقْرًا ذَاتِيًّا ، بِحَيْثُ لَا تَسْتَغْنِي عَنْهُ لَحْظَةً ، فَهُوَ الَّذِي ابْتَدَأَ إِيجَادَهَا عَلَى هَذَا النَّحْوِ مِنَ الْإِحْكَامِ وَالْإِتْقَانِ ، وَهُوَ الَّذِي يُدَبِّرُ أُمُورَهَا ، وَيُمِدُّهَا بِكُلِّ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي بَقَائِهَا ، وَفِي بُلُوغِ الْكَمَالِ الَّذِي قَدَّرَهُ لَهَا " (شرح الواسطية للهراس: ص/70) . قال – تعالى - : { أَفَمَنْ هُوَ قَآئِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ } قال الطبري – رحمه الله - : " يقول تعالى ذكره: أفَالرَّبُ الذي هو دائمٌ لا يَبيدُ ولا يَهْلِك ، قائم بحفظ أرزاق جميع الخَلْق، متضمنٌ لها، عالمٌ بهم وبما يكسبُونه من الأعمال، رقيبٌ عليهم، لا يَعْزُب عنه شيء أينما كانوا، كَمن هو هالك بائِدٌ لا يَسمَع ولا يُبصر ولا يفهم شيئًا، ولا يدفع عن نفسه ولا عَمَّن يعبده ضُرًّا، ولا يَجْلب إليهما نفعًا؟ كلاهما سَواءٌ ؟ " ( جامع البيان: 16/462) . تنبيه : القيومية تدل على صفتين : الأولى / صفة ذاتية : وتشمل : (غناه المطلق) - الغنى الذاتي - ، (ودوامه ، وأزليته) فهو : " الدائم الباقي الذي لا يزول، ولا يعدم، ولا يفنى بوجه من الوجوه " (مجموع الفتاوى :1/25). الثانية / صفة فعلية : وهي قيام المخلوقات به ، وفقرها المطلق إليه سبحانه فقراً ذاتياً لا تنفك عنه ، فهو القائم على كل نفس بتدبير شؤونها في إيجادها وإعدادها وإمدادها . فائدة متعلقه باسم الله – تعالى - : { الْقَيُّومُ } . قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - : " وادعيت أيها المريسي في قول الله : { الله لا إله إلا هو الحي القيوم } ( البقرة : 255 ) وادعيت أن تفسير القيوم عندك لا يزول يعني الذي لا ينزل ولا يتحرك ولا يقبض ولا يبسط وأسندت ذلك عن بعض أصحابك غير مسمى عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال : القيوم الذي لا يزول ومع روايتك هذه عن ابن عباس دلائل وشواهد أنها باطلة : إحداها : أنك رويتها وأنت المتهم في توحيد الله والثانية : أنك رويته عن بعض أصحابك غير مسمى وأصحابك مثلك في الظنة والتهمة والثالثة : أنه عن الكلبي وقد أجمع أهل العلم بالأثر على أن لا يحتجوا بالكلبي في أدنى حلال ولا حرام فكيف في تفسير توحيد الله وتفسير كتابه ؟ وكذلك أبو صالح ولو قد صحت روايتك عن ابن عباس أنه قال : ( القيوم : الذي لا يزول ) لم نستنكره وكان معناه مفهوما واضحا عند العلماء وعند أهل البصر بالعربية : أن معنى لا يزول لا يفنى ولا يبيد لا أنه لا يتحرك ولا يزول من مكان إلى مكان إذا شاء كما كان يقال للشيء الفاني : هو زائل كما قال لبيد : ( ألا كل شيء ما خلا الله باطل ... وكل نعيم لا محالة زائل ) يعني: فانٍ ، لا أنه متحرك ؛ فإن أمارة ما بين الحي والميت التحرك وما لا يتحرك فهو ميت لا يوصف بحياة كما لا توصف الأصنام الميتة قال الله تعالى : { والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون } { أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون } ( النحل : 20 - 21 ) فالله الحي القيوم القابض الباسط يتحرك إذا شاء وينزل إذا شاء ويفعل ما يشاء بخلاف الأصنام الميتة التي لا تزول حتى تزال " (درء تعارض العقل والنقل :1/271) . ــــــ تتمة متعلقة بمبحث ( الاسم الأعظم ) : هل هو : (الْحَيُّ الْقَيُّومُ) أم غيره ؟ لقد اختلفت أقوال العلماء في تحديد الاسم الأعظم ، وهل هو اسم معين أم اسم جنس ؟ وقبل التفصيل في ذلك نقرر بعض القواعد المهمة : القاعدة الأولى / تفاضل الأسماء الحسنى . قال شيخ الإسلام – رحمه الله - : " وَكَمَا أَنَّ أَسْمَاءَهُ وَصِفَاتِهِ مُتَنَوِّعَةٌ فَهِيَ أَيْضًا مُتَفَاضِلَةٌ كَمَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ مَعَ الْعَقْلِ وَإِنَّمَا شُبْهَةُ مَنْ مَنَعَ تَفَاضُلَهَا مِنْ جِنْسِ شُبْهَةِ مَنْ مَنَعَ تَعَدُّدَهَا وَذَلِكَ يَرْجِعُ إلَى نَفْيِ الصِّفَاتِ " (مجموع الفتاوى : 17/212) . القاعدة الثانية / إخفاء الاسم الأعظم من باب الاجتهاد في طلبه والمحافظة عليها . وهي كالحكمة من عدم عد التسعة والتسعين اسماً ليجتهدوا في طلبها ، " وأخفى الاسم الأعظم في الأسماء ليحافظوا على جميعها ". ذكر هذا القول البغوي في تفسيره : ( 1/289 ) ونسبه إلى البعض، ولم يبين. وكذلك صاحب : (اللباب في علوم الكتاب :20/432) ، (تفسير السراج المنير / لمحمد بن أحمد الشربيني :4/654). القاعدة الثالثة / روج أهل البدع من خلال معرفة الاسم الأعظم كثيراً من الأكاذيب فوجب الحذر في نقل أخبار هذا الباب . قال عبد الرزاق البدر – حفظه الله - : " وبعض المتصوفة لهم في هذا الباب أباطيل كثيرة لا يلتفت إلى شيء منها ويروون في ذلك أحاديث موضوعة وآثاراً نخترعة وقصصا منكرة يخدعون بها عوام المسلمين ويغرون بها جهالهم . والواجب على كل مسلم أن يكون في دينه لى حيطة وحذر من الوقوع في إفك هؤلاء وباطلهم " (فقه الأدعية والأذكار :1/145) . ومنه : القول بأن الاسم الأعظم ( سر مكنون ) خصّ الله به بعض عباده قول باطل . القاعدة الرابعة / لقبول الدعاء شروط ، وتمنع منه موانع . فالواجب على العبد حتى يستجيب الله دعاءه أن يتحقق من شروط إجابة الدعاء ويتخلي من موانعه متحرياً مواضع رضا الله – تعالى - . فقد يأتي العبد بالاسم الأعظم ولا يستجاب له لتخلف شرط ، أو لوجود مانع . *** اعلم - وفقك الله – أن العلماء قد اختلفوا في تعيين الاسم الأعظم على نحو من أربعين قولاً ، قال الشوكاني – رحمه الله - : " وقد اختلف في تعيين الاسم الأعظم على نحو أربعين قولاً ، وقد أفردها السيوطي بالتصنيف " (تحفة الذلكرين :ص/67) . ولم يذكر السيوطي في كتابه الذي أفرده في ذلك ، والذي أسماه : " الدُّرُّ المنظم في الاسم الأعظم " سوى عشرين قولاً " (فقه الأدعية والأذكار : 1/145) . وقال ابن حجر في (الفتح 11/224):" وجملة ما وقفت عليه من ذلك أربعة عشر قولاً ". قال الألباني – رحمه الله - : " واعلم أن العلماء اختلفوا في تعيين اسم الله الأعظم على أربعة عشر قولاً ، ساقها الحافظ في "الفتح" ، وذكر لكل قول دليله ، وأكثرها أدلتها من الأحاديث ، وبعضها مجرد رأي لا يلتفت إليه ، مثل القول الثاني عشر ؛ فإن دليله : أن فلاناً سأل الله أن يعلمه الاسم الأعظم ، فرأى في النوم ؛ هو : الله ، الله ، الله ، الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم!! وتلك الأحاديث منها الصحيح " ، ولكنه ليس صريح الدلالة ، ومنها الموقوف كهذا ، ومنها الصريح الدلالة ؛ وهو قسمان : قسم صحيح صريح ، وهو حديث بريدة : "الله لا إله إلا هو ، الأحد الصمد الذي لم يلد ... " إلخ ، وقال الحافظ : "وهو أرجح من حيث السند من جميع ما ورد في ذلك " . وهو كما قال رحمه الله ، وأقره الشوكاني في "تحفة الذاكرين " (ص 52) ، وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (1341) . والقسم الآخر : صريح غير صحيح ، بعضه مما صرح الحافظ بضعفه ؛ كحديث القول الثالث عن عائشة في ابن ماجه (3859) ، وهو في "ضعيف ابن ماجه " رقم (841) ، وبعضه مما سكت عنه ؛ فلم يحسن! كحديث القول الثامن من حديث معاذ ابن جبل في الترمذي ، وهو مخرج في "الضعيفة" برقم (4520) . وهناك أحاديث أخرى صريحة لم يتعرض الحافظ لذكرها ولكنها واهية ، وهي مخرجة هناك برقم (2772 و 2773 و 2775) " (السلسلة الضعيفة : رقم :6124). وعلى كل فأظهر الأقوال في ذلك ثلاثة أقوال - وهناك قول رابع قال به بعض الأئمة ذكرته للرد عليه - : القول الأول : أنه لفظ الجلالة ( الله ) . قال أبو حنيفة : " هو الإسم الأعظم " (تفسير العز بن عبد السلام :1/88) . وقال ابن منده – رحمه الله - : " ذكر معرفة اسم الله الأكبر الذي تسمى به وشرفه على الأذكار كلها فقال: - عز وجل - : {ولذكر الله أكبر} ، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم : {فاعلم أنه لا إله إلا الله} ، وقال : {ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها} ، وقال : {يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا} ، فاسمه (الله) معرفة ذاته ، منع الله عز وجل خلقه أن يتسمى به أحد من خلقه ، أو يدعى باسمه إله من دونه ، جعله أول الإيمان ، وعمود الإسلام ، وكلمة الحق والإخلاص ، ومخالفة الأضداد والإشراك فيه ، يحتجز القاتل من القتل ، وبه يفتتح الفرائض ، وتنعقد الأيمان ، ويستعاذ من الشيطان ، وباسمه يفتتح ويختم الأشياء ، تبارك اسمه ولا إله غيره " (التوحيد : 2/21) . وقال ابن كثير – رحمه الله -: " { الله } عَلَمٌ على الرب تبارك وتعالى، يقال: إنه الاسم الأعظم؛ لأنه يوصف بجميع الصفات، كما قال تعالى: { هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ * هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ * هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الأسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } [الحشر: 22 -24]، فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات له، كما قال تعالى: { وللهِ الأسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا } وقال تعالى: { قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأسْمَاءُ الْحُسْنَى } [الإسراء: 110] وفي الصحيحين، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن لله تسعة وتسعين اسما، مائة إلا واحدًا من أحصاها دخل الجنة" (التفسير : 1/122) . " ونقل البندنيجي عن أكثر العلماء أن الاسم الأعظم هو الله " (تفسير السراج المنير / لمحمد بن أحمد الشربيني : 1/223). وبه يقول الألباني – رحمه الله - :" يقيناً اسم الله الأعظم هو : ( الله ) اسم الذات " (سلسلة الهدى والنور ، شريط : 616) . القول الثاني : أنه ( الحي القيوم ) . قال النووي – رحمه الله - : " قال بعض الأئمة المتقدمين: هو الحي القيوم؛ لأنه في البقرة في آية الكرسي، وفي أول آل عمران، وفي طه في قوله تعالى: {وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ}، وهذا الاستنباط حسن "والله أعلم" (المسائل المنثورة :ص/277) . و" قال ابن القيم : وقال لي شيخنا - يوماً -: لهذين الاسمين وهما : (الحي القيوم) تأثير عظيم في حياة القلب وكان يشير إلى أنهما الاسم الأعظم "( المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام :1/177) . قال شيخ الإسلام – رحمه الله - : " الحي، القيوم يجمع أصل معاني الأسماء والصفات، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله إذا اجتهد في الدعاء " (التوسل والوسيلة /ص: 93). وبين أنه الاسم الأعظم في : (مجموع الفتاوى : 18/311) . قال السعدي – رحمه الله - : " ولهذا ورد أن الحي القيوم هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب وإذا سئل به أعطى ؛ بدلالة الحي على الصفات الذاتية والقيوم على الصفات الفعلية ، والصفات كلها ترجع إليهما " (التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة للسعدي : ص/24) ، ونسبه للمحققين في تفسيره آية الكرسي ، واختاره ابن القيم كما في زاد المعاد (4/204) ، (مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين :8/135) ، (شرح الواسطية للهراس :ص/70) ، (شرح الواسطية للفوزان : 1/19) . وقال ابن القيم في نونيته: وله الحياة كمالها فلأجل ذا *** ما للممات عليه من سلطان وكذلك القيوم من أوصافه *** ما للمنام لديه من غشيان وكذاك أوصاف الكمال جميعها *** ثبتت له ومدارها الوصفان القول الثالث / وقال السعدي – رحمه الله - : " وقد سئل الشيخ رحمه الله عن الاسم الأعظم من أسماء الله هل هو اسم معين معروف أو اسم غير معين ولا معروف. فأجاب: "بعض الناس يظن أن الاسم الأعظم من أسماء الله الحسنى لا يعرفه إلا من خصه الله بكرامة خارقة للعادة، وهذا ظن خطأ، فإن الله تبارك وتعالى حثنا على معرفة أسمائه وصفاته، وأثنى على من عرفها، وتفقه فيها، ودعاء الله بها دعاء عبادة وتعبد ودعا مسألة، ولا ريب أنّ الاسم الأعظم منها أولاها بهذا الأمر، فإنه تعالى هو الجواد المطلق الذي لا منتهى لجوده وكرمه، وهو يحب الجود على عباده، ومن أعظم ما جاد به عليهم تعرفه لهم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، فالصواب أنّ الأسماء الحسنى كلها حسنى، وكل واحد منها عظيم، ولكن الاسم الأعظم منها كل اسم مفرد أو مقرون مع غيره إذا دل على جميع صفاته الذاتية والفعلية أو دل على معاني جميع الصفات مثل: الله، فإنه الاسم الجامع لمعاني الألوهية كلها، وهي جميع أوصاف الكمال، ومثل الحميد المجيد، فإن الحميد الاسم الذي دل على جميع المحامد والكمالات لله تعالى، والمجيد الذي دل على أوصاف العظمة والجلال ويقرب من ذلك الجليل الجميل الغني الكريم. ومثل الحي القيوم، فإن الحي من له الحياة الكاملة العظيمة الجامعة لجميع معاني الذات، والقيوم الذي قام بنفسه، واستغنى عن جميع خلقه، وقام بجميع الموجودات، فهو الاسم الذي تدخل فيه صفات الأفعال كلها. ومثل اسمه العظيم الكبير الذي له جميع معاني العظمة والكبرياء في ذاته وأسمائه وصفاته، وله جميع معاني التعظيم من خواص خلقه. ومثل قولك: يا ذا الجلال والإكرام، فإن الجلال صفات العظمة، والكبرياء، والكمالات المتنوعة، والإكرام استحقاقه على عباده غاية الحب وغاية الذل وما أشبه ذلك. فعلم بذلك أن الاسم الأعظم اسم جنس، وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة الشرعية والاشتقاق، كما في السنن أنه سمع رجلاً يقول: "اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، فقال: "والذي نفسي بيده، لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى". وكذلك الحديث الآخر حين دعا الرجل، فقال: "اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، المنان، بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، ياحي! يا قيوم! فقال صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده، لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى". وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: {وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ} 2 {اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} 3 رواه أبو داود والترمذي4، فمتى دعا الله العبد باسم من هذه الأسماء العظيمة بحضور قلب ورقة وانكسار، لم تكد ترد له دعوة، والله الموفق" (تفسير اسماء الله الحسنى :ص:167) . القول الرابع / قال السيوطي – رحمه الله - : " أنه لا وجود له بمعنى أن أسماء الله تعالى كلها عظيمة لا يجوز تفضيل بعضها على بعض ذهب إلى ذلك قوم منهم أبو جعفر الطبري وأبو الحسن الأشعري وأبو حاتم بن حبان والقاضي أبو بكر الباقلاني، ونحوه قول مالك وغيره لا يجوز تفضيل بعض الأسماء على بعض وحمل هؤلاء ما ورد من ذكر الاسم الأعظم على أن المراد به العظيم، وعبارة الطبري اختلفت الآثار في تعيين الاسم الأعظم والذي عندي أن الأقوال كلها صحيحة إذ لم يرد في خبر منها أنه الاسم الأعظم ولا شيء أعظم منه فكأنه تعالى يقول كل اسم من أسمائي يجوز وصفه بكونه أعظم فيرجع إلى معنى عظيم " (الحاوي :2/83) . وبه يقول ابن باز – رحمه الله - : " كل اسماء الله يقال لها الأعظم ... كل اسماء الله عظمى " (نور على الدرب :435) ، " الحي القيوم من أسماء الله العظيمة ... لأن اسماء الله كلها عظمى " (شرح الواسطية شريط:1) ، " الأعظم معناه الاسم العظيم لأن الاسم الأعظم ورد في احاديث كثيرة، والله أعلم معناه الاسم العظيم " (الوابل الصيب شريط : 5) . وهذا القول مردود لأن التفاضل ثابت في أسماء الله – تعالى – وانظر تفصيل القول في هذا المبحث من مجموع الفتاوى (17/66) . (يتبع ... ) - إن شاء الله - . ملاحظة : اعتذر من الأخوة على الاطالة لكن الموضوع كما لا يخفى يقتضي ذلك ، وكثرت أجزاءه حتى لا يطول الموضوع في موضع واحد فيبعث على الملل ، والله الموفق . |
|
#63
|
|||
|
|||
|
القسم الأخير من بيان معاني آية الكرسي . 4 . [الْعَلِيُّ] : اسم لله – تعالى – يدل على إثبات صفة العلو الكامل المطلق له : ويتضمن علو الذات ، والقدر ، والقهر . وحقيقة ذلك : 1- أن له علو الذات ومعناه : أنه مستو على عرشه، فوق جميع خلقه، مباين لهم، وهو مع هذا مطلع على أحوالهم، مشاهد لهم، مدبر لأمورهم الظاهرة والباطنة . 2 - وله علو القدر ومعناه : علو صفاته ، " إذ إن له كل صفة كمال ، وله من تلك الصفة أعلاها وغايتها " . 3 - وله علو القهر ومعناه : أنه الواحد القهار الذي قهر بعزته وعلوه الخلق كلّهم، فنواصيهم بيده . (ينظر : الحق الواضح المبين ص/26 ، وشرح النونية للهراس : 2/68) . قال ابن عثيمين – رحمه الله - : " { الْعَلِيُّ } على وزن فعيل وهي صفة مشبهة ؛ لأن علوه – عز وجل – لازم لذاته " ( شرح العقيدة الواسطية : 1/172 – 173 ) . وقد ورد اسمه : ( الْعَلِيُّ ) في القرآن في سبعة مواضع : موضعين مقترن ( بالعظيم ) ، وهما : ما جاء في آية الكرسي، وقوله : { لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَهُوَ العَلِيُّ العَظِيمُ } [الشورى:4] ، وخمس مواضع مقترن ( بالكبير ) ، وهي قوله – تعالى -: {وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ }[الحج : 62] ، و [لقمان : 30] وقوله :{ قالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ }[سبأ :23] . وقوله : { فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ}[غافر : 12] . وقوله : {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً} [النساء:34] . وورد في السنة في موضعين . قال ابن عثيمين – رحمه الله - : " وأدلة العلو: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة . • فمن الكتاب قوله – تعالى - : { وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ } [البقرة: 255]. • ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: " ربنا الله الذي في السماء " . • وأما الإجماع على علو الله فهو معلوم بين السلف ولم يُعلم أن أحداً منهم قال بخلافه . قلت : قال شيخ الإسلام – رحمه الله - : " رَوَى أَبُو بَكْرٍ البيهقي فِي " الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ " بِإِسْنَادِ صَحِيحٍ عَنْ الأوزاعي قَالَ : كُنَّا - وَالتَّابِعُونَ مُتَوَافِرُونَ - : نَقُولُ إنَّ اللَّهَ - تَعَالَى ذِكْرُهُ - فَوْقَ عَرْشِهِ وَنُؤْمِنُ بِمَا وَرَدَتْ فِيهِ السُّنَّةُ مِنْ صِفَاتِهِ " ( مجموع الفتاوى:5/39) . • وأما العقل ، فلأن العلو صفة كمال ، والله سبحانه متصف بكل كمال، فوجب ثبوت العلو له . • وأما الفطرة فإن كل إنسان مفطور على الإيمان بعلو الله، ولذلك إذا دعا ربه وقال: يارب، لم ينصرف قلبه إلا إلى السماء " ( بتصرف يسير من مذكرة على العقيدة الواسطية ص/ 36) . قلت : قال ابن أبي العز الحنفي – رحمه الله - : " وَأَمَّا ثُبُوتُهُ بِالْفِطْرَةِ، فَإِنَّ الْخَلْقَ جَمِيعًا بِطِبَاعِهِمْ وَقُلُوبِهِمُ السَّلِيمَةِ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ، وَيَقْصِدُونَ جِهَةَ الْعُلُوِّ بِقُلُوبِهِمْ عِنْدَ التَّضَرُّعِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ طَاهِرٍ الْمَقْدِسِيُّ أَنَّ الشَّيْخَ أَبَا جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيَّ حَضَرَ مَجْلِسَ الْأُسْتَاذِ أَبِي الْمَعَالِي الْجُوَيْنِيِّ الْمَعْرُوفِ بِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ، وَهُوَ يَتَكَلَّمُ فِي نَفْيِ صِفَةِ الْعُلُوِّ، وَيَقُولُ: كَانَ اللَّهُ وَلَا عَرْشَ وَهُوَ الْآنَ عَلَى مَا كَانَ! فَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو جَعْفَرٍ: أَخْبِرْنَا يَا أُسْتَاذُ عَنْ هَذِهِ الضَّرُورَةِ الَّتِي نَجِدُهَا فِي قُلُوبِنَا؟ فَإِنَّهُ مَا قَالَ عَارِفٌ قَطُّ: يَا اللَّهُ، إِلَّا وَجَدَ فِي قَلْبِهِ ضَرُورَةً تَطْلُبُ الْعُلُوَّ، لَا يَلْتَفِتُ يَمْنَةً وَلَا يَسْرَةً، فَكَيْفَ نَدْفَعُ هَذِهِ الضَّرُورَةَ عَنْ أَنْفُسِنَا؟ قَالَ: فَلَطَمَ أَبُو الْمَعَالِي عَلَى رَأْسِهِ وَنَزَلَ، وَأَظُنُّهُ قَالَ: وَبَكَى! وَقَالَ: حَيَّرَنِي الْهَمَذَانِيُّ حَيَّرَنِي! " (شرح العقيدة الطحاوية ص/ 270) . تنبيه : الكلام على صفة العلو بتفصيل وبيان الأقوال المخالفة وشبههم سيأتي تفصيله – إن شاء الله – في موضعه من كلام المصنف – رحمه الله - . 5 . [الْعَظِيمُ] : اسم لله – تعالى – دال على عظمته وتعظيمه ، فله من كل صفة كمال أعظمها ، وهو منفرد بها تعظيماً . قال ابن عثيمين – رحمه الله - : " العظيم . . . صفة مشبهة " ( شرح الواسطية : 1/173) . وحقيقة العظيم : هو من اتصف بصفات عديدة ، وله من كل صفة أكملها ، وأنه المستحق للتعظيم وحده في قلوب عباده . فصفة العظمة نوعان : أحدهما: أنه موصوف بكل صفة كمال، وله من ذلك الكمال أكمله، وأعظمه وأوسعه . النوع الثاني: أنه لا يستحق أحد من الخلق أن يعظم كما يعظم الله فيستحق جل جلاله من عباده أن يعظموه بقلوبهم، وألسنتهم، وجوارحهم . ( ينظر : الحق الواضح المبين ص27- 28 ، وشرح القصيدة النونية للهراس : 2/68). قال العلامة الهراس – رحمه الله - : " وَأَمَّا الْعَظِيمُ فَمَعْنَاهُ الْمَوْصُوفُ بِالْعَظَمَةِ ، الَّذِي لَا شَيْءَ أَعْظَمُ مِنْهُ ، وَلَا أَجَلُّ ، وَلَا أَكْبَرُ ، وَلَهُ سُبْحَانَهُ التَّعْظِيمُ الْكَامِلُ فِي قُلُوبِ أَنْبِيَائِهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَأَصْفِيَائِهِ " ( شرح العقيدة الواسطية ص/ 74 ) . ورد اسمه العظيم في القرآن في ستة مواضع : مقترنا بلفظ الجلالة ( الله ) ، وهو قوله : {إِنَّهُ كَانَ لا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ العَظِيمِ }[الحاقة : 33] . ومقترنا بالرب مقصوداً بالتسبيح به خاصه وهو قوله : { فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ العَظِيمِ } في ثلاثة مواضع : [الواقعة : 74 و : 96] ، [الحاقة : 52] . واقترن باسمه ( العلي ) في موضعين كما سبق بيانه . وأما في السنة فقد ورد في مواضع كثيرة . المسألة السادسة / الفوائد المسلكية ، وغيرها . الفائدة الأولى / تأثير الحي القيوم على حياة القلوب . قال ابن القيم – رحمه الله - : " وقال لي شيخنا يوما لهذين الاسمين وهما : ( الحي القيوم ) تأثير عظيم في حياة القلب وكان يشير إلى أنهما الاسم الأعظم " ( المدارج : 1/482 ). وقال شيخ الإسلام – رحمه الله - : " وَاعْلَمْ أَنَّ فَقْرَ الْعَبْدِ إلَى اللَّهِ أَنْ يَعْبُدَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، لَيْسَ لَهُ نَظِيرٌ فَيُقَاسُ بِهِ ؛ لَكِنْ يُشْبِهُ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ حَاجَةَ الْجَسَدِ إلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ؛ وَبَيْنَهُمَا فُرُوقٌ كَثِيرَةٌ . فَإِنَّ حَقِيقَةَ الْعَبْدِ قَلْبُهُ وَرُوحُهُ ، وَهِيَ لَا صَلَاحَ لَهَا إلَّا بِإِلَهِهَا اللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ : فَلَا تَطْمَئِنُّ فِي الدُّنْيَا إلَّا بِذِكْرِهِ : وَهِيَ كَادِحَةٌ إلَيْهِ كَدْحًا فَمُلَاقِيَتُهُ وَلَا بُدَّ لَهَا مِنْ لِقَائِهِ ، وَلَا صَلَاحَ لَهَا إلَّا بِلِقَائِهِ . وَلَوْ حَصَلَ لِلْعَبْدِ لَذَّاتٌ أَوْ سُرُورٌ بِغَيْرِ اللَّهِ فَلَا يَدُومُ ذَلِكَ ، بَلْ يَنْتَقِلُ مِنْ نَوْعٍ إلَى نَوْعٍ ، وَمِنْ شَخْصٍ إلَى شَخْصٍ ، وَيَتَنَعَّمُ بِهَذَا فِي وَقْتٍ وَفِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ ، وَتَارَةً أُخْرَى يَكُونُ ذَلِكَ الَّذِي يَتَنَعَّمُ بِهِ وَالْتَذَّ غَيْرَ مُنْعِمٍ لَهُ وَلَا مُلْتَذٍّ لَهُ ، بَلْ قَدْ يُؤْذِيهِ اتِّصَالُهُ بِهِ وَوُجُودُهُ عِنْدَهُ ، وَيَضُرُّهُ ذَلِكَ . وَأَمَّا إلَهُهُ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ فِي كُلِّ حَالٍ وَكُلِّ وَقْتٍ ، وَأَيْنَمَا كَانَ فَهُوَ مَعَهُ ؛ وَلِهَذَا قَالَ إمَامُنَا ( إبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ }.وَكَانَ أَعْظَمُ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ : { اللَّهُ لَا إلَهَ إلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ } . وَقَدْ بَسَطْتُ الْكَلَامَ فِي مَعْنَى الْقَيُّومِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ ، وَبَيَّنَّا أَنَّهُ الدَّائِمُ الْبَاقِي الَّذِي لَا يَزُولُ وَلَا يَعْدَمُ ، وَلَا يَفْنَى بِوَجْهِ مِنْ الْوُجُوهِ " (مجموع الفتاوى : 1/24 – 25) . الفائدة الثانية / أثر الحي القيوم في دوام الحسنة . قال شيخ الإسلام – رحمه الله - :" بِخِلَافِ الْحَسَنَةِ . فَإِنَّهَا مِنْ إنْعَامِ الْحَيِّ الْقَيُّومِ الْبَاقِي الْأَوَّلِ الْآخِرِ . فَسَبَبُهَا دَائِمٌ فَيَدُومُ ( أي: ثوابها ) بِدَوَامِهِ " ( مجموع الفتاوى : 14/345) . الفائدة الثالثة / الكمال في الإثبات ، وهو الأصل في صفات الله . قال شيخ الإسلام – رحمه الله - : " النَّفْيَ الْمَحْضَ عَدَمٌ مَحْضٌ ؛ وَالْعَدَمُ الْمَحْضُ لَيْسَ بِشَيْءِ وَمَا لَيْسَ بِشَيْءِ فَهُوَ كَمَا قِيلَ : لَيْسَ بِشَيْءِ ؛ فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ مَدْحًا أَوْ كَمَالًا " (مجموع الفتاوى : 3/35). وقال – أيضاً - : " وذلك لأن صفات الكمال أمور وجودية ، أو أمور سلبية مستلزمة لأمور وجودية ، كقوله – تعالى - : { اللَّهُ لَا إلَهَ إلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تأخذه سنة ولا نوم } فنفي السنة والنوم استلزم كمال صفة الحياة والقيومية " (الاصفهانية: ص/ 135) . ومما يدل على ذلك أن كل نفي جاء في آية الكرسي سبق بصفة إثبات ، لأن الإثبات هو الأصل وهو صفة الكمال ، فأول سلب ورد في هذه الآية سلب الألوهية عن غير الله - عز وجل - ، فافتتحت الآية بقوله – تعالى - : { الله } ، وفيها إثبات الإلهية له، ثم أتى بعد ذلك بقوله: { لا إله إلا هو } . ثم بعد ذلك قال: { الحي القيوم } ، ثم بعد ذلك قال : { لا تأخذه سنة ولا نوم } . ثم قال : { له ما في السموات وما في الأرض }، وقال بعدها : { من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه } إلخ الآية . فكل نفي سبق بإثبات ، وهذا يدل على أن الأصل في صفات الله - عز وجل - الإثبات، وأن النفي تابع ، والمقصود منه إثبات الكمال في الصفات (ينظر : شرح الواسطية للمصلح ) . المسألة السابعة : قوله : " وَلِهَذَا كَانَ مَنْ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ فِيْ لَيْلَةٍ لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ حَافِظْ وَلا يَقْرَبُهُ شَيْطَانْ حَتَى يُصْبِحْ " . يشير إلى ما جاء عن أَبي هريرة - رضي الله عنه - ، قَالَ : وَكَّلَنِي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَام، فَأخَذْتُهُ فقُلتُ: لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ، قَالَ : إنِّي مُحْتَاجٌ ، وَعَليَّ عِيَالٌ ، وَبِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ ، فَخَلَّيْتُ عَنْهُ ، فَأصْبَحْتُ ، فَقَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " يَا أَبَا هُريرة ، مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ البَارِحَةَ ؟ " قُلْتُ : يَا رسول الله ، شَكَا حَاجَةً وَعِيَالاً ، فَرحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبيلَهُ . فَقَالَ : " أمَا إنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ " فَعَرَفْتُ أنَّهُ سَيَعُودُ ، لقولِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَرَصَدْتُهُ ، فَجاء يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ ، فَقُلتُ : لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قَالَ : دَعْنِي فَإنِّي مُحْتَاجٌ ، وَعَلَيَّ عِيَالٌ لاَ أعُودُ ، فَرحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبيلَهُ ، فَأصْبَحْتُ فَقَالَ لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " يَا أَبَا هُريرة ، مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ البَارِحَةَ ؟ " قُلْتُ : يَا رسول الله ، شَكَا حَاجَةً وَعِيَالاً ، فَرحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبيلَهُ . فَقَالَ : " إنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ " فَرَصَدْتُهُ الثَّالثَة ، فَجاء يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ فَأخَذْتُهُ ، فَقُلتُ : لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ، وهذا آخِرُ ثلاثِ مَرَّاتٍ أنَّكَ تَزْعُمُ أنَّكَ لاَ تَعُودُ ! فَقَالَ : دَعْنِي فَإنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللهُ بِهَا ، قُلْتُ : مَا هُنَّ ؟ قَالَ : إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الكُرْسِيِّ ، فَإنَّهُ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ الله حَافِظٌ ، وَلاَ يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ ، فَأصْبَحْتُ ، فَقَالَ لي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : " مَا فَعَلَ أسِيرُكَ البَارِحَةَ ؟ " قُلْتُ : يَا رسول الله ، زَعَمَ أنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللهُ بِهَا ، فَخَلَّيْتُ سَبيلَهُ ، قَالَ : " مَا هِيَ ؟ " قُلْتُ : قَالَ لي : إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَة الكُرْسِيِّ مِنْ أوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ الآية : { اللهُ لاَ إلَهَ إِلاَّ هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ } وقال لِي : لاَ يَزَالُ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ ، وَلَنْ يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ . فَقَالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - : " أمَا إنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ ، تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلاَثٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ " قُلْتُ : لاَ . قَالَ : " ذَاكَ شَيْطَانٌ " ( رواه البخاري ) . ( تم بحمد الله ) . |
|
#64
|
|||
|
|||
|
بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة لسؤال أخي العزيز عمربن محمدالبومرداسي وبعد توضيح المشرف أبي الحارث ، بأنه سؤال عن : " الحكمة من انفراد السنة بوصف لله تعالى عن القرآن " . أقول : الظاهر أن الحكمة هي بيان أن السنة ( عدل ) القرآن ، أي : مثله في تشريع الأحكام ، والإخبار عن المغيبات ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه " قال ابن باز - رحمه الله - : " فالسنة وحي ثان أوحاه الله إليه لإكمال الرسالة وتمام البلاغ " (25/ 59) من مجموع فتاواه . وهو من جنس الموصوف الذي له أوصاف متعددة يثبت بعضها بالقرآن وبعضها بالسنة ونحن نؤمن بالجميع ، كأوصاف الجنة والنار . ولهذا قال أبو بكر بن قاسم : " ونؤمن بكل ما بلغنا بما قد أخبر به من قول ، أو فعل ، أو صفة ، أو مغيب " ( أعتقاد أهل السنة ص/45). فالكتاب والسنة صنوان في باب الخبر عن الله - تعالى - ، " كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : آمَنْت بِاَللَّهِ وَبِمَا جَاءَ عَنْ اللَّهِ عَلَى مُرَادِ اللَّهِ وَآمَنْت بِرَسُولِ اللَّهِ وَمَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى مُرَادِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ( مجموع الفتاوى : 6/354) . والله أعلم . |
|
#65
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
جزى الله الأستاذ العتيبيَّ خيرا ..
هذا هو ما حاولتُ لفت النظر إليه ،ذلك أن أهل البدع (يحاولون جعل ذلك مغايرا) ،وبخاصة (ما جاء عن طريق خبر الآحاد) ،فكأنهم يقللون من قيمة السنة ،لذلك قال أهل السنة والأثر: نؤمن بما وصف الله به نفسه ووصفه به نبيّه صلى الله عليه وسلّم ..
__________________
قال ابن تيمية:"و أما قول القائل ؛إنه يجب على [العامة] تقليد فلان أو فلان'فهذا لا يقوله [مسلم]#الفتاوى22_/249 قال شيخ الإسلام في أمراض القلوب وشفاؤها (ص: 21) : (وَالْمَقْصُود أَن الْحَسَد مرض من أمراض النَّفس وَهُوَ مرض غَالب فَلَا يخلص مِنْهُ إِلَّا الْقَلِيل من النَّاس وَلِهَذَا يُقَال مَا خلا جَسَد من حسد لَكِن اللَّئِيم يبديه والكريم يخفيه). |
|
#66
|
|||
|
|||
|
وجزاكما الله مثله وزادكما ربي من فضله وجمعنا بكم في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في مستقر جنته |
|
#67
|
|||
|
|||
|
الحلقة السابعة بسم الله الرحمن الرحيم تنبيه : بدا لي أن أجعل المادة من هذا الموضع من المدارسة : كل آية أو آيات موضوعها واحد في تعليق واحد ، ومن الله التوفيق . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ قال المصنف – رحمه الله - : " وقوله – تعالى -: { وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ } [الفرقان:58] " . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ الشرح : تنبيه : في بعض النسخ قدمت آية [الحديد:3] :{ هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } على آية الفرقان ، وفي هذا نظر من جهتين : الجهة الأولى / النسخة المحققة فيها تقديم آية ( الفرقان ) على آية ( الحديد ) . ينظر : ( مجموع الفتاوى : 3/131) ، و(الواسطية للمصلح ) . الجهة الثانية / أن آية الفرقان مناسبة لآية الكرسي في إثبات صفة الحياة فإتباعها بها أولى . المعنى العام : مقصود المصنف – رحمه الله - : أن الله – تعالى – حي ، فدلت الآية على إثبات أن من اسمائه الحسنى ( الحي ) الدال على صفة الحياة الكاملة التي لا نقص فيها بأي وجه من الوجوه ، فلم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها سنة ولا نوم . وهنا جاء في الآية صفة سلبية وهي : ( نفي الموت ) ، وينفى لسببين : الأول / أن الموت صفة نقص محض لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله – تعالى - ، قال شيخ الإسلام – رحمه الله - : " فَجِنْسُ السِّنَةِ وَالنَّوْمِ وَالْمَوْتِ مُمْتَنِعٌ عَلَيْهِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا " إنَّهُ يَجُوزُ عَلَيْهِ كَمَا يَلِيقُ بِشَأْنِهِ " لِأَنَّ هَذَا الْجِنْسَ يُوجِبُ نَقْصًا فِي كَمَالِهِ " ( مجموع الفتاوى : 16/425 ) . الثاني / أن كمال حياته الكمال المطلق من كل الوجوه يوجب نفي الموت عنه . فالقاعدة : أن الأصل في الكمال هو الإثبات ، وأما النفي فيأتي لدلالته على كمال ضد المنفي ، فالله – تعالى – لا يموت لكمال حياته . فلم يوصف بالحياة لأجل أنه لا يموت . بل هو مستحق للحياة الكاملة المستلزمة نفي الموت عنه ، فينفى عنه الموت لأنه حي ، فهي صفة ذاتية لازمة له . ولا تقل هو حي لأنه لا يموت . بل هو الحي الكامل لذلك لا يموت . والفرق بينهما : أن من جعل الأصل الصفة السلبية ، يقول : هو حي لأنه لا يموت ، فيأتي بصفة الحياة لأجل إثبات عدم الموت . وأما من جعل الأصل الصفات الثبوتية الدالة على الكمال المطلق ، فيقول : هو لا يموت لكمال حياته . قال شيخ الإسلام – رحمه الله - : " لكن قولهم قلنا أنه حي لننفي الموت عنه كلام مستدرك فإن الله موصوف بصفات الكمال الثبوتية كالحياة والعلم والقدرة فيلزم من ثبوتها سلب صفات النقص وهو سبحانه لا يمدح بالصفات السلبية إلا لتضمنها المعاني الثبوتية فإن العدم المحض والسلب الصرف لا مدح فيه ولا كمال إذ كان المعدوم يوصف بالعدم المحض والعدم نفي محض لا كمال فيه إنما الكمال في الوجود " ( الجواب الصحيح : 3/ 208 – 209 ) . إلى أن قال : " والمقصود هنا أنه موصوف بصفات الكمال التي يستحقها بذاته ويمتنع اتصافه بنقائضها وإذا وصف بالسلوب فالمقصود هو إثبات الكمال وهؤلاء قالوا قد وصفناه بالحياة لننفي عنه الموت كما قالوا هو شيء لننفي العدم عنه والحياة صفة كمال يستحقها بذاته ، والموت مناقض لها ، فلم يوصف بالحياة لأجل نفي الموت ، بل وصفه بالحياة يستلزم نفي الموت فينفى عنه الموت ؛ لأنه حي لا يثبت له الحياة لنفي الموت وكذلك لتثبت له أنه شيء موجود وذلك يستلزم نفي العدم عنه لا أن إثبات وجوده لأجل نفي العدم بل نفي العدم عنه لأجل وجوده كما أن نفي الموت عنه لأجل حياته " ( الجواب الصحيح : 3/ 11 – 12) . " والشاهد من الآية الكريمة : أن فيها إثبات الحياة الكاملة لله ـ سبحانه ـ ونفي الموت عنه ، ففيها الجمع بين النفي والإثبات في صفات الله تعالى " ( شرح الواسطية للفوزان ص/ 22 ) . مبحث مهم في التوكل: • قوله : { وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ } . المسألة الأولى / معنى التوكل . التوكل في اللغة : مأخوذ من " وكَلَ الشيء إلى غيره " ( شرح الواسطية لابن عثيمين: 1/185). و " الواو والكاف واللام : أصلٌ صحيحٌ يدلُّ على اعتمادِ غيرِكَ في أمرك " ( معجم المقاييس :6/104 ) . أي أنك تعتمد على غيرك في شؤونك . " والتوكُّل منه ، وهو إظهار العَجْز في الأمر والاعتمادُ على غيرك " ( معجم المقاييس :6/104 ) . وكمال التوكل التفويض ولذلك يفسر به ، فهو اعتماد مع تسليم وتفويض ، ويضاف إليه الأخذ بالأسباب ، وهذا حقيقته الشرعية . فمعناه شرعاً : " صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به – سبحانه - ، وفعل الأسباب الصحيحة " ( شرح الواسطية ابن عثيمين : 1/ 185 ) . فالمعنى الشرعي له ثلاث مراتب : • المرتبة الأولى / الاعتماد على الله . • المرتبة الثانية / الثقة به . • المرتبة الثالثة / الأخذ بالأسباب الصحيحة . قال ابن القيم – رحمه الله - : " والاستعانة تجمع أصلين الثقة بالله والاعتماد عليه فإن العبد قد يثق بالواحد من الناس ولا يعتمد عليه في أموره مع ثقته به لاستغنائه عنه . وقد يعتمد عليه مع عدم ثقته به لحاجته إليه ولعدم من يقوم مقامه فيحتاج إلى اعتماده عليه مع أنه غير واثق به والتوكل معنى يلتئم من أصلين من الثقة والاعتماد وهو حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين (مدارج السالكين : 1/75) . لطيفة : قال ابن عثيمين – رحمه الله - : " والاستعانة بالله تعالى هي ثمرة التوكل " ( شرح الواسطية : 1/186 ) . وقال شيخ الإسلام – رحمه الله - : " وَمِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ : مَا قَالَهُ طَائِفَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ . قَالُوا : الِالْتِفَاتُ إلَى الْأَسْبَابِ شِرْكٌ فِي التَّوْحِيدِ . وَمَحْوُ الْأَسْبَابِ أَنْ تَكُونَ أَسْبَابًا نَقْصٌ فِي الْعَقْلِ وَالْإِعْرَاضُ عَنْ الْأَسْبَابِ بِالْكُلِّيَّةِ قَدْحٌ فِي الشَّرْعِ وَإِنَّمَا التَّوَكُّلُ وَالرَّجَاءُ مَعْنًى يَتَأَلَّفُ مِنْ مُوجِبِ التَّوْحِيدِ وَالْعَقْلِ وَالشَّرْعِ " ( مجموع الفتاوى : 8/196 ) . حقيقة معنى التوكل قال ابن القيم – رحمه الله - : " فإن قلت فما معنى التوكل والاستعانة ؟ قلت هو حال للقلب ينشأ عن معرفته بالله والإيمان بتفرده بالخلق والتدبير والضر والنفع والعطاء والمنع وأنه ما شاء كان وإن لم يشأ الناس وما لم يشأ لم يكن وإن شاءه الناس فيوجب له هذا اعتمادا عليه وتفويضا إليه وطمأنينة به وثقة به ويقينا بكفايته لما توكل عليه فيه وأنه ملي به ولا يكون إلا بمشيئته شاءه الناس أم أبوه فتشبه حالته حالة الطفل مع أبويه فيما ينويه من رغبة ورهبة هما مليان بهما فانظر في تجرد قلبه عن الإلتفات إلى غير أبويه وحبس همه على إنزال ما ينويه بهما فهذه حال المتوكل ومن كان هكذا مع الله فالله كافيه ولا بد قال الله - تعالى - : { وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ } [الطلاق:3] أي كافيه والحسب الكافي فإن كان مع هذا من أهل التقوى كانت له العاقبة الحميدة " (مدارج السالكين : 1/ 82 ) . تنبيه : من توكل على غير الله لا يخلو من ثلاثة أقسام : أولا : أن يتوكل توكل اعتماد وتعبد ، فهذا شرك أكبر ، كأن يعتقد بأن هذا المتوكل عليه هو الذي يجلب له كل خير ويدفع عنه كل شر ، فيفوض أمره إليه تفويضًا كاملا في جلب المنافع ودفع المضار ، مع اقتران ذلك بالخشية والرجاء ، ولا فرق بين أن يكون المتوكل عليه حيًا أو ميتًا ، لأن هذا التفويض لا يصح إلا لله . ثانيًا : أن يتوكل على غير الله بشيء من الاعتماد لكن فيه إيمان بأنه سبب وأن الأمر إلى الله ، كتوكل كثير من الناس على الملوك والأمراء في تحصيل معاشهم ، فهذا نوع من الشرك الأصغر . ثالثًا : أن يتوكل على شخص على أنه نائب عنه ، وأن هذا المتوكل فوقه ، كتوكل الإنسان على الوكيل في بيع وشراء ونحوهما مما تدخله النيابة ، فهذا جائز ، ولا ينافي التوكل على الله ، وقد وكل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أصحابه في البيع والشراء ونحوهما " ( شرح الواسطية : 1/ 186 ) . الفوائد المسلكية : الفائدة الأولى / قوله – تعالى - : { وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ } . قال الفوزان – حفظه الله - : " وخص صفة الحياة إشارة إلى أن الحي هو الذي يوثق به في تحصيل المصالح . ولا حياة على الدوام إلا به سبحانه وأما الأحياء المنقطعة حياتهم فإنهم إذا ماتوا ضاع من يتوكل عليهم " (شرح الواسطية الفوزان : ص/23) . " وَلِهَذَا قَالَ الْخَلِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ } فَإِنَّهَا فِي حَالِ أُفُولِهَا قَدْ انْقَطَعَ أَثَرُهَا عَنَّا بِالْكُلِّيَّةِ فَلَمْ تَبْقَ شُبْهَةٌ يَسْتَنِدُ إلَيْهَا الْمُتَعَلِّقُ بِهَا وَالرَّبُّ الَّذِي يُدْعَى وَيُسْأَلُ وَيُرْجَى وَيُتَوَكَّلُ عَلَيْهِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ قَيُّومًا يُقَيِّمُ الْعَبْدَ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ وَالْأَحْوَالِ كَمَا قَالَ : { وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ } وَقَالَ : { اللَّهُ لَا إلَهَ إلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ }" ( مجموع الفتاوى : 8/173 ) . الفائدة الثانية / قال ابن القيم – رحمه الله - : " فأفضل التوكل : التوكل في الواجب أعني واجب الحق وواجب الخلق وواجب النفس . وأوسعه وأنفعه : التوكل في التأثير في الخارج فى مصلحة دينية أو في دفع مفسدة دينية وهو توكل الأنبياء في إقامة دين الله ودفع فساد المفسدين في الأرض وهذا توكل ورثتهم . ثم الناس بعد في التوكل على حسب هممهم ومقاصدهم فمن متوكل على الله في حصول الملك ومن متوكل في حصول رغيف " (مدارج السالكين : 2/ 113 – 114 ) . الفائدة الثالثة / وفي تمام الآية : { وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ } الجمع بين التوكل والعبادة لطيفة مهمة في أن الكفاية على قدر القيام بالعبودية ، كما قال – تعالى - : { وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ } [الطلاق:3] ، مع قوله – تعالى - : {أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ}[الزمر:36] . فالذي يتوكل على الله فالله كافيه على قدر قيامه بالعبودية ، كما قال ابن القيم – رحمه الله - : " فالكفاية التامة مع العبودية التامة والناقصة فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه " (الوابل الصيب ص/ 11 ) . الفائدة الرابعة / قال صالح آل الشيخ – حفظه الله - : " هنا مسألة يكثر السؤال عنها في التوكل وهي قول القائل (توكلت على الله ثم على فلان) . من أهل العلم من أجازها . ومنهم وهم الأكثر من منعها ، والمانعون على الأصل من أن التوكل فعل قلبي وأنه لا يسوغ التوكل على أحد إلا على الله جل وعلا قال سبحانه {فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ} ، {عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا} اختصاص ذلك بالله . أما المخلوق فيقال (وكلت فلانا) ونحو ذلك (اعتمدت على فلان) أما التوكل بخصوصه فليس للمخلوق منه نصيب لأن الذي يفعل الأمور وينفذها على ما يرجو العبد هو الله جل وعلا والمخلوق قد يكون سببا ، وإذ كان سببا فإنه لا يصح أن يفوض الأمر إليه. قال طائفة من أهل العلم لا بأس أن يقال (توكلت على الله ثم على فلان) باعتبار أن العامي إذا أطلقها لا يعني بها التوكل الذي هو عبادة القلب ، وإنما يعني به ما تكون فيه الوكالة والاعتماد ظاهرا دون عمل القلب " ( شرح الواسطية : 1/ 138 ) . تمت بحمد الله |
|
#68
|
|||
|
|||
|
الحلقة الثامنة بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف : " وقوله – سبحانه -: { هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } [الحديد:3] " . ــــــــــــــــــــــــ الشرح : قولُهُ : [ وقولِهِ ] بالكسر ، معطوفًا على سورة الإخلاص من قوله " وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص " . قولُهُ : [ هُوَ ] أي : الله – تعالى – وليس اسماً له كما زعمه بعضهم ؛ لسببين : 1) أنه ضمير وهو كناية لا يختص بواحد دون غيره ؛ " فَإِنَّ مَنْ قَالَ: يَا هُوَ يَا هُوَ، أَوْ: هُوَ هُوَ. وَنَحْوَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ الضَّمِيرُ عَائِدًا إلَّا إلَى مَا يُصَوِّرُهُ قَلْبُهُ، وَالْقَلْبُ قَدْ يَهْتَدِي وَقَدْ يَضِلُّ " ( الفتاوى الكبرى : 5/212 ) . " وَرُبَّمَا اقْتَصَرَ بَعْضُهُمْ عَلَى هُوَ هُوَ . أَوْ عَلَى قَوْلِهِ : لَا هُوَ إلَّا هُوَ لِأَنَّ هَذَا الذِّكْرَ الْمُبْتَدَعَ الَّذِي هُوَ لَا يُفِيدُ بِنَفْسِهِ إلَّا أَنَّهُ مُطْلَقًا لَيْسَ فِيهِ بِنَفْسِهِ ذِكْرٌ لِلَّهِ إلَّا بِقَصْدِ الْمُتَكَلِّمِ . فَقَدْ يَنْضَمُّ إلَى ذَلِكَ اعْتِقَادُ صَاحِبِهِ أَنَّهُ لَا وُجُودَ إلَّا هُوَ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ بَعْضُهُمْ وَيَقُولُ : لَا هُوَ إلَّا هُوَ أَوْ لَا مَوْجُودَ إلَّا هُوَ وَهَذَا عِنْدَ الِاتِّحَادِيَّةِ أَجْوَدُ مِنْ قَوْلِ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ لِأَنَّهُ مُصَرِّحٌ بِحَقِيقَةِ مَذْهَبِهِمْ الْفِرْعَوْنِيِّ القرمطي حَتَّى يَقُولَ بَعْضُهُمْ . لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ذِكْرُ الْعَابِدِينَ وَاَللَّهُ اللَّهُ ذِكْرُ الْعَارِفِينَ وَهُوَ ذِكْرُ الْمُحَقِّقِينَ وَيَجْعَلُ ذِكْرَهُ يَا مَنْ لَا هُوَ إلَّا هُوَ " ( مجموع الفتاوى : 2/63 – 64 ) . 2) أنه جامد فلا يتضمن معنى ، وأسماء الله - تعالى - حسنى كما قال سبحانه: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} [الأعراف: 180]. يعني البالغة في الحسن غايته لِمَا اشتملت عليه من المعاني ، ولفظ ( هو ) ليس فيه معنى البتة لأنه جامد . ومقصود المصنف – رحمه الله – من الآية : أن دلالة النصوص الشرعية على إثبات الأسماء الحسنى وما تضمنته من الأوصاف تكون على جهة التفصيل لأنها أدل على كماله – تعالى - ، وأن الواجب إثبات ذلك لأنه مراد الله – تعالى – من كلامه . وقد دلت الآية على أربعة أسماء وهي : ( الأول والآخر والظاهر والباطن ) ، وست صفات وهي : ( الأولية ، والآخرية ، والظاهرية ، والباطنية ، والإحاطة ، والعلم ) . فـ" استفدنا من مجموع الأسماء : إحاطة الله تعالى بكل شيء زمنًا ومكانًا ، لأنه قد يحصل من اجتماع الأوصاف زيادة صفة " ( مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين : 8/149 ) . قال العلامة الفوزان – حفظه الله - : " والشاهد من الآية الكريمة : إثبات هذه الأسماء الكريمة لله المقتضية لإحاطته بكل شيء زمانًا ومكانًا واطلاعًا وتقديرًا وتدبيرًا . تعالى وتقدس علوًا كبيرًا " ( شرح الواسطية : ص/22 ). المعنى العام : اعلم – وفقك الله – أن هذه الأسماء الأربعة والصفات الست دلت على : • كمال عظمة الله – تعالى - . • وكمال إحاطته الزمانية والمكانية من كل وجه . • وشمول علمه لكل شيء . قال السعدي – رحمه الله - : " وهذا يدل على كمال عظمته وأنه لا نهاية لها ، وبيان إحاطته من كل وجه . ففي الأول والآخر إحاطته الزمانية ، وفي الظاهر والباطن إحاطته المكانية. ثم صرح بإحاطة علمه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة ، ومن العالم العلوي والسفلي ، ومن الظواهر والبواطن والواجبات والجائزات والمستحيلات ، فلا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء " (التنبيهات اللطيفة : ص/ 26 ) . قال العلامة الهراس – رحمه الله - : " فَالْآيَةُ كُلُّهَا فِي شَأْنِ إِحَاطَةِ الرَّبِّ سُبْحَانَهُ بِجَمِيعِ خَلْقِهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، وَأَنَّ الْعَوَالِمَ كُلَّهَا فِي قَبْضَةِ يَدِهِ كَخَرْدَلَةٍ فِي يَدِ الْعَبْدِ ، لَا يَفُوتُهُ مِنْهَا شَيْءٌ " ( شرح الواسطية : ص/79 ). وهذه الأسماء الأربعة اثنان للأزلية والأبدية ، واثنان للإحاطة ، إحاطة العلو والظهور والبطون وقد فسرها النبي – صلى الله عليه وسلم – تفسيراً مختصراً جامعاً يوضح حقيقة المراد منها ، فقال مسلم في صحيحه : حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، قَالَ : كَانَ أَبُو صَالِحٍ يَأْمُرُنَا ، إِذَا أَرَادَ أَحَدُنَا أَنْ يَنَامَ ، أَنْ يَضْطَجِعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ، ثُمَّ يَقُولُ : «اللهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى ، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ ، اللهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ ، وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ » وَكَانَ يَرْوِي ذَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( رواه مسلم برقم : 2713) . " ومن المعلوم أننا لا نرجع إلى قول أحد كائناً من كان من البشر بعد تفسير النبي صلى الله عليه وسلم " ( قاله ابن عثيمين – رحمه الله - في لقاء الباب المفتوح ) . إلا أن يكون على سبيل التوضيح والشرح لتفسير النبي – صلى الله عليه وسلم - ، وأما إذا كان مخالفاً للتفسير النبوي فهو مردود لأنه من الآراء التي تكون في مقابلة النصوص ، ولا يعول عليها كما سنبين بعضاً منها – إن شاء الله - في مبحث الفوائد المتعلقة بالآية . الأسماء الواردة في الآية : 1. [ الْأَوَّلُ ] : في اللغة : " (أول) الهمزة والواو واللام أصلان: ابتداء الأمر وانتهاؤه. أما الأوَّل فالأوّل، وهو مبتدأُ الشيء " ( معجم مقاييس اللغة : 1/160 ) . وفي الشرع : هو الذي ليس قبله شيء . وهذا التفسير النبوي أكمل في بيان المعنى المقصود ؛ لأن المراد بالأولية الأولية المطلقة . قال ابن عثيمين – رحمه الله - : " وهنا فسر الإثبات بالنفي فجعل هذه الصفة الثبوتية صفة سلبية ، وقد ذكرنا فيما سبق أن الصفات الثبوتية أكمل وأكثر ، فلماذا؟ فنقول : فسرها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذلك ، لتوكيد الأولية ، يعني أنها مطلقة ، أولية ليست أولية إضافية ، فيقال : هذا أول باعتبار ما بعده وفيه شيء آخر قبله ، فصار تفسيرها بأمر سلبي أدل على العموم باعتبار التقدم الزمني " ( مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين : 8/147 ) . ولذلك جاءت عبارات العلماء في توضيح الأولية بأنها المطلقة ، فقال الطحاوي – رحمه الله : " قديمٌ بلا ابتداء , دائمٌ بلا انتهاء " ، وأتقن منها عبارة ابن أبي زيد القيرواني : " ليس لأَوَّلِيَّتِهِ ابتداءٌ , ولا لآخِريّتِه انقضَاءٌ " . وعلى هذا تكون " (أوليته) - سبحانه - بمعنى (الأزلية) يعني أنه - جل وعلا - لم يزل . وكلمة أزلية هذه منحوتة من الكلمتين (لم) (يزل) فقيل فيها أزلية وتفسيرها (لم يزل) " ( شرح الواسطية صالح آل الشيخ :ص/130 ) . ومما يدل على الأولية المطلقة قوله :{وَلَمْ يُولَدْ} لأنه لو وُلِدَ لكان مسبوقًا بوالدٍ فلم يكن الأول ، وهو - جل وعلا - الأول الذي ليس قبله شيء . وقد دل على اسم الله ( الأول ) الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة . فقد ورد الاسم العلم المتضمن لصفة الأولية في موضع واحد من القرآن ، وفي عدد من الأحاديث كما مر معنا ويأتي – إن شاء الله - . واعلم أنه " لا توجد طائفة من الطوائف تنكر أن الله - عز وجل - هو الأول ، لكن يوجد من الطوائف من يجعل مع الله - سبحانه وتعالى - من مخلوقاته قريناً له في الأولية ، فيشرك في هذه الصفة ، وهم الفلاسفة - قبحهم الله - الذين يقولون بقدم العالم ، فإنهم يقولون : إن الإله علة موجبة تقتضي معلوله ، فلما كان الإله لا أول له ولا بداية ، وهو علة موجبة تقتضي معلولها ، كان معلولها - أيضاً - لا بداية له ، فاعتقدوا أن هذا الخلق قديم أزلي أول ، كما أن الله - عز وجل - هو الأول ، ويقولون : إنها نتجت عن الله - عز وجل - وصدرت عنه صدور المعلول عن علته بدون إرادة ، ولهذا كفرهم السلف - رضوان الله عليهم - " ( شرح الواسطية لعبد الرحيم السلمي ) . ومن دلالة العقل ما ذكره شيخ الإسلام – رحمه الله - بقوله : " أن يقال الباري والعالم موجودان وكل موجودين فإما أن يكون وجودهما معا وهما متقارنان وإما أن يكون أحدهما قبل الآخر وليس مع العالم مقارنا له فوجب أن يكون متقدما عليه وهذا حق . . . وهذه دلت على أن الباري سابق للعالم لم يقارنه العالم ، وكذلك قال - سبحانه - : {هو الأول والآخر والظاهر والباطن } " ( بيان تلبيس الجهمية : 1/111 ) . وقال ابن أبي العز – رحمه الله – عن الأول والآخر - : " وَالْعِلْمُ بِثُبُوتِ هَذَيْنِ الْوَصْفَيْنِ مُسْتَقِرٌّ فِي الْفِطْرَة ، فَإِنَّ الْمَوْجُودَاتِ لَا بُدَّ أَنْ تَنْتَهِيَ إِلَى وَاجِبِ الْوُجُودِ لِذَاتِهِ ، قَطْعًا لِلتَّسَلْسُلِ ، فَأنت تُشَاهِدُ حُدُوثَ الْحَيَوَانِ وَالنَّبَاتِ وَالْمَعَادِنِ وَحَوَادِثِ الْجَوِّ كَالسَّحَابِ وَالْمَطَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَهَذِهِ الْحَوَادِثُ وَغَيْرُهَا لَيْسَتْ مُمْتَنِعَةً ، فَإِنَّ الْمُمْتَنِعَ لَا يُوجَدُ ، وَلَا وَاجِبَةَ الْوُجُودِ بِنَفْسِهَا ، فَإِنَّ وَاجِبَ الْوُجُودِ بِنَفْسِهِ لَا يَقْبَلُ الْعَدَمَ ، وَهَذِهِ كَانَتْ مَعْدُومَةً ثُمَّ وُجِدَتْ ، فَعَدَمُهَا يَنْفِي وُجُودَهَا ، وَوُجُودُهَا يَنْفِي امْتِنَاعَهَا ، وَمَا كَانَ قَابِلًا لِلْوُجُودِ وَالْعَدَمِ لَمْ يَكُنْ وُجُودُهُ بِنَفْسِهِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : { أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ } . يَقُولُ سُبْحَانَهُ : أَحَدَثُوا مِنْ غَيْرِ مُحْدِثٍ أَمْ هُمْ أَحْدَثُوا أَنْفُسَهُمْ ؟ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الشَّيْءَ الْمُحْدَثَ لَا يُوجِدُ نَفْسَهُ ، فَالْمُمْكِنُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ وُجُودٌ وَلَا عَدَمٌ لَا يَكُونُ مَوْجُودًا بِنَفْسِهِ ، بَلْ إِنْ حَصَلَ مَا يُوجِدُهُ ، وَإِلَّا كَانَ مَعْدُومًا ، وَكُلُّ مَا أَمْكَنَ وُجُودُهُ بَدَلًا عَنْ عَدَمِهِ ، وَعَدَمُهُ بَدَلًا عَنْ وُجُودِهِ ، فَلَيْسَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ وُجُودٌ وَلَا عَدَمٌ لَازِمٌ لَهُ " ( شرح الطحاوية :ص/148 – 149 ) . وفي اسم الله – تعالى – ( الأول ) مسائل : المسألة الأولى / أن الأولية حقيقية . قال شيخ الإسلام – رحمه الله - : " أن التقدم على الشيء قد يقال إنه بمجرد الرتبة كما يكون بالمكان مثل تقدم العالم على الجاهل وتقدم الإمام على المأموم فتقدم الله على العالم ليس بمجرد ذلك بل هو قبله حقيقة " ( بيان تلبيس الجهمية : 1/111 ) . المسألة الثانية / أن أولية الله – تعالى - تشمل الذات والأسماء والصفات والأفعال . قال الطحاوي – رحمه الله – في ( عقيدته :ص/17 ) : " مَا زَالَ بِصِفَاتِهِ قَدِيمًا قَبْلَ خَلْقِهِ، لَمْ يَزْدَدْ بِكَوْنِهِمْ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ قَبْلَهُمْ مِنْ صِفَتِهِ، وَكَمَا كَانَ بِصِفَاتِهِ أَزَلِيًّا كَذَلِكَ لَا يَزَالُ عَلَيْهَا أَبَدِيًّا " . فهو " سبحانه (أول) في ذاته فليس قبل ذاته شيء ، وهو (أول) جل وعلا بصفاته وبأسمائه جل وعلا وبأفعاله ، فإن أسماء الله تبارك وتعالى ، وإن صفات الله جل وعلا لم يكتسبها جل وعلا اكتسابا بعد حصول الخلق . كما هو الحال في المخلوقين ، فإن الصفة أو الاسم في المخلوق إنما تكون بعد اكتسابه للصفة ، فيقال فلان كاتب بعد أن حصلت منه الكتابة ، وفلان قادر أو قدير بمعنى أنه حصلت منه هذه القدرة يعني في أجناسها وهكذا ، فلان صانع صنع الشيء بمعنى حصل منه ذلك . وقد يطلق على المخلوق الصفة قبل فعله لها بمعنى كونه قابلا لها ، كما يقال في الإنسان حين ولادته إنه ناطق بمعنى أنه يقبل ذلك . يعني كما أن ذاته - جل وعلا - لها صفة (الأولية) فكذلك أسماء الله - جل وعلا - وكذلك صفاته وكذلك أفعاله " ( بتصرف يسير من شرح الواسطية صالح آل الشيخ :ص/130 ) . ( يتبع – إن شاء الله - ) . |
|
#69
|
|||
|
|||
|
بوركت أبا الحارث على الفائدة النافعة وجزاك الله خيرا وسيأتي في هذا القسم من الحلقة التدليل على ما أشرت إليه سلمك الله . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القسم الثاني من الحلقة الثامنة المسألة الثالثة / " قال الخطابي : الأول هو السابق للأشياء كلها " . قال صالح آل الشيخ – حفظه الله - : " يعبر طائفة من أهل العلم عن أولية الله بسبق الأشياء ، وهذا السبْق وإن كان يجوز من باب الإخبار لكن لا يفهم أنه من باب الصفة أو من باب الإطلاق الوارد ، بل الذي ورد في ذلك إنما هو الأولية " . ( بتصرف من شرح الواسطية :ص/130 ) . المسألة الرابعة / قال الفوزان – حفظه الله - : " ليس من أسماء الله تعالى القديم، وإنما من أسمائه الأول " (المنتقى : 1/27) . وقد تعقب ابن باز – رحمه الله - الطحاوي – رحمه الله في عقيدته المشهورة عند قوله : ( قديم بلا ابتداء ) قال الشيخ : هذا اللفظ لم يرد في أسماء الله الحسنى كما نبه عليه الشارح رحمه الله وغيره وإنما ذكره كثير من علماء الكلام ليثبتوا به وجوده قبل كل شئ ، وأسماء الله توقيفية لا يجوز إثبات شيء منها بالرأي كما نص على ذلك أئمة السلف الصالح ، ولفظ القديم لا يدل على المعنى الذي أراده أصحاب الكلام ؛ لأنه يقصد به في اللغة العربية المتقدم على غيره وإن كان مسبوقاً بالعدم كما في قوله تعالى (حتى عاد كالعرجون القديم ) وإنما يدل على المعنى الحق بالزيادة التي ذكرها المؤلف وهو قوله (قديم بلا ابتداء ) ولكن لاينبغي عده في أسماء الله الحسنى لعدم وروده أو ثبوته من جهة النقل ويغني عنه اسمه سبحانه الأول كقوله (هو الأول والآخر) والله ولي التوفيق " ( التعليقات الأثرية على العقيدة الطحاوية : ص/ 8 ) . وكذلك تعقبه الألباني – رحمه الله – فقال : " اعلم أنه ليس من أسماء الله تعالى : ( القديم ) وإنما هو من استعمال المتكلمين فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن - هو المتقدم على غيره فيقال : هذا قديم للعتيق وهذا جديد للحديث ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره لا فيما لم يسبقه عدم كما قال - تعالى - : { حتى عاد كالعرجون القديم } [ يس : 39 ] . والعرجون القديم : الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني فإذا وجد الجديد قيل للأول قديم وإن كان مسبوقا بغيره كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " ( 1 / 245 ) والشارح في " شرحه " (العقيدة الطحاوية شرح وتعليق : ص/ 5 ) . وقال صالح آل الشيخ – حفظه الله - : " وقال بعض الناس إن الأول هو معنى (القديم) فسموه به ، قالوا إن (الأولية) هي (القِدَم) وهذا غير صحيح ، وذلك أن اسم القديم جاء في القرآن والعربية على نحوين : - الأول : أن يكون مطلقا ، يعني من الزمن ، يعني قِدم على جميع الأشياء . - الثاني : أن يكون قدما نسبيا ، يعني أن يكون قديماً على بعض الأشياء . الأول واضح ، والثاني كقوله تعالى { حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ } قال : { أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الأَقْدَمُونَ } وهذا فيه قِدم نسبي ، ولهذا لما احتمل هذا اللفظ أن يكون فيه المعنيان ـ القِدم المطلق والنسبي - لم يصح أن يقال إن من أسمائه القديم ؛ لأن الاسم الذي يحتمل معنيين كامل وناقص ليس من أسماء الله الحسنى وهذا مثل (الصانع) ومثل (المريد) وأشباه ذلك " ( شرح الواسطية صالح آل الشيخ ) . والخلاصة في هذه المسألة : أننا لا نسمي الله - جل وعلا - بالقديم لسببين : الأول : عدم الدليل . " لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة " ( شرح السفارينية لابن عثيمين :ص/34 ) . و " ؛ لأن أسماء الله تعالى توقيفية ، لا يجوز لأحد أن يثبت شيئًا منها إلا بدليل " (المنتقى : 1/27) . " , وإذا لم يرد في الكتاب ولا في السنة فليس لنا أن نسمي الله به , لأننا إذا سمينا الله بما لم يسم به نفسه فقد قفونا ما ليس لنا به علم . وقلنا على الله ما لا نعلم والله قد حرم ذلك فقال :{ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ } [الأعراف : 33] . وقال - تعالى - : { وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً } [الإسراء : 36] . ( شرح السفارينية لابن عثيمين :ص/34 ) . الثاني : لأنه يحتمل القدم النسبي الذي لا يمنع أن يكون قبله العدم وهو نقص . فهو " لا يدل على الكمال فالقديم يطلق على السابق لغيره سواء كان حادثا أم أزلياً . قال الله - تعالى – :{ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ } [يس : 39] . والعرجون القديم هو عذق النخلة الذي يلتوي إذا تقدم به العهد , ولا شك أنه حادث وليس أزليا , والحدوث نقص ، وأسماء الله - تعالى - كلها حسنى لا تحتمل النقص بأي وجه " ( شرح السفارينية لابن عثيمين :ص/34 ) . المسألة الخامسة / أما الصفات أو الآثار - آثار الصفات - هذا قد يطلق عليها أنها قديمة كما قال النبي - صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ - : " أعوذ بوجهك الكريم وسلطانك القديم " . وهذا أخص من أن يكون اطلاق اسم (القديم) عليه جل وعلا ، بل هو إطلاق على بعض ما له - جل وعلا - . فـ (القديم) ليس نعتا لله جل وعلا ، بل نعت للسطان " ( بتصرف من شرح الواسطية صالح آل الشيخ ) . المسألة السادسة / قال الألباني – رحمه الله - : " أفاد الشيخ ابن مانع هنا فيما نقله عن ابن القيم في " البدائع " أنه يجوز وصفه سبحانه بالقدم بمعنى أنه يخبر عنه بذلك وباب الأخبار أوسع من باب الصفات التوقيفية . قلت : ولعل هذا هو وجه استعمال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الوصف في بعض الأحيان " (العقيدة الطحاوية شرح وتعليق : ص/ 5 ) . وقول ابن القيم المشار إليه هذا : " أن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي وما يطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفا كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع " ( بدائع الفوائد : 1/170 ) . مع أن الأفضل من باب السلامة وقلة النزاع واجتماع القلب وطمأنينته وسكينته أن لا يصار إلى الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة مع وجود ما يغني عنها من الثابت بالنص . فإن الألفاظ الشرعية من خاصيتها أنها محكمة فلا تتسرب الشبه إلى القلب من خلالها بل مهما استقرت في القلب زاد إيمانه ولم تجد الوساوس والشبه من خلالها منفذا إلى قلب قد امتلأ بها ؛ ولذلك كانت هي المرجع عند تثوير المتشابهات للشبهات في القلب . " وفي مسائل جرت لأحمد وإسحاق : إن الله - سبحانه - وصف نفسه في كتابه بصفات استغنى الخلق أن يصفوه بغيرها " ( الصواعق المرسلة : 4/1302 ) . المسألة السابعة / مسألة تسلسل الحوادث في الأزل . اعلم - وفقك الله إلى هداه – أن هذه المسألة من فضول العلم وليست من أصوله وإنما يلجأ العبد إلى الخوض فيها عند رده على أهل البدع وما لم يحتج إليها فهو في غنية عنها . " ونتوقف عن تسلسل الحوادث في الماضي ، ونقول الأمر غيب ، ولم يخبرنا الله تعالى بشيء من ذلك ، وليس لنا التدخل في هذه الأمور ؛ لأنها من الأمور التي لا يضر جهلها ولا يفيد علمها ، وقد توقع في شيء من الحيرة ومن الاضطراب ، والمسلم عليه أن يقتصر على ما فيه فائدة له في العقيدة ، وأن يعتقد ما ينفعه وما يكون دافعاً له إلى معرفة ربه بأسمائه وبصفاته ، وإلى التقرب إلى الله تعالى بموجب تلك الأسماء " ( شرح الطحاوية لابن جبرين : 1/210 شاملة ) . " قال البخاري في كتاب خلق أفعال العباد قال ضمرة بن ربيعة عن صدقة عن سليمان سمعته يقول لو سئلت أين الله لقلت في السماء ولو سئلت أين كان العرش قبل السماء لقلت على الماء ولو سئلت أين كان قبل الماء لقلت لا أدري . قال البخاري : " وذلك لقوله – تعالى - : {ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء} يعني: إلا بما بين " ( خلق أفعال العباد :ص/ 37). (اجتماع الجيوش الإسلامية :ص/169 ) . ( بيان تلبيس الجهمية : 2/44) . واعلم أن " المنكر هو القول بامتناع تسلسل الحوادث في الماضي، لكن هل هو واقع ـ أي: أن المخلوقات لم تزل فعلاً ـ أو يمكن دوامها وتسلسلها في الماضي لكنه لم يقع؟ الأمر في هذا واسع " ( شرح الطحاوية للبراك : ص/62 ) . وخلاصة ما يجب على المسلم معرفته في هذا الباب الأمور التالية : 1- أن الله تعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء . 2- بطلان قول من قال إن أسماء الله محدثة أحدثها الخلق ، وقول من قال إن صفات الله - عز وجل - اتصف بها بعد خلقه للخلق . " لَيْسَ بَعْدَ خَلْقِ الْخَلْقِ اسْتَفَادَ اسْمَ "الْخَالِقِ"، وَلَا بِإِحْدَاثِ الْبَرِيَّةِ اسْتَفَادَ اسْمَ "الْبَارِي لَهُ " ( الطحاوية :ص/ 17 ) . 3- أن الله تعالى متصف بصفات الكمال أزلاً وأبدًا ، ومنها كونه خالقاً لما يشاء متى شاء ، فعالاً لما يريد ، فلم يأت عليه زمن كان مُعَطلاً عن الخلق أو الكلام ، أو غير ذلك من صفات كماله ، ونعوت جلاله . وأنه سبحانه وتعالى لم يحدث له شيء من الصفات بعد أن لم يكن ، والمقصود صفات الذات ، وأصل صفات الفعل ؛ لأن آحادها متعلقة بالمشيئة فإن شاء فعلها وإن لم يشأ لم يفعلها . 4- أن كل ما سوى الله - تعالى - مخلوق له ، مربوب له ، كائن بعد أن لم يكن ، وأن قول من قال إن هذا العالم المنظور قديم أو أزلي باطل كقول الفلاسفة . 5- أن تسلسل الحوادث في الأزل جائز ممكن فنعتقد أن وجودها أمر ممكن متعلق بمشيئة الله وقدرته ، فالله أخبرنا أنه يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء وهو على ما يشاء قدير ، ولا يلزم من ذلك أن الخلق يشارك الله في الأزلية والأولية . ( يتبع – إن شاء الله - ) . |
|
#70
|
|||
|
|||
|
جزاكم الله خيرا متابعون
بالنسبة لتنبيه الأستاذ باسم فهو جيّد في محلّه ..و الاقتصار على الألفاظ الشرعية(=آية ،حديث،قول الصحابة) أسلم و أحكم.
__________________
قال ابن تيمية:"و أما قول القائل ؛إنه يجب على [العامة] تقليد فلان أو فلان'فهذا لا يقوله [مسلم]#الفتاوى22_/249 قال شيخ الإسلام في أمراض القلوب وشفاؤها (ص: 21) : (وَالْمَقْصُود أَن الْحَسَد مرض من أمراض النَّفس وَهُوَ مرض غَالب فَلَا يخلص مِنْهُ إِلَّا الْقَلِيل من النَّاس وَلِهَذَا يُقَال مَا خلا جَسَد من حسد لَكِن اللَّئِيم يبديه والكريم يخفيه). |
 |
|
|
 |
 |