

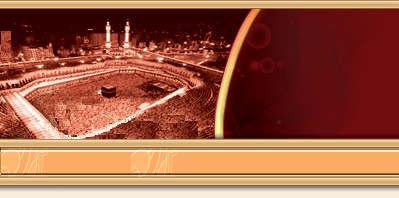
 |
 |
أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
 |
 |
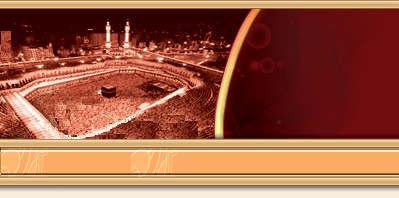 |
|||||
|
|||||||
| 14300 | 139530 |
|
#1
|
||||
|
||||
|
بصائر
فهذه أوشاب من النظر في قوله تعالى : (مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ) ، مَنَّ اللهُ تعالى بها ، ورأيتها مؤتلفة في بابة التربية والتعليم، وهي من صميم العلوم التي جاء القرآن بها، وطبعتها بميسم البصائر، تأسياً بقوله تعالى: (هَٰذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ)، والبصائر جمع بصيرة، وهي مما يخص القلوب وأعمالها ، والنفس وعوائدها، فببصائر القرآن تزكوا النفس ، ويستقيم العمل، ويؤتي العلمُ ثمارَه في الأنفس والآفاق، ولا أزعم التقصي ، فلا أحسب أن هذا في مُكنَة أحد من الخلق ، فلا تزال عجائب القرآن لا تنقضي، وكلماته تمد مبتغي الهدى منه حتى يرث الله الأرض ومن عليها . ففي القرآن علم الأولين والآخرين ، "وما من شيء إلاّ ويمكن إستخراجه منه، لمن فهمَّه الله تعالى". (البرهان 2/116) ، شريطة أن يُعمِل الأداة المنهجية في إستنباط المعنى ، ومعرفة المراد، فكتاب الله لا يَحِلُّ التجرُّؤ عليه لمُجَرَّد الرأي والاجتهاد ، من غير أصل ، فقد قال تعالى: (وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَك بِهِ عِلْم إِنَّ السَّمْع وَالْبَصَر وَالْفُؤَاد كُلّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا)، وقال سبحانه: (وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ)، وهذا لا يعني تضييق الخِناق على النص القرآني ، وحَجْر الاستنباط بما نُقِلَ فقط، بل هو حراسةٌ للنَّص وصيانة للدّلالة ، أن يتسوَّر عليها كلُّ زَنِيم دعيٌّ على القرآن وعلوم أهل الإسلام ، وما أجمل قول الماوردي في (النكت 1/34-35). فتمسك فيه –أي بحديث: (من قال في القرآن برأيه)- بعضُ المتورعة مِمَّنْ قلَّت في العلم طبقتُهُ ، وضعفت فيه خبرتُهُ ، واستعمل هذا الحديث على ظاهره ، وامتنع من أن يستنبط معاني القرآن باجتهاده عند وضوح شواهده، إلّا أن يَرِدَ بها نقلٌ صحيح، ويدلَّ عليه نصٌ صريحٌ ، وهذا عدول عما تعبّد الله تعالى به خلقه في خطابهم بلسان عربي مبين ... ثم قال وجعل لهم سبلاً إلى استنباط أحكامه، كما قال تعالى: (لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ)، ولو كان ما قالوه صحيحاً لكان كلام الله غير مفهوم، ومراده بخطابه غير معلوم ، ولصار كاللّغز المعمى، فبطل الاحتجاج به، وكان ورود النص على تأويله مغنياً عن الإحتجاج، بتنزيله –وأعوذ بالله- من قولٍ في القرآن يؤدي إلى التوقف عنه، ويؤول إلى ترك الإحتجاج به) وانظر الزركشي (البرهان 2/105) والطاهر بن عاشور (التحرير والتنوير 1/343) . وقد يعترض معترض بما قاله المحقق أبو اسحق الشاطبي في (الموافقات 2/57،135)، من ضرورة مرجع التفسير إلى معهود علوم العرب وفهومهم، لأنهم أمّة أمّيّة، فلا يُتكلف فيه فوق ما يقدرون عليه، وأنتم اليوم تقحمون النص الشرعي في ميادين لم يكن للعرب بها عهد ولا ذمام، في محاولة يائسة لأَسْلَمة العلوم وزعّ المعارف في بوتقة الإسلام. وهذا الكلام قد يكون صحيحاً، إن كان موجهاً لقوم ركبوا بسبيل ذلك كلَّ مركب ، وتقحموا لُجَّة الاستنباط وإعادة القراءة بغير خطام ولا أزمة ، فلا أثر ينصرهم ولا لغة تؤيدهم، ولا سياق يضيء لهم ظلمة ما ارتكبوا ، والحديث معهم له موطن آخر، لكن التسليم لكلام أبي اسحق على إطلاقه فيه نظر، تكفّل ببيانه العلامة الطاهر بن عاشور في تفسيره العجاب (التحرير والتنوير 1/44)، فقد قال رحمه الله، بعد أن نقل ما تقدم من كلامِ أبي إسحق الشاطبي: وهو أساس واهٍ لوجوه ستة: الأول: أن ما بناه عليه يقتضي أن القرآن لم يُقصد منه إنتقال العرب من حال إلى حال، وهذا باطل لما قدمنا ، قال تعالى: (تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَٰذَا). الثاني: أن مقاصد القرآن راجعة إلى عموم الدعوة ، وهو معجزة باقية ، فلا بد أن يكون فيه ما يصلح، لأن تناوله أفهام من يأتي من الناس في عصور انتشار العلوم في الأمة. الثالث: أن السلف قالوا، إن القرآن لا تنقضي عجائبه، يعنون معانيه، ولو كان كما قال الشاطبي لانقضت عجائبه بانحصار أنواع معانيه. الرابع: أن من تمام إعجازه، أن يتضمن من المعاني مع إيجاز لفظه ما لم تفِ به الأسفار المتكاثرة. الخامس: أن مقدار أفهام المخاطبين به ابتداءً لا يقضي إلا أن يكون المعنى الأصلي مفهوماً لديهم ، فأما ما زاد على المعاني الأساسية ، فقد يتهيأ لفهمه أقوام، وتُحجب عنه أقوام، وربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه. السادس: أن عدم تكلم السلف عليها إن كان فيما ليس راجعاً إلى مقاصده ، فنحن نساعد عليه، وإن كان فيما يرجع إليها فلا نُسلِّم وقوفَهم فيها عند ظواهر الآيات، بل قد بيّنوا وفصّلوا وفرّعوا في علوم عنوا بها ولا يمنعنا ذلك أن نقتفي عن آثارهم في علوم أخرى، راجعة لخدمة المقاصد القرآنية، أو لبيان سعة العلوم الإسلامية ، أما ما وراء ذلك، فإن كان ذكره لاتضاح المعنى فذلك تابع للتفسير أيضاً، لأن العلوم العقلية إنما تبحث عن أحوال الأشياء على ما هي عليه، وإن كان فيما زاد على ذلك، فذلك ليس من التفسير، لكنه تكملة للمباحث العلمية واستطراد في العلم، لمناسبة التفسير ليكون متعاطي التفسير أوسع قريحة في العلوم.اهـ. البصيرة الأولى: المعنى الإجمالي للآية، ما ينبغي لأحد من البشر، والبشر جمع بني آدم ، لا واحد له من لفظه مثل: القوم، والخلق وقد يكون اسماً لواحد. (أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ) يقول أن ينزِّل الله عليه كتابه ، (وَالْحُكْمَ) يعني ويعلمه فصل الحكمة (وَالنُّبُوَّةَ) يقول: يعطيه النبوة (ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ) يعني ثم يدعو الناس إلى عبادة نفسه دون الله ، وقد آتاه الله ما آتاه من الكتاب والحكمة والنبوة، ولكن إذا أتاه الله ذلك فإنما يدعوهم إلى العلم بالله ويحدوهم إلى معرفة شرائع دينه، وأن يكونوا رؤساء في المعرفة بأمر الله ونهيه، وأئمة في طاعته وعبادته، بكونهم معلمي الناس، وبكونهم دارسيه."جامع البيان 5/524" للإمام أبي جعفر الطبري. البصيرة الثانية: الربَّاني، هو العالم في قولِ كلِّهم، كما قال الواحدي في (البسيط 5/308) ، والخلافُ في اشتقاقهِ قد ظهرت آثارُه على المعنى المختار في بيان معنى هذا اللفظ، فهل هو منسوب إلى الرب والعلم به، وزيدت الألف والنون لمزيد الاختصاص، وجيء بياء النسبة بعد ذلك، كقولهم: لحياني لعظيم اللحية، ورقباني لعظيم الرقبة، وهذا قول أبي بشر ومن شايعه، أم هو الذي يرُبُّ العلم ويربُّ الناس، أي يعلمهم ويصلحهم، ويقوم بأمورهم ، والألف والنون للمبالغة كما قالوا: ريّان ، عطشان، ونعسان ، ثم ضُمت إليه ياء النسبة (البسيط 5/382)، وبناء على ذلك جاءت أقوال السلف من الصحابة والتابعين في معنى الربَّاني ، فعن الحَبْرِ ابن عباس رضي الله عنه، قال: هم الفقهاء العلماء ، أو الفقهاء الحكماء ، وبنحوه جاء القول عن مجاهد والضَّحاك وقتادة ، والسدّي وأبي رزين، وقال سعيد بن جبير: حكماء أتقياء ، وقال ابن زيد: الذين يربُّون الناسَ ولاةُ هذا الأمر ، يربّونهم ، يلونهم، وعن ابن الأعرابي قال: هم الذين يربُّون الناس بصغار العلم قبل كباره. انظر (جامع البيان 5/526-529)، و(المحرر الوجيز 1/462) ، و(الفقيه والمتفقه ج1/199). وبعد أن اختار ابن جرير الطبري القول الثاني من مادتي الاشتقاق ، قال: (فإذا كان الأمر في ذلك على ما وصفنا ، وكان الربّان ما ذكرنا ، والربّاني هو المنسوب إلى من كان بالصفة التي وصفت ، وكان العالم بالفقه والحكمة من المصلحين أمور الناس بتعليمه إياهم الخير، ودعائهم إلى ما فيه مصلحتهم ، أو كان كذلك الحكيم التقي لله ، والوالي الذي يلي أمور الناس على المنهاج الذي وليه المقسطون من المصلحين أمور الخلق، بالقيام فيهم بما فيه صلاح عاجلهم ، وآجلهم ، وعائدة النفع عليهم في دينهم ودنياهم ، كانوا جميعاً مستحقين أنهم ممن دخل في قوله عز وجل: (وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ) (جامع البيان 5/530)، وهذا قولٌ جامعٌ من هذا الإمام الخبير ، لله درّه ، فإنه صاحب آياتٍ، وسبّاق غايات. البصيرة الثالثة: قوله تعالى: "وَلَكِن كُونُواْ" ، هذا على تقدير القول لدلالة الأَولى عليه ، وأعني قوله تعالى : (مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ..) وهذا الحذف كثير مستسهل في كلام العرب ، فيكون المعنى ولكن يقول كونوا، وقد قدَّرَه الأخفشُ علي بن سليمان على صيغة الأمر فقال: (المعنى ولكن ليقل) (إعراب القرآن 1/392) لأبي جعفر النحاس، وعلى كلٍ، فإنه مضمن دعوتهم إلى بلوغ تلك الرتبة وإفراغ الجهد في التحقق بها ، وأن نَوْلَها أمرٌ في المُكنة ، بل هو دائرٌ بين الوجوب والاستحباب. البصيرة الرابعة: من عادة أهل الإصلاح إذا نَأَتِ المطالب، وعزبت الإرادات الموصلة إليها ، ألّا يُكتفى في استنفاذ الوسع ترغيباً في العمل ، وعدّ المآثر والمعالي ، بل يقرن ذلك ببيان الطرق الموصلة لتلك المطالب ، حتى يغدو المعتاص متهيئاً ، والملتاث مُلتَئِماً، وقد جاء ذلك في قوله تعالى: (وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ) ، ففي قوله تعالى: (بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ...) بياناًللطريق اللَّاحب، الموصل لتلك الغاية، فالباء في قوله: (بِمَا) هي باء السببية كما نبَّه أبو البقاء في (التبيان 1/141) ، وأبو حيان في (البحر 2/530) وقال الشوكاني: وقوله: (بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ)، أي بسبب كونكم عالمين، أي كونوا ربانيين بهذا السبب ، فإن حصول العلم للإنسان والدراسة له يتسبب عنهما الربَّانية ..... . (فتح القدير 1/584). البصيرة الخامسة: إن من أعظم آفات السير إلى المطالب العالية تَلَكُّؤ السير وتَلَوِّيه، ولا شك أن لذاك التَلَكُّؤِ أسباباً عديدة، لا يحتمل المقام بسطها، لكن النفوس المشرقة، ومَن أخذ نفسه بالحزم، وزمّهما بزمام الجِدِّ يسفر له، قوله عز وجل : (بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ) بما يكفي ،ليقطع سُبُلَ التسّويف عن نفسه ، فالمُشارطة حقٌّ ، فمن وفَّى بشرط الصفقة ، وُفِّيَ له، ومَن أَخلَّ فمن نفسه أُتِي. فاتِّساق الرُّتبة لصاحبها بسبيل مكين من المثابرة على تعليم الكتاب ودراسته وقراءته، وإلاّ دون ذلك شيب الغراب. انظر (إرشاد العقل السليم 2/83) لأبي السعود العمادي. ولبيان هذه المُشارطة، نقول : تقدَّم معنا القولُ بسببية الباء في قوله تعالى: (بِمَا كُنتُمْ) ويبقى النظر في (ما) المتصلة بها ، هل هي مصدرية، فتنسبك مع مدخولها بمصدر تقديره (بكونكم)، وهذا ما استظهره أبو حيان (البحر المحيط 2/530)، وجرى عليه أبو علي الفارسي في (الحجة 3/59-60)، أم هي موصولة وقد دفعه أبو علي الفارسي، وخدش فيه السمين الحلبي في (الدر المصور 3/271) ، لما يلزم منه استيفاء المفاعيل وتعذر تقدير العائد على الموصول، وانظر (المحرر الوجيز 1/462-463). وإذا تبين ذلك فلا شكَّ أن المصدر يقتضي الثبوت، وقد انضم إلى ذلك متعلَّق الباء في قوله (بما)، فهي معلقة بمحذوف نعت لـ (ربَّانيين)، وجوّز ذلك رائحةُ الفعل من ربَّانيين ، والظروف والأشباه تتعلق بأرواح الفعل ، ناهيك عن خبر كان في قوله: (بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ) حيث جاء فعلاً مضارعاً يقتضي التجدد والإستمرار، وإعادة العامل فيهما مؤذن بأثر كل واحد من مدخولي الباء على المسبب. انظر (إرشاد العقل السليم 2/83)، وبه يتضح أن استحقاق الربَّانية لا يُنال إلاّ بتعلُّم الكتاب وتعليمه، وصرف العناية في ذلك والثبات عليه، وأن على السالك أن يعي أن لا طريق له للوصول إلى تلك الغاية إلاّ بهذا السبيل ، فإذا كان "العلم –أي علم- بالتعلم" كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بحيازة السَّبق فيه ، فضلاً عن تَسَنُّم مواطن الرأي والمشورة النافذة في أُمَّة محمد صلى الله عليه وسلم. البصيرة السادسة: اختلف القراء في قوله تعالى: (بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ) ،فقد قرأ عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر وخلف (تُعلِّمون) بضم التاء وتشديد اللام المكسورة، وعليه فالفعل متعدي لمفعولين: الأول منهما محذوف وتقديره "الناس" والثاني "الكتاب" وقرأ الحرميان وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب (تُعلِمون) بالتخفيف ، مضارع (عَلِمَ)، وعلى هذا فهو متعدي لمفعول واحدٍ ، وقد استوفاه ، وكان هذا عمدة أبي علي الفارسي، عندما رجّح مصدرية (ما) ،إذ لا راجع من الصلة للموصول (الحجة 3/60)، وقد يخدش فيه على قراءة التشديد ، ولكن للجواب عنه انظر (الدر المصون 4/141). ولأبي علي الفارسي بسط في بيان أسباب إختيار بعض القراء لإحدى القراءتين ، وقد حوى في غضون ذلك على لطائف ، وله في كتاب (الحجة) منها نظائر كثيرة ، وقد أحببت نقله هنا لتعم فائدته، فقد قال –رحمه الله- : وحجة من قال (بما كنتم تُعلِمون)، أي بالتخفيف ، أن أبا عمرو قال، زعموا: يصدقها (تدرسون)، ولم يقل : (تدرِّسون)، ومن حجتها أن العالم الدارس قد يدرك بعلمه ودرسه، مما يكون واعياً إلى التمسك بعلمه، والعمل به ، ما يدركه العالم المعلِّم في تعليمه ، ألا ترى أنه يتكرر عليه في درسه ما يتكرر في تعليمه ، مما ينبه ويبصر من اللطائف التي يثيرها النظر في حال الدرس ، قال أبو زيد –كلاماً معناه- : لا يكون الدرس درساً حتى تقرأه على غيرك. وحجة من قال (تعلِّمون) أن التعليم أبلغ في هذا الموضع ، لأنه إذا علَّم الناس فلم يعمل بعلمه ، ولم يتمسك بدينه ، كان مع استحقاق الذم بترك عمله بعلمه داخلاً في جملة من وبَّخ الله بقوله : (أَتَأْمُرُونَ النَّاسَبِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ) ، ومن حجَّتهم أن الذي يعلِّم لا يكون إلاّ عالماً بما يعلِّم ، فإذا علَّم كان عالماً ، فعلَّم في هذا الموضع أبلغ ، لأن المعلّم عالم ، والعالم لا يدل على علَّم. (الحجة 3/61) وكلا القراءتين حق ثابت، بالنقل الصحيح عن أئمة الإسلام والإقراء ، وكل واحدة أفادت معنىً حوى الخير وزيادة على ما جاءت به أختُها، ولا شكَّ أن الاختيار بين القراءات إذا أفضى إلى إسقاط إحداهما أو تضعيفها أو القدح بنقلتها العدول ، فإنه سوءة يتبرأ أهلُ الإسلام –فضلاً- عن علمائهم منها، قال الإمام أبو العباس أحمد بن يحيى الملقب بثعلب إمام الكوفيين: إذا اختلف الإعراب في القرآن عن السبعة ، لم أفضِّل إعراباً على إعراب في القرآن ، فإذا خرجت إلى الكلام – كلام الناس- فضلّت الأقوى . نقله أبو عمر الزاهد المعروف بغلام ثعلب في كتابه (اليواقيت). وما تقدَّم عن أبي علي الفارسي آنفاً وغيره من أئمة الإسلام ممن تكلم على الترجيح بين القراءات الصحيحة الثابتة ، فأحسن محاملِه أنه ذِكرٌ للوجوه المرجحة لمعاني الألفاظ أو التراكيب اللغوية، والبنى الصرفية للمفردات، لا على أنه ترجيح يفضي أو يكاد إلى إسقاط القراءة الثابتة ، ولذا قال أبو حيان –رحمه الله- : وتكلَّموا في ترجيح إحدى القراءتين على الأخرى ، وقد تقدَّم إني لا أرى شيئاً من هذه التراجيح لأنها كلها منقولة متواترة قرآناً، فلا ترجيح في إحدى القراءتين على الأخرى. (البحر 2/530)،(الدر المصون 1/48-49)، وقد نهس النحويين بسبب ذلك جمهرةٌ من أهل العلم ، فيهم الأساطين ودونهم من المحدثين أرباب اللهج، بضرورة إعادة قراءة التُّراث عامة، واللُّغوي منه خاصة ، وفق نظريات استُنبتت في أرض غريبة عن لغة القرآن ، وسُقِيَت بماء حداثةٍ ، إن كان لائقاً فإنه يليق بتلك المُصَع، لا بباسقات تراثنا المجيد، وانظر (النحو وكتب التفسير 1/19-98)للدكتور إبراهيم رفيدة، و(منهج سيبويه في الإستشهاد بالنحو 1/234)للدكتور سليمان خاطر. البصيرة السابعة: بين الدراسة والتصرُّف في العلوم وتفصيل مخبآته تلازمٌ ، أقل أحواله أن يكون عادياً، وفي قوله تعالى: (وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ)، إشارة لذلك، وذلك على قراءة (دَرَسْت)، بسكون السين من الدراسة، أو على قراءة (دارست) بالألف من المدارسة ، فتصريف الآيات والمجيء بها مفصَّلة ، آية بعد آية سيؤدي بهم إلى أن يقولوا (دَرَسْت) أو (دارست). انظر (معاني القرآن 2/226)للزجاج ، و(الحجة 2/375) للفارسي ، و(معاني القرآن 2/87) للنحاس، واللام في قوله تعالى: (لِيَقُولُوا) هي التي يسميها الكوفيّون لام العاقبة أو الصيرورة ، وأنكر ذلك البصرية وجعلوها لام التعليل . انظر كتاب (اللامات 119)للزجاج ، (مغني اللبيب1/240) ، و (الجنى الداني 121) فإنه مادة ابن هشام في المغني في الحروف والأدوات. وقد توسل المعتزلة وغيرهم بمعنى الصيرورة للوصول إلى مآرب عقدية، في توجيه كلام الله تعالى، تارة بنفي خلق أفعال العباد، وأخرى بنفي التعليل عن أفعال الله تعالى ، وليس لهم فيما توسلوا به متمسك، لأن ما يصلح في سياقٍ، ليس بالضرورة يصلح لكل سياق ، ناهيك عن القواطع التي ملأت كتاب الله عز وجل على إثبات ما نفوه ، وتأكيد ما رغبوا عنه ، فليحذر الدارس الغِرّ من السّم في حلاوة العسل مدسوساً، لئلا يزعقه وهو لا يشعر . وفي غضون ذلك نلمح معنىً جليلاً، فيه تسليةٌ لكلِّ من رُزِقَ حظاً وافراً من العلم ، وضَرَبَ بيدٍ باطشة فيه، أن سيكون عُرضةً لسهام الحاسدين ، وهدفاً للطاعنين في علمه ومعرفته ، وحسبه قول الله تعالى: (أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ). البصيرة الثامنة: على قراءة التشديد في قوله تعالى (تعلِّمون) يلزم أن يحمل الربّاني على أمر زائد على العلم والتعليم، وهو أن يكون مع ذلك حكيماً مخلصاً، أو حكيماً حليماً حتى تظهر السببية كما ذهب إلى ذلك الشوكاني في (فتح القدير 1/584)، وقد أشار مجاهد بن جبر –رحمه الله- إلى ذلك عندما قال : الربَّانيون : الفقهاء العلماء وهم فوق الأحبار (تفسير الطبري 5/528) ، وعلّق على ذلك ابن جرير بقوله: فالربَّانيون إذاً هم عماد الناس في الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا ولذلك قال مجاهد وهم فوق الأحبار ، لأن الأحبار هم العلماء ، والربَّاني الجامع إلى العلم والفقه والبصر بالسياسة والتدبير والقيام بأمور الرعية وما يصلحهم في دنياهم ودينهم. (جامع البيان 5/531). البصيرة التاسعة: للزمخشري في تفسير قوله تعالى: (وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ) ، كلام حول تعاضُد العلم مع العمل وضرورة الإخلاص في العمل ، وإلاّ كان وبالاً على صاحبه والإخلال بالعمل آفة تضرب بُجْرَانها في أطناب الطلبة والمنتسبين للعلم ، فتراهم سُرُجَاً في سرده أرض برصاء إذا جاء العمل، وهذا من الخِذلان الذي يضرب الله به على قلب المحصل وعما قريب إن لم يتدارك ويبادر العلم بالعمل سترى أمره إلى تباب. فمما قال -عفا الله عنه- : أوجب أن تكون الربَّانية التي هي قوة التمسك بطاعة الله، مسبَّبَةً عن العلم والدراسة، وكفى به دليلاً على خيبة سعي من جَهَد نفسه، وكدّ روحه في جمع العلم، ثم لم يجعله ذريعة إلى العمل ، فكان مثله مثل من غرس شجرة حسناء تونقه بمنظرها، ولا تنفعه بثمرها ثم قال: وفيه أن من علم ودرَّس العلم ولم يعمل به فليس من الله في شيء ، وأن السبب بينه وبين ربه منقطع ، حيث لم يثبت النسبة إليه إلاّ للمتمسكين بطاعته. (الكشاف 1/387). وهذا الكلام لو صدر من غير هذا الرجل لكان له في الخير محمل، ولحُمِل على التشديد وضرورة الجمع بين العلم والعمل ، لكن للزمخشري على علو كعبه في الدرس البلاغي خَلَّة سوء ، طفح بها تفسيره ، ألا وهي، تطويع آيات الكتاب العزيز لمذهبه الاعتزالي والتوسل بالأداة اللغوية لتحقيق تلك ، وقد نشر مآبره بطريقة موثقة، تخدع ذا اللُّب، حتى أن السراج البلقيني يقول: استخرجت الاعتزال من كشَّاف الزمخشري بالمِنقاش. ومن أجل ذلك علَّق أبو حيان الأندلسي على كلام الزمخشري السابق بقوله: وفيه دسيسة الاعتزال وهو أن لا يكون مؤمناً عالماً إلاّ بالعمل ، وأن العمل شرط في صحة الإيمان. (البحر المحيط 2/530). وقال أبو علي السكوني: وفيه التكفير بالذنوب والجزم على العصاة بالتخليد في النار ، وهذا كله اعتزال. (التمييز لما أودعه الزمخشري من الإعتزال في الكتاب العزيز 2/27). البصيرة العاشرة: يقول الإمام ابن العربي المالكي: حرّم الله على الأنبياء أن يتخذوا الناس عباداً يتألهون لهم ، ولكن ألزم الخلق طاعتهم، وقال –أيضاً-: قرأ ابن عامر وأهل الكوفة بضم التاء –يعني في قوله : (تُعلمون)- وكان معناه لا تتخذوهم عباداً بحق تعليمكم، فإنه فرض عليكم، أو إشراك في نيتكم، أو استعجال لأجركم، أو تبديل لأمر الآخرة بأمر الدنيا ، واختاره الطبري على قراءة فتح التاء.(أحكام القرآن 1/366-367). وما نقله عن ابن جرير الطبري، يعني به قوله: وما ينبغي لأحد من البشر، والبشر جميع بني آدم ، لا واحد له من لفظه مثل القوم والخلق وقد يكون اسماً لواحد ، (أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ) ، يقول: أن ينزل عليه كتابه (وَالْحُكْمَ) يعني يعلمه فصل الحكمة ، (وَالنُّبُوَّةَ) يعني ويعطيه النبوة (ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّه) يعني ثم يدعو الناس إلى عبادة نفسه دون الله ، وقد آتاه الله ما آتاه من الكتاب والحكم والنبوة. (جامع البيان 5/524)، وقال العزُّ بن عبد السلام في (تفسيره 1/225) : (مَا كَانَ لِبَشَرٍ) ما جاز. وكلامهم صريح في كونه على جهة التكليف للأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، وفي ذلك من العظة ما يكفي لمن رُزِقَ حظاً من البصيرة أن يَكُفَّ طماحه ، ويقطع أطماعه في تطلب الجاه والمنزلة في قلوب العباد، والسعي لذكر الفعلة وعزها، وسناء الوقعة وصوتها ، ولو أبصر هذا الأخرق لعلم أن العلم الذي تبوأ به هذه المكانة ، هو محض فضل الله ومنته ، وعليه أن يسير بهذه النعمة على مراد الله عز وجل ، وأن يُعبّد الخلقَ لربهم اختياراً، كما هم عبيد له اضطراراً، وهذا معنى يليق بمن حمل الباء في قوله تعالى: (وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ) على معنى (في) ، أي كونوا ربانيين في علمكم أوتعليمكم ودراستكم. انظر (التحصيل 2/... ) لأبي العباس المهدوي. وقال أبو اسحق الزجاج : إن الله لا يصطفي لنبوته الكَذَبَة ، ولو فعل ذلك بشرٌ لسلَبَه اللهُ عزَّ وجلَّ آيات النبوة وعلاماتها. (معاني القرآن 1/367)، وعلى هذا مشى أبو حيان في (البحر 2/528) ، وبسط تلميذه الشهاب الحلبي القول في ذلك قائلاً : ومعنى مجيء هذا النفي في كلام العرب نحو "ما كان لزيد أن يفعل"، ونحوه نفي الكون والمراد نفي خبره ، هو على قسمين: قسم يكون النفي فيه من جهة الفعل ، ويُعبَّر عنه بالنفي التام ، نحو هذه الآية ، لأن الله تعالى لا يعطي الكتاب والحكم والنبوة لمن يقول هذه المقالة الشنعاء ، ونحوه (مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا)، و(وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ الله). وقسم يكون النفي فيه على سبيل (الانتفاء)، كقول أبي بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم فيصلِّي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويُعرف القسمان من السياق. (الدر المصون 3/79)، ومادة هذا القول القاضي أبو محمد بن عطية في (المحرر الوجيز 1/461). وقوله –رحمه الله-: المراد نفي الخبر ، أي متعلق الخبر ، لأن قوله تعالى: (مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ) الخبر لـ(بشر) متعلق بمحذوف هو الخبر الحقيقي ، والمصدر المنسبك من أن والفعل في محل رفع مبتدأ، وكلمات المفسرين اختلفت في تفسير هذا المتعلق ، فأنت تراه عند ابن جرير الطبري (ينبغي) وعلى ذلك جرى السيوطي في تفسير الجلالين وعلَّقَ الجملُ في (الحاشية 1/444) بقوله: قوله (ينبغي) ، إما تفسير لكان أو بيان لمتعلق الجار والمجرور الواقع خبراً لكان ، وسيأتي للشارح في سورة (يس) تفسير الانبغاء بالإمكان ، وتأول الصاوي في حاشيته (1/361) قولَ الجلالِ (ينبغي) بيمكن، مستدركاً بكلام الشهاب الحلبي آنف الذكر ، والذي دعاهم لذلك أنهم حملوا كلمة (ينبغي) على أنه من جملة خطاب التكليف ، والنص مبني عندهم على النفي التام ، وسلفهم في منع كونه من خطاب التكليف الفخر الرازي ، فقد قال: واعلم أنه ليس المراد من قوله (مَا كَانَ لِبَشَرٍ)، ذلك أنه يحرم عليه هذا الكلام ، لأن ذلك محرّم على كل الخلق ، وأيضاً لو كان المراد منه التحريم ، لما كان ذلك تكذيباً للنَّصارى في ادعائهم ذلك على المسيح عيه السلام ، لأن من ادعى على رجل فعلاً ، فقيل له إن فلاناً لا يحل له أن يفعل ذلك ، لم يكن تكذيباً له فيما ادعى عليه... .(مفاتيح الغيب 4/321). وكنت علقت على كلام الفخر الرازي بقولي: فيه نظر لا يُسلّم له وجه احتجاجه على ما منع. ولما بيَّضتُ المقالَ وقفتُ على أصله الذي أُخِذَ عنه ، وهو أبو علي الجبائي المعتزلي، حيث قال: ليس قوله (مَا كَانَ لِبَشَرٍ)، على سبيل التحريم ، لأن هذا محرَّم على جميع الخلق ، ولو كان ذلك تحريماً ، لم يكن تكذيباً للنصارى في ادعائهم ذلك على المسيح، لأن من ادعى على إنسان قولاً، فقال: فلان لا يحل له كذا ، لا يكون مكذباً لدعواه، وإنما أراد الله بهذا تكذيبهم. وتعقبه على قوله هذا، الراغبُ الأصفهاني في (تفسيره 1/671) قائلاً: وما قاله فيه قصور نظر ، فإن النصارى أقرّوا بأن المسيح لم يكن يدعي ما لم يكن له أن يدعي ، فإذا أقرّوا بذلك ، وبيّن الله تعالى أن ليس له ولا لأحد من البشر أن يقول ذلك، كان فيه إلزامٌ واضحٌ ، وكأنه قيل قد ثبت أن المسيح لم يكن يدعي ما ليس له دعواه، وثبت أنه كان بشراً بما تقدَّم في هذه السورة وغيرها ، ولم يكن لأحد يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يقول للناس: اعبدوني من دون الله ، وإن المسيح قد أوتي الكتاب والنبوة ، فإذن محال أن يدعو أحداً إلى عبادته. فالحمد لله على توفيقه، وحرف المسألة ضرورة التفريق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، فمن برح الخفاء به في هذا الباب أصاب المحز فيه، فقوله تعالى: (مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ..) ممتنع شرعاً وقدراً ، وقوله تعالى: (وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا) ممتنع قدراً ، بل ممتنع وصفاً، لأنه لا يتصور أن يأتي به القدَّر، مستحيل أن يكون الله تعالى ناسياً أو منسياً ، وقوله تعالى :(وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ) ممتنع شرعاً ، ولو شاء أن يُعذِّبَهم وهو فيهم لعذَّبَهم، ولكنه ممتنع شرعاً .(تفسير سورة آل عمران 1/450) للعلامة المتفنن ابن عثيمين رحمه الله . وبهذا التفصيل يزول الإشكال الوارد في هذه المسألة، فكل فريق من المثبتة والنافية ، يأتي بحجج لا تُدفَع ، والصواب التفصيل الذي أوردناه ، والله أعلم .انظر (شفاء العليل 3/1375) للمحقق الهُمَام ابن القيّم . وفي قوله تعالى: (مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ...) دلالة هامة على ضرورة اعتبار حال الأنبياء والتأمل في أخلاقهم وسيرتهم، والنظر في أقوالهم وأفعالهم، فكلها دلائل تؤيد نبوتهم ، ولزوم تصديقهم في ذلك. فهذا الإمكان المنفي لا يخلو كما قال الراغب (التفسير 1/670) ، إما أن يكون من خارجٍ ، كالقهر أو من جهة الشرع والعقل ، وقد نبَّه تعالى أنهم ممنوعون من ذلك من جهة العقل المسدد ، والحظر الوارد عليهم من قبله تعالى، لا منعاً من جهة عدم التمكن، ولذا كان قولك ليس لفلان أن يفعل كذا ،أبلغَ من قولك هو لا يفعل كذا، فالبعض لا يرى إلا المعجزة ، شاهد صدق معتبر على دعوى النبوة ، والدلائل الأخرى إما أن يكون لها نصيب من الاعتبار أو لا، ولكنَّه يدخل في هذه البابة على استحياء، فهذا العضد الإيجي يقول –بعد أن ذكر المسالك الثلاث لإثبات نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، الأول: وهو المعجزة، والثاني: الاستدلال بأحواله قبل النبوة، والثالث: إخبار الأنبياء والمتقدمين عليه، والمعتمد هو ظهور المعجزة على يده، وهذه الوجوه الأخرى للتكملة، وزيادة التقرير.(المواقف 357). والحق أن النبوة مشتملة على علوم وأعمالٍ، لا بد من أن يتصف الرسول بها ، وهي أشرف العلوم ، وأشرف الأعمال ، فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب، ولا يتبين صِدْقُ الصادقِ ، وكَذِبُ الكاذبِ من وجوهٍ كثيرةٍ ، ولا سيما والعالَم لم يخلو من آثار نبي من لدن آدم إلى زماننا، وقد عُلِمَ جنس ما جاءت به الأنبياء والمرسلون ، وما كانوا يدعون إليه ويأمرون به ، ولم تزل آثار المرسلين في الأرض، ولم يزل عند الناس من آثار الرسل ما يعرفون به جنس ما جاءت به الرسل ، ويفرِّقون بين الرُّسل وغير الرُّسل ، فلو قُدِّر أن رجلاً جاء في زمن إمكان بعث الرُّسل ، وأمر بالشرك وعبادة الأوثان ، وأباحَ الفواحشَ والظُلّمَ والكذب ، ولم يأمر بعبادة الله ، ولا بالإيمان باليوم الآخر، هل كان مثل هذا يحتاج أن يُطالبَ بمعجزة أو يُشَكَّ في كَذِبِهِ أنه نبيّ، ولو قُدِّرَ أَنَّه أتى بما يُظَنُّ أنه معجزة ، لعُلِمَ أنه من جنس المخاريق أو الفتن والمحنة، ولهذا لما كان الدجَّال يدَّعي الإلهية ، لم يكن ما يأتي به دالاً على صدقه ، للعلم بأن دعواه ممتنعة في نفسها وأنه كذَّاب. (شرح الأصفهانية 544). سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلاّ أنت ، استغفرك وأتوب إليك. بقلم أبي الحارث
__________________
|
 |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
 |
 |