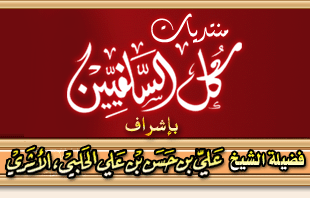


 |
 |
أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
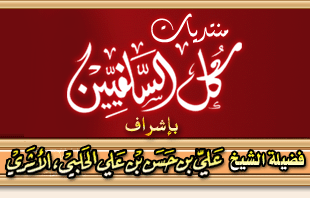 |
 |
 |
|||||
|
|||||||
| 94305 | 98094 |
|
#1
|
|||
|
|||
|
هذا بحث في أسلوب من أساليب البلاغة لصاحبه : الأستاذ وليد علي الطنطاوي ، رأيت نشره بين طلبة العلم ، و لا يعني ذلك بالضرورة أنّي أرتضي كلّ ما جاء فيه ، فأصل البحث مهم ، أما الجزئيات فقد تختلف التعابير عنها ، و كذلك بعض الأحاديث التي لم تصحّ و غيرها من العبارات ، و التي قد يتاثّر فيها الباحث ببعض المدارس أو المصطلحات الحادثة ، و قد جاء بعنوان :آراء العلماء في أسلوب السجع من حيث الإباحة والحظر.
خلاصة ـــ هذا البحث يبحث في آراء العلماء في أسلوب السجع من حيث الإباحة والحظر الكلمات لمفتاحية : آراء العلماء ، أسلوب السجع ، فواصل . -الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، سوف نتحدث في هذا المقال عن آراء العلماء في أسلوب السجع من حيث الإباحة والحظر . ولا تفوتنا الإشارة بإيجاز إلى آراء العلماء في أسلوب السجع من حيث الإباحة والحظر، ومن حيث جواز إطلاقه على ما في القرآن الكريم من فواصل وعدم الجواز. فقد اختلفت آراء العلماء في ذلك، فمنهم مَن عاب أسلوب السجع وعدَّه من الأساليب التي تقوم أكثر ما تقوم على الصنعة، وعلى التكلف، والتعسف، وهم يستدلون على وجهة نظرهم بما آل إليه حالُ البيان العربي من تدهور وانحطاط في العصور التي شاع فيها استعمالُ السجع، ومنهم من استحسنه ودافع عنه محتجًّا بأنه لو كان مذمومًا لما ورد في النظم الكريم؛ حيث لا تكاد سورةٌ تخلو منه، بل إن من سوره ما جاءت جميعها مسجوعة كسورة القمر، وسورة الرحمن وغيرهما. ومنهم من أجاز إطلاق السجع على ما في القرآن الكريم، ومنهم من منعه وأطلق اسم الفواصل. وكدأب العلماء قديمًا وحديثًا انقسموا فريقين: فريق يُثبت وجوده في القرآن ويؤيد، وآخر ينفي ويعترض، وكلٌّ أدلى بدلوه. فالمانعون وعلى رأسهم الباقلاني يستندون إلى أدلة كثيرة؛ منها: أن الفواصل بلاغة والأسجاع عيب، وذلك أن الفواصل تابعة للمعاني، وأما الأسجاع فالمعاني تابعة له، ثم إن السجع يألفه الكهان من العرب، ونفيه من القرآن أجدر لأن يكون حجة لنفي الشعر؛ لأن الكهانة تنافي النبوات، كما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال للذين كلموه في شأن الجنين: ((أَسَجْعًا كسجع الكهان؟))، فرأى ذلك مذمومًا. وأن لو كان في القرآن سجع لأمكن معارضته؛ لأن السجع غير ممتنع عليهم بل هو من عادتهم، ثم إن تقديم موسى على هارون في موضع تأخيره عنه في آخر ليس للسجع، بل لفائدة أخرى، وهي إعادة ذكر القصة بألفاظ مختلفة تؤدي معنًى واحدًا، فالمقصد من تقديم بعض الكلمات وتأخيرها؛ إظهارًا للإعجاز على الطريقين جميعًا، ثم إنه لا يقال: في القرآن أسجاع لعدم الإذن الشرعي، وأيضًا لا يقال: في القرآن أسجاع، إنما يقال: فواصل؛ لقوله تعالى: {كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} [فصلت: 3]، هذا هو رأي المانعين. أما المجيزون بوجود السجع في القرآن فأدلتهم كما أوردوها هي أن السجع ليس عيبًا، فمنه ما يأتي طوعًا سهلًا تابعًا للمعاني، وبالضد من ذلك، والقرآن لم يأتِ فيه مثال من القسم المعيب لعلوه في الفصاحة، كما أن الرسول صلى الله عليه و سلم سمع الشعر واستحسنه، وأمر به شعراءه، فالسجع والمزدوج دون القصيد والرجز، فكيف يحلُّ ما هو أكثر، ويحرم ما هو أصغر؟. ثم إن زوال التحريم لزوال العلة، فالنهي وقع عن السجع؛ لقرب عهد العرب بالجاهلية حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم قيد الإنكار بالتشبيه كسجع الكهان، ولو كان الإنكار لذاته لقال: أسجع فقط، الأمر الذي يعني: أن النهي منصب على سجع الكهان، كما أن إثبات السجع في القرآن صحيح؛ لأنه مما يبين به فضل الكلام، ولأنه من الأجناس التي يقع بها التفاضل في البيان والفصاحة كالتجنيس والالتفات. ثم إنه لا سببَ للفصل بين الفاصلة والسجع، والفاصلة، أو السجعة في القرآن تؤدي دورها تمامًا، كما تؤديه في غيره من الكلام الفني الجميل، ويقول أحد المثبتين وهو التنوخي، في كتابه: (الأقصى القريب): أما مَن عاب السجع مطلقًا فمخطئ؛ لأن السجع كثير في كتاب الله، في كلام النبي صلى الله عليه و سلم والفصحاء كقس وسحبان، وإنما يُعاب السجع إذا احتاج متكلفه إلى تنقيص المعنى أو زيادته، فالذي فاته من المعنى يقبح، وترك السجع لا يقبح، فيكون حينئذٍ السجع قبيحًا لاستلزام القبح، وبهذا يجاب عن قول النبي صلى الله عليه و سلم: ((أسجعًا كسجع الكهان؟))؛ لأنه لو عاب السجع مطلقًا لَمَا نطق به، ولا يمكنه أن يعيبه مطلقًا؛ لمجيئه في كتاب الله تعالى كثيرًا. فالمعيب إذن هو سجع مخصوص وهو الذي مثله بسجع الكهان، وهو الذي ينقص المعنى ولا يزيده. وفي: (العناية)، و(الكفاية)، يقول شهاب نقلًا عن البقاعي، في كتابه: (مصاعب النظر): اختلف السلف في السجع، قال أبو بكر الباقلاني، في كتاب: (الإعجاز): "ذهب أصحابنا الأشاعرة كلهم إلى نفي السجع عن القرآن، كما ذكره أبو الحسن الأشعري في غير ما موضع من كتبه، وذهب كثير ممن خالفهم إلى إثباته، والقول الثاني وهو القول بإثبات السجع في القرآن فاسد؛ لما في القرآن من اختلاف أكثر فواصله في الوزن والروي، ولا ينبغي الاغترار بما ذكره بعض الأماثل كالبيضاوي والتفتازاني من إثبات الفواصل والسجع فيه، وأن مخالفة النظم في مثل هارون وموسى بحسبه ". يقول شهاب: "ونقل أبو حيان في قوله تعالى: {وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ} [فاطر: 21]، أنه لا يقال في القرآن: قدَّم كذا أو أخر، كذا للسجع؛ لأن الإعجاز ليس في مجرد اللفظ بل فيه وفي المعنى، ومتى حُوِّل اللفظ لأجل السجع عما كان لا يتم به المعنى بدون سجع؛ نقض المعنى وقيل عليه: أنه نسي ما قاله في الصافات من أن التعبير بمارد ومريد بالفاصلة، ثم إنه قال: لو كان في القرآن سجع لم يخرج عن أساليب كلامه، ولم يقع به إعجاز -لا يزال الكلام لشهاب- ولو جاز أن يقال: سجع معجز، جاز أن يقال: شعر معجز، والسجع مما تألفه الكهان، وقد أنكر النبي صلى الله عليه و سلم على من سجع عنده، وعلى ما عرف في كتب الحديث، ولو كان سجعًا لكان قبيحًا لتقارب أوزانه واختلاف طرقه، فيخرج عن نهجه المعروف، ويكون كشعر غير موزون وما احتجوا به من التقديم والتأخير ليس بشيء، فإنه لذكر القصة بطرق مختلفة". قال شهاب: وقد أطال أبو حيان بلا طائل لتوهمه أن السجع كالشعر؛ لأن التزام تقفيته ينافي جزالة المعنى وبلاغته، لاستتباعه للحشو المخل، وأن الإعجاز بمخالفته لأساليب الكلام فشنع على هؤلاء الأعلام وليس بشيء، ولا عجب منه أنه ذكر كلام الباقلاني مع التصريح فيه بأن من السلف مَن ذهب إليه، والحق أنه في القرآن من غير التزام له في الأكثر، وكأن من نفاه نفى التزامه أو أكثريته، ومن أثبته أراد وروده فيه في الجملة، والمرجح والأولى كما قال العلماء أن نقول عما جاء في القرآن الكريم على هيئة السجع فواصل؛ تأدبًا مع كلام ربنا سبحانه وتعالى، ولنا في إمام مدرسة المتأخرين السكاكي القدوة؛ حيث عدل في كتابه (المفتاح) عن المصطلحات البلاغية التي رسخت في أذهان السابقين مثل: المغالطة عند شيخ عبد القاهر، فإن السكاكي سماها أسلوب الحكيم؛ لأنه ورد في الذكر الحكيم، وكذلك تجاهل العارف سماه السكاكي: سوق المعلوم مساقَ غيره لوجوده في كلام الله تعالى. والفاصلة أولى من السجع لورودها في القرآن كما قال ربنا: {كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} [فصلت: 3]، وكما قال: {الر كِتابٌ أُحكِمَت آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَت مِن لَدُن حَكيمٍ خَبيرٍ} [هود: 1]، على أن إيثار التعبير بالفواصل القرآنية فيه خروج من هذا الخلاف الشكلي حول إطلاق كلمة السجع على الفاصلة القرآنية، وقد رأيت ما يحدثه تلائم الفواصل من إثارة الشعور، ودفع الملل، وجذب المخاطبين، وبخاصة في هذه البيئة الشاعرة التي نزَل فيها القرآن الكريم. يساعدنا على ذلك أن الفاصلة أعم من السجع حيث إنها تطلق على أواخر الآي، سواء اتفقت الأحرف أم اختلفت، واقرأ معي قول الله تعالى: {لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ﴿١﴾ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ﴿٢﴾ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَـذَا الْبَيْتِ ﴿٣﴾ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾} [قريش:1- 4]، فإنك ستجد لذة التلاوة وحلاوتها؛ إذ الكلمات: هي أربع كلمات تنتهي بأحرف مختلفة، ولكنها من فصيلة واحدة، وهي حروف الهمس: سكت فحثه شخص، وكل كلمة قبل آخرها حرف مدٍّ ولين، وهذا الحرف يُمدُّ حركتين أو أربعًا أو ستًّا يُسمى مدًّا عارضًا للسكون، وهذا التنغيم الصوتي يؤدِّي -بلا شك- إلى جمال الأداء مع جمال اللفظ مع جمال المعنى، مع جمال الهدف، كل هذا يؤدي إلى دخول القرآن إلى القلب؛ لعوامل شتَّى: الأداء اللفظي مع الفاصلة القرآنية التي تأتي، والمعنى في قول واحد، ولذلك تسمع وترى مَن أسلم بسبب سماعه القرآن الكريم، فهذا عمرُ بنُ الخطاب رضي الله عنه لما سمع سورة طه أو الحاقة في إحدى روايتي إسلامه. من أجل هذا حاول الكفار قديمًا وحديثًا صرفَ الناس عن مجرد سماع القرآن، أخبر الله تعالى عن مثل ذلك في سورة فصلت، حيث قال تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَـذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ } [فصلت: 26]، ولذا لا يُملُّ سماع القرآن الكريم بسبب ما فيه من فواصل وخلافها، حتى قال فيه أفصح العرب صلى الله عليه و سلم: ((لا يَخْلِق عن كثرة الرد)). ونحن المسلمين نقرأ القرآن منذ نعومة أظفارنا، ولا نمله إن شاء الله ما بقينا؛ حيث إنك تقف مندهشًا من حفظ الأطفال الصغار جدًّا، جزء عم ،بما فيه من الفواصل البليغة، في حين أنهم لا يستطيعون حفظ قصيدة امرئ القيس مثلًا، أو حتى حسان بن ثابت رضي الله عنه، وما هذا إلا أنه بُني على فواصل بليغة حكيمة، كل فاصلة في مكانها، وحُقَّ لنا أن نعتز بهذا الكتاب، وحقًّا صدق الله إذ يقول: {إِنّا نَحنُ نَزَّلنَا الذِّكرَ وَإِنّا لَهُ لَحافِظونَ } [الحجر: 9]. وخلاصة الرأي في هذا الخلاف:
أن منع إطلاق مصطلح السجع على ما في القرآن الكريم إنما هو لرعاية الأدب فقط؛ لأن السجع في الأصل هدير الحمام ونحوه، ولأنه قد شاع إطلاق هذا المصطلح على أقوال الكهان، ولم يَرد نص شرعي صريح يمنع من إطلاق السجع على ما في القرآن الكريم. أما نهي النبي صلى الله عليه و سلم عن السجع، فهو مقيد بسجع الكهان، وليس مطلقًا، وقد مر بنا سبب هذا النهي. هذا، وقد ذكر ابن الأثير شروطًا أربعة ، ينبغي تحققها حتى يكون السجع حسنًا، فإذا فُقدت شرط أو فُقد شرط لا يكون السجع حسنًا، وتلك الشروط هي: أولًا: أن تكون الألفاظ المسجوعة حلوةً رنانة،ً لا غثةً ولا باردةً. الأمر الثاني: أن تكون التراكيب أيضًا صافية حسنة رائقة خالية من الغثاثة، وذلك أن المفردات قد تكون حسنة، ولكنها عند التركيب تفقد هذا الحسن، ولذا شُرط في التركيب ما شرط في المفرد، ومعنى الغثاثة والبرودة التي ينبغي أن تخلو منها الألفاظ والتراكيب أن يهتم المتكلم بالسجع ويهمل الألفاظ والتراكيب، فلا يراعي خصائصها ولا مواقع مفرداتها. الأمر الثالث: أن يكون اللفظ فيه تابعًا للمعنى، لا أن يكون المعنى تابعًا للفظ، وإلا كان كظاهر مموه على باطل مشوَّه. الأمر الرابع: أن تكون كل واحدة من الفقرتين المسجوعتين دالة على معنى غير المعنى الذي دلت عليه أختها، فإذا كان المعنى فيهما سواء، فذلك هو التطويل بعينه؛ لأن التطويل إنما هو الدلالة على المعنى بألفاظ يُمكن الدلالة عليه بدونها. انتهى من كلام ابن الأثير . ولكن الشرط الأخير، لم يُسلم لابن الأثير، وقد فنَّده ابن أبي الحديد في حاشيته على المثل الأسير، ذاكرًا: أن السجعة الثانية إذا كانت بمعنى الأولى فهي تؤكد معناها، والتأكيد عمدة البيان، ثم ذكر أن القرآن الكريم قد ورد فيه ذلك في كثير من مواضعه، نحو قوله تعالى: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَـهِ النَّاسِ﴿٣﴾} [الناس:1 - 3]، فالرب ها هنا، والملك، والإله بمعنًى، فكل سجعة من هذه السجعات قد أعطت معنى الأخرى، ومثله قول تعالى: {وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ﴿١٤﴾ لِّنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ﴿١٥﴾ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا } [النبأ:14 - 16]، فإن الجنات هي البساتين، ولا معنًى للبساتين إلا ما كان محتويًا على الحب والجنات. وقوله -تبارك وتعالى-: {إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿٢٧﴾ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا ﴿٢٨﴾} [النبأ: 27- 28]، فإن عدم اعتقادهم في الحساب هو تكذيبهم بالآيات. ومثل هذا في القرآن العزيز كثير جدًّا. والمرجح في هذا: أن السجعة الثانية عندما تأتي بمعنى الأولى، فإن كانت مؤكدة لها أو مبينة أو موضحة كما رأينا في الآيات، فذلك محمود؛ لأنه إطناب، والإطناب من البلاغة. أما إذا كان تكرارها لا يزيد الأولى شيئًا فذلك مذموم؛ لأنه من التطويل، والتطويل عيٌّ، ومنه قول الصابي: الحمد الله الذي لا تدركه العيون بألحاظها، ولا تحده الألسنة بألفاظها، ولا تخلقه العصور بمرورها، ولا تهرمه الدهور بكرورها، ثم الصلاة على النبي الذي لم يرَ للكفر أثرًا إلا طمسه ومحاه، ولا رسمًا إلى أزاله وعفاه. فلا فرق هنا بين مرور العصور، وكرِّ الدهور، ولا بين محو الأثر وعفاء الرسم، فالسجعة الثانية مكررة، وتكرارها لم يفِد الأولى شيئًا، ولم يزد الكلام بهجة، ولا أضفى عليه رونقًا، ولذا كان من التطويل المعيب، هكذا قالوا. ويُقبل السجع أيضًا إذا خرج عفوًا غير مستكره ولا مستجلب، بل يأتي والكلام مطابق لمقتضى الحال، ويتمثل ذلك في القرآن الكريم -كما رأينا- وفي السنة النبوية المطهرة الشريفة، وفي حكم وأمثال العرب، وخطب الخلفاء الراشدين، ومَن سرى سيرهم، وهاك بعض الأمثلة. مثلًا قوله في سورة القمر، فكل آية آخرها حرف راء، وهناك ست آيات آخرها حرف راء، هذه الراء بعدها ياء المتكلم، وهي : {فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ} [القمر: 16]، وحذفت الياء لأغراض منها :رعاية الفاصلة التي بُنيت على حرف الراء وحذفها؛ لدلالة ياء المتكلم الموجودة في الكلمة قبلها: {عَذَابِي}، ومنها قطع الكلمة عند حرف الراء للتخويف والترهيب، فهو نذر عظيم لا يُقادر قدره ولا يُحاط وصفه، فحذف الياء جاء للتوافق الصوتي مع الآيات السابقة واللاحقة. وعليه، فالقرآن الكريم قمة في ذلك، فهو يحرص على توافق التنغيم الصوتي بقدر حرصه على مراعاة الأحوال والمقتضيات. مثلًا قوله تعالى غير ما سبق: {وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا} [المزمل: 8]، المصدر للفعل تبتل تبتلًا على زنه تفعَّل، ومع ذلك جاء بزنة تفعيل، وذلك مراعاةً للفاصلة؛ ليدل على أنه ينبغي له تجريد نفسه عما سواه ومجاهدته، فلذا ذكر التبتيل الدال على فعله بخلاف التبتل، فإنه لا يدل إلا على قبول الفعل كالانفعال، وكذا مراعاة زيادة حرف مثل الألف في نحو قوله تعالى: {إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّـهِ الظُّنُونَا } [الأحزاب: 10]، فكلمة: {الظُّنُونَا} زيدت في آخرها الألف مراعاةً بحق الفاصلة، وهذا كما ذكرنا ليس بأصلي؛ لأن هناك قراءة بحذف الألف وصلًا ووقفًا، فالذين أثبتوا الألف في الظنون وقفًا ووصلًا، لأنها تشبه هاء السكت في كونها فريدة في بيان الحركة، وهاء السكت تَثْبُتُ وقفًا للحاجة إليها، وقد ثبتت وصلًا؛ إجراءً للوصل مجرى الوقف، فكذلك هذه الألف. كذلك حديث الرسول صلى الله عليه و سلم مَن يلحظ ما جاء فيه من سجع يرى أن هذا المحسن البديعي جاء غير متكلف، واقرأ قوله صلى الله عليه و سلم: ((أنهاكم عن قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال))، وانظر إلى هذا الأدب المحمدي الذي لا ينطق عن الهوى، كيف ينهى صلى الله عليه و سلم عن هذه الخصال الثلاث الذميمة التي هي سبب أكيد في هزيمة الأمة، وانحدارها إلى مهاوي الرذيلة، بسبب هذه الخصلة قيل وقال، وكثرة السؤال، إضاعة المال. ومن كلامه صلى الله عليه و سلم حين ذكر الأنصار قوله: ((أما والله، ما علمتكم إلا لا تقلون عند الطعم، وتكثرون عند الفزع))، فالأنصار لا يلهثون وراء الدنيا ولا وراء عرضها الزائل، وهم عند الجهاد والنصرة لدين الله كثير كأسود الفيافي لا يخافون ولا يخشون أحدًا إلا الله. كلام ما أطيبه وما أعذبه، فالذي حسن السجع هنا المقابلة بين جملتين، وأداة الاستفتاح "أما" وهي تفيد التوكيد والقسم بلفظ الجلالة وطريق القصر بالنفي والاستثناء، ونظير ذلك قوله أيضًا: ((خير المال سكة مأبورة، وفرس مأمورة))، والسجع المقبول الذي يؤثر وتبدو بلاغته في جيد الكلام هو الذي يتحقق فيه اختيار مفردات الألفاظ، واختيار التأليف، وكون اللفظ تابعًا للمعنى لا عكسه، وكون كل واحد من الفقرتين دالَّة على معنى الآخر. وشيخ البلاغيين عبد القاهر هو الذي وضح السجع المقبول بقوله: وعلى الجملة، فإنك لا تجد تجنيسًا مقبولًا، ولا سجعًا حسنًا، حتى يكون المعنى هو الذي طلبه واستدعاه، وساق نحوه، وحتى تجده لا تبتغي به بدلًا، ولا تجد عنه حولًا، فمثال ما جاء من السجع هذا المجيء، وجرى هذا المجرى في لين مقادته، وحل هذا الحل من القبول، قول القائل: اللهم هب لي حمدًا، وهب لي مجدًا، فلا مجد إلا بفعال، ولا مقال إلا بمال، وقول الفضل بن عيسى الرقاشي: سل الأرض، فقل: مَن شق أنهارك؟ وغرس أشجارك؟ وجنى ثمارك؟ فإن لم تجبك حوارًا أجابتك اعتبارًا، وإن أنت تتبعته من الأثر وكلام النبي صلى الله عليه و سلم تثق كل الثقة بوجودك له على الصفة التي قدمت، فإنك لا تجد في جميع ما ذكرت لفظًا اجتلب من أجل السجع، وترك له ما هو أحق بالمعنى، وأبر به وأهدى إلى مذهبه. انتهى من كلام الشيخ عبد القاهر، في: (أسرار البلاغة). ومما اشترطه البلاغيون لتمام السجع وجعله مقبولًا: سكون أواخر الثقل، قال الخطيب، في: (الإيضاح): واعلم أن فواصل الأسجاع موضوعة على أن تكون ساكنة الأعجاز، موقوفًا عليها؛ لأن الغرض أن يزاوج بينها، ولا يتم ذلك في كل سورة إلا بالوقف. ونذكر من ذلك ما جاء في أول سورة الفجر، يقول تعالى: {وَالْفَجْرِ ﴿١﴾ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴿٢﴾ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ﴿٣﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ﴿٤﴾ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ ﴿٥﴾ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿٦﴾ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴿٧﴾ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ﴿٨﴾ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴿٩﴾ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ﴿١١﴾ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ﴿١٢﴾ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴿١٣﴾ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴿١٤﴾} [الفجر:1- 14]، فتسكين أواخر الراء، وأواخر الدال كي يظهر السجع، ولو حركتَ حرف الراء والدال؛ فات الغرض من السجع، وربما يحذف حرف أو يزاد حرف من أجل السجع، ويظهر ذلك جليًّا من غير ما ذكرنا... في آيات سورة الفجر السابقة، فحذف حرف الياء من الفعل يسري بدون جازم، وذلك لتمام الفاصلة، وذلك كحذف حرف الياء أيضًا من الاسم "الواد"، لنفس الغرض، وحذف الياء كثيرًا في القرآن مثل: {أَفَمَن هُوَ قائِمٌ عَلى كُلِّ نَفسٍ بِما كَسَبَت وَجَعَلوا لِلَّـهِ شُرَكاءَ قُل سَمّوهُم أَم تُنَبِّئونَهُ بِما لا يَعلَمُ فِي الأَرضِ أَم بِظاهِرٍ مِنَ القَولِ بَل زُيِّنَ لِلَّذينَ كَفَروا مَكرُهُم وَصُدّوا عَنِ السَّبيلِ وَمَن يُضلِلِ اللَّـهُ فَما لَهُ مِن هادٍ} [الرعد: 33]، و{لَهُ مُعَقِّباتٌ مِن بَينِ يَدَيهِ وَمِن خَلفِهِ يَحفَظونَهُ مِن أَمرِ اللَّـهِ إِنَّ اللَّـهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَومٍ حَتّى يُغَيِّروا ما بِأَنفُسِهِم وَإِذا أَرادَ اللَّـهُ بِقَومٍ سوءًا فَلا مَرَدَّ لَهُ وَما لَهُم مِن دونِهِ مِن والٍ} [الرعد: 11]، {وَالَّذينَ آتَيناهُمُ الكِتابَ يَفرَحونَ بِما أُنزِلَ إِلَيكَ وَمِنَ الأَحزابِ مَن يُنكِرُ بَعضَهُ قُل إِنَّما أُمِرتُ أَن أَعبُدَ اللَّـهَ وَلا أُشرِكَ بِهِ إِلَيهِ أَدعو وَإِلَيهِ مَآبِ وَالَّذينَ آتَيناهُمُ الكِتابَ يَفرَحونَ بِما أُنزِلَ إِلَيكَ وَمِنَ الأَحزابِ مَن يُنكِرُ بَعضَهُ قُل إِنَّما أُمِرتُ أَن أَعبُدَ اللَّـهَ وَلا أُشرِكَ بِهِ إِلَيهِ أَدعو وَإِلَيهِ مَآبِ } [الرعد: 36]، في سورة الرعد، وأصلها: هادي، ووالي، ومآبي، حُذفت جميعها؛ لمراعاة الفاصلة، ومثلها: {دِينِ} في: { لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ} [الكافرون: 6]، وأصلها: ديني، فحذفت الياء؛ مراعاةً للفاصلة. وربما غيَّر العرب الكلمة عن موضعها الصرفي، وذلك طلبًا للسجع، والتوازن الإيقاعي بين طرفي الجملة، وذلك مثل قول الرسول يرقي سِبطيه: ((أعيذكما بكلمات الله التامة من الهامة، والسامة، والعين اللامه))، فاللامة أصلها الملمة من ألمَّ، فعبر بها لموافقتها ما قبلها، وقوله صلى الله عليه و سلم للنساء: ((ارجعن مأزورات غير مأجورات))، والأصل: موزورات من الوزر، لكنه قال ذلك لمكان: ((مأجورات))، وكذلك قوله صلى الله عليه و سلم ((خير المال سكة مأبورة، أو مهرة مأمورة))، فالسكة الطريقة من النخل، ومأبورة أي: ملقحة، و((مهرة مأمورة))، أي: كثيرة النسل، وكان له أن يقول: مؤمرة؛ لأنه: مِن آمرها الله، ولكنه أتبعها قوله: ((مأبورة))، كقولهم: إنه لا يأتينا بالغدايا والعشايا. المراجع والمصادر: 1. القزويني ، زكريا بن محمد القزويني تحقيق: محمد السعدي فرهود ، (الإيضاح في علوم البلاغة) ، طبعة رقم1، سنة النشر: 2001 م . 2. الجرجاني، عبد القاهر الجرجاني، قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكر، (دلائل الاعجاز) ، ط5، مكتبة الخانجي، 2004م. . 3. أبو موسى، د. محمد محمد أبو موسى، (دلالات التراكيب دراسة بلاغية) ، القاهرة، مكتبة وهبة للطباعة والنشر والتوزيع، 1987م . 4. المراغي، أحمد مصطفى المراغي، (تاريخ علوم البلاغة و التعريف برجالها) ، القاهرة، مكتبة و مطبعة مصطفى البابي، ط1، 1950م . 5. فيود ، د. بسيوني عبد الفتاح فيود ، (علم البيان: دراسة تحليلية لمسائل البيان) ، القاهرة، مؤسسة المختار ، دار المعالم الثقافية، الإحساء ، ط 2، 1998 م . 6. الخوارزمي ، الشيخ يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي الخوارزمي الملقب بسراج الدين السكاكي، (مفتاح العلوم) ، لبنان، مكتبة المقهى، نشر دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية ، 1987م. 7. الشاطئ، عائشة بنت الشاطئ، (التفسير البياني) ، مكتبة المجلس، الطبعة الأولى، 1962م. 8. فيود، د. بسيوني عبد الفتاح فيود، (علم البديع: دراسة تاريخية وفنية لأصول البلاغة ومسائل البديع) ،القاهرة، مؤسسة المختار، 2004 . 9. الصعيدي، عبد المتعال الصعيدي، (البغية على الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة) ،مكتبة الآداب، 1999م . 10. شاهين، كامل السيد شاهين، (اللباب في العروض و القافية) ،القاهرة، الهيئة العامة لشئون الأميرية، 1978م. 11. القيرواني، ابن رشيق القيرواني، (العمدة في محاسن الشعر وآدابه) ،الناشر: دار الكتب العلمية، 2001م 12. أبو موسى، د. محمد محمد أبو موسى، (التصوير البياني) ،القاهرة، مكتبة وهبة للطباعة والنشر والتوزيع، 1997م. آراء العلماء في أسلوب السجع من حيث الإباحة والحظر بحث فى دراسات بلاغيه إعداد أ/ د. وليد علي الطنطاوي قسم اللغة العربية كلية اللغات – جامعة المدينة العالمية شاه علم – ماليزيا |
 |
|
|
 |
 |