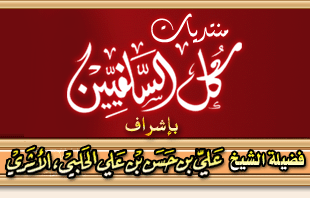


 |
 |
أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
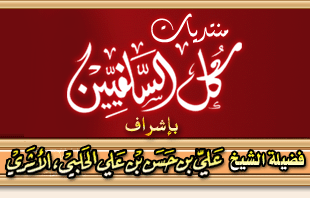 |
 |
 |
|||||
|
|||||||
| 80765 | 98094 |
|
#1
|
|||
|
|||
|
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه . أما بعد ؛ فهذا شرح لحديث طارق بن شهاب رضي الله عنه وللمسائل المستخرجة عليه من كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله – أفردته من شرحي – أسأل الله أن يتمه على خير وبركة - على هذا الكتاب المبارك ؛ لأهميته ولبعض الإشكالات التي أوردت عليه وعلى بعض المسائل التي استخرجها الإمام المجدد – رحمه الله – عليه . وأسأل الله التوفيق والسداد والعون . عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ: (( دَخَلَ اَلْجَنَّةَ رَجُلٌ فِي ذُبَابٍ وَدَخَلَ اَلنَّارَ رَجُلٌ فِي ذُبَابٍ " قَالُوا وَكَيْفَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ ؟ قَالَ مَرَّ رَجُلَانِ عَلَى قَوْمٍ لَهُمْ صَنَمٌ لَا يَجُوزُهُ أَحَدٌ حَتَّى يُقَرِّبَ لَهُ شَيْئًا، فَقَالُوا لِأَحَدِهِمَا قَرِّبْ قَالَ لَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ أُقَرِّبُهُ قَالُوا لَهُ قَرِّبْ وَلَوْ ذُبَابًا فَقَرَّبَ ذُبَابًا ، فَخَلُّوا سَبِيلَهُ ، فَدَخَلَ اَلنَّارَ وَقَالُوا لِلْآخَرِ قَرِّبْ فَقَالَ مَا كُنْتُ لِأُقَرِّبَ لِأَحَدٍ شَيْئًا دُونَ اَللَّهِ "فَضَرَبُوا عُنُقَهُ ; فَدَخَلَ اَلْجَنَّةَ )) . رَوَاهُ أَحْمَدُ. هذا الحديث فيه مسائل : المسالة الأولى : تخريج الحديث : جاء هذا الحديث بجميع طرقه عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي موقوفا عليه ، وهذه تفاصيل طرقه : 1- جاء من طريق الأعمش ، واختلف فيه على الأعمش : أ - فأخرجه أحمد في الزهد ( 1/ 15 ) ، وأبو نعيم في الحلية ( 1/ 203 ) ، والخطيب البغدادي في الكفاية ( 562 ) ، عن أبي معاوية بن خازم الضرير وتابعه جرير بن حازم عن الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب عن سلمان : (( دخل رجل الجنة في ذباب ! ودخل النار رجل في ذباب ! قالوا : وكيف ذلك ؟ قال : مر رجلان [ ممن كان قبلكم ] على قوم لهم صنم ، لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا . فقالوا لأحدهما : قرب [شيئاً ] . قال : ليس عندي شيء ، فقالوا له : قرب ولو ذبابا . فقرب ذبابا ؛ فخلوا سبيله . قال : فدخل النار . وقالوا للآخر : قرب ولو ذبابا . قال : ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل .قال : فضربوا عنقه فدخل الجنة )) ، واللفظ لأحمد وما بين القوسين لأبي نعيم . قال الإمام الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة : (( وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين ؛ غير سليمان بن ميسرة ؛ قال ابن معين : " ثقة " . كما في " الجرح والتعديل " ( 2 / 1 / 143 - 144 ) ، وذكره ابن حبان في " الثقات " ( 4 / 310 ) وقال : " يروي عن طارق بن شهاب الأحمسي ، وله صحبة ، وعنه الأعمش " . وروى عنه حبيب بن أبي ثابت أيضا ، ووثقه آخرون . انظر " التعجيل " ( ص 168 / 423 ) ، فالإسناد صحيح )) . ب - وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان ( 6962 ) ، وابن الأعرابي في معجمه ( 1796) ، من طريق العباس بن محمد الدوري عن محاضر بن المورع عن الأعمش عن الحارث بن شبيل عن طارق بن شهاب عن سلمان قال : (( دخل رجل الجنة في ذباب ! ودخل رجل النار في ذباب ! قالوا : وكيف ذاك ؟ قال : مر رجلان مسلمان على قوم يعكفون على صنم لهم ، فقالوا : قربا لصنمنا قربانا ، قالا : لا نشرك بالله شيئا ، فقالوا : قربوا ما شئتم ولو ذباب ، فقال أحدهما لصاحبه : ما ترى ؟ قال : لا نشرك بالله شيئا ، فقتل فدخل الجنة ، وقال الآخر بيده على وجهه ، فأخذ ذبابا ، فألقاه على الصنم ، فدخل النار )) . قال الإمام الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة : (( وهذا إسناد صحيح أيضا. رجاله ثقات رجال مسلم ؛ غير عباس – وهو ابن محمد الدوري - ، وهو ثقة حافظ )). 2- وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 33583 ) ، فقال : حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن مخارق بن خليفة عن طارق بن شهاب عن سلمان قال : (( دخل رجل الجنة في ذباب! ودخل رجل النار في ذباب! قال : مر رجلان على قوم قد عكفوا على صنم لهم . وقالوا : لا يمر علينا اليوم أحد إلا قدم شيئا ، فقالوا : لأحدهما قدم شيئا ، فأبى فقتل ، وقالوا للآخر : قدم شيئا ، فقالوا قدم ولو ذبابا ، فقال وإيش ذباب ، فقدم ذبابا فدخل النار ، فقال سلمان : فهذا دخل الجنة في ذباب ودخل هذا النار في ذباب )) . قال الإمام الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة : (( وهذا صحيح أيضا. رجاله رجال الشيخين ؛ غير مخارق هذا ، وهو ثقة من رجال البخاري )) . 3- وذكر أبو نعيم رحمه الله في الحلية طرقا أخرى له فقال : (( رواه شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق مثله. ورواه جرير عن منصور عن المنهال بن عمرو عن حيان بن مرثد عن سلمان نحوه )). قال الإمام الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة: (( وبالجملة ؛ فالحديث صحيح موقوفا على سلمان الفارسي رضي الله عنه ؛ إلا أنه يظهر لي أنه من الإسرائيليات التي كان تلقاها عن أسياده حينما كان نصرانيا)) . وقال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله في تيسير العزيز الحميد : (( هذا الحديث ذكره المصنف معزوا لأحمد وأظنه تبع ابن القيم في عزوه لأحمد . قال ابن القيم قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه قال : (( دخل رجل الجنة في ذباب ... )) الحديث ، وقد طالعت المسند فما رأيته فيه فلعل الإمام رواه في كتاب الزهد أو غيره )) . وتعقبه الإمام الألباني رحمه الله بقوله في سلسلة الأحاديث الضعيفة : (( قلت : وفي هذا العزو أمور: أولا : قوله : " يرفعه " خطأ واضح كما يتبين من تخريجنا هذا . ثانيا : إطلاق العزو لأحمد فيه نظر! لأنه يوهم بإطلاقه أنه في " مسنده " ، وليس فيه كما قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى ، ولو كان فيه ؛ لأورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " ، وليس فيه أيضا ، وإنما هو في " الزهد " له كما تقدم . ثالثا : لم يتعد في إسناده طارق بن شهاب ، فأوهم أنه من مسنده! وإنما هو من روايته عن سلمان موقوفا ؛ كما رأيت عند مخرجيه ومن جميع طرقه )) . وقال الشيخ صالح العصيمي حفظه في الدر النضيد : (( ولعله [ أي ابن القيم ] كتبه من حفظه ؛ فوهم ، أو وقع في نسخته غلطا ، فإنه على الجادة المذكورة في غير نسخة من كتاب الزهد للإمام أحمد )) . المسألة الثانية : ترجمة مختصرة لصحابي الحديث : هو طارق بن شهاب بن عبد شمس بن سلمة بن هلال بن عوف بن جشم بن عمرو بن لؤي بن رهم بن معاوية بن أسلم بن أحمس البجلي الأحمسي أبو عبد الله ، رأى النبي صلى الله عليه و سلم وهو رجل ، ويقال: إنه لم يسمع منه شيئا . (( إذا ثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه و سلم فهو صحابي على الراجح وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي وهو مقبول على الراجح )) . قال قيس بن مسلم : سمعته يقول : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وغزوت في خلافة أبي بكر وعمر بضعا وثلاثين ، أو قال: بضعا وأربعين، من بين غزوة وسرية. ومع كثرة جهاده ، كان معدودا من العلماء. مات سنة اثنتين وثمانين أو ثلاث أو أربع ووهم من أرخه بعد المائة وجزم بن حبان بأنه مات سنة ثلاث وثمانين . المسألة الثالثة : شرح الحديث : ( وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ) تبين سابقا أن هذا الحديث موقوف على سلمان رضي الله عنه ( دَخَلَ اَلْجَنَّةَ) التي فيها ما تشتهيه الأنفس ، وتلذ الأعين من أنواع اللذات والأفراح ، والمسرات ، والمنازل الأنيقات ، والحور الحسان ، ورؤية وجه الرحمن . والذي دخل هذه الجنة ( رَجُلٌ فِي ذُبَابٍ ) أي لأجله أو بسببه ، فـ ( في ) في هذا الموضع للسببية ، وليست للظرفية ، ونظيره قوله جل وعلا : ﴿ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( دخلت النار امرأة في هرة حبستها )) ؛ أي : بسبب هرة . ( وَدَخَلَ اَلنَّارَ ) مثوى الحسرة والندم ، ومنزل الشقاء والألم ، ومحل الهموم والغموم ، وموضع السخط من الحي القيوم ، والذي دخل النار (رَجُلٌ فِي ذُبَابٍ ) أي بسبب ذباب أيضا . فلما سمعوا بهذا الخبر استغربوه وتعجبوا منه ، كيف بلغ الذباب إلى هذه الغاية التي بسببه دخل رجل الجنة ورجل دخل النار، أو احتقروه كيف كان تقريب الذباب سببا لدخول الجنة أو النار ، فكأنهم - والله أعلم - تقالوا هذا العمل ؛ لأنهم قد علموا أن الجنة لا يدخلها أحد إلا بالأعمال الصالحة كما قال تعالى : ﴿ ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ﴾ وأن النار لا يدخلها أحد إلا بالأعمال السيئة ، فكأنهم تقالوا ذلك وتعجبوا واحتقروه ، ولهذا ( قَالُوا وَكَيْفَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ ؟ ) وذلك من حرصهم على العلم ؛ فاستفهموا سلمان رضي الله عنه ليبين لهم ما استغربوه ، فبين لهم ما صير هذا الأمر الحقير عندهم عظيما ، يستحق هذا عليه الجنة ، ويستوجب الآخر عليه النار ففصل بعدما أجمل تشويقا للسامع وإيجازا للحكم ليكون أدعى في جمع أطراف المسألة ، فـ ( قَالَ مَرَّ رَجُلَانِ ) أبهم اسميهما ، لأن الحكم يتعلق بعملهما لا باسميهما ، وفي لفظ آخر للحديث ( رجلان مسلمان ) وفي لفظ آخر ( ممن كان قبلكم ) . وكان مرور هذين الرجلين ( عَلَى قَوْمٍ لَهُمْ صَنَمٌ ) وفي لفظ : (قد عكفوا على صنم لهم ) والصنم : هو ما كان على صورة مما يُعبد من دون الله ، يُصوِّر صورة على شكل وجه رجل ، أو على شكل جسم حيوان ، أو رأس حيوان ، أو على شكل صورة كوكب أو نجم ، أو على شكل الشمس و القمر ونحو ذلك ، فإذا صور صورة فتلك الصورة يُقال لها صنم. وقال بعض العلماء : كل ما عبد من دون الله ، بل كل ما يشغل عن الله يقال له صنم. والوثن : هو ما عُبد من دون الله مما هو ليس على شكل صورة . واللام في قوله ( لهم ) للاختصاص ، فهم خصوا أنفسهم بصنم ( لَا يَجُوزُهُ أَحَدٌ ) أي أنهم لا يدعون أحدا يمر به ويتجاوزه ( حَتَّى يُقَرِّبَ لَهُ ) أي يذبح له (شَيْئًا ) نكرة في سياق الشرط ، فتعم جميع الأشياء عظيمها وحقيرها ومثال العظيم : الإبل ، ومثال الحقير : الذباب . وهذا يدل على تعلق أهل الباطل بباطلهم ونصرتهم للباطل، وتواصيهم عليه، وتعاونهم في غرسه والتمكين له بين الناس ؛ فأهل التوحيد أولى بأن يتعلقوا بالحق الذي عندهم والذي هو أوجب الواجبات ، وأن يدعوا الناس إليه ليلا ونهارا ، سرا وجهارا . ( فَـ ) مباشرة لما مر هذان الرجلان بالصنم ( قَالُوا ) بواو الجمع ، وهذا يدل على أن أهل الصنم اتفقوا على ذلك ، وإلا قد لا يحضره إلا سادنه ، ولهذا قال : فقالوا (لِأَحَدِهِمَا قَرِّبْ ) أي اذبح للصنم أي شيء ؛ لأن الأمر هنا مطلق ، فمقصودهم الصورة الظاهرة ، وفي رواية :( فقالوا : قربا لصنمنا قربانا ، قالا : لا نشرك بالله شيئا ) ولا تعارض فقد يحتمل أنهما قالا لهما جميعا ابتداء ثم طلبوا من كل واحد منهما بعد ذلك ، فلما قيل له هذا الكلام وكان ضعيف العلم ، أو ضعيف الإرادة ( قَالَ لَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ أُقَرِّبُهُ ) فاحتج بالعدم . فلما عرفوا موافقته بالذبح لغير الله ، واعتذر طمعوا فيه ، وقنعوا منه بأيسر شيء ؛ لأن قصدهم موافقتهم على ما هم عليه من الشرك . ( قَالُوا لَهُ قَرِّبْ ) يعني اذبح تقربا (وَلَوْ ذُبَابًا ) وإن قلّ تعظيما لصنمهم ، وحفظا لأمرهم حتى لا يختل فيترك ، وجاء بعد هذا في لفظ ( فقال أحدهما لصاحبه : ما ترى ؟ قال : لا نشرك بالله شيئا ) وفي لفظ آخر : ( فقال وإيش ذباب ) كأنه استصغر هذا الأمر واستبعد أن يكون ناقضا لإيمانه ( فَقَرَّبَ ذُبَابًا ) حصل به موافقتهم . ( فَـ ) مباشرة ( خَلُّوا سَبِيلَهُ ) أي تركوه يذهب ( فَـ ) مات ، وبعد موته ( دَخَلَ اَلنَّارَ) وهذا الرجل كما هو ظاهر الحديث لم يكن له عمل يستحق به دخول النار قبل ما فعله مع هذا الصنم ؛ ففيه معنى حديث مسلم الذي تقدم في باب الخوف من الشرك عن جابر مرفوعا : (( من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار)) . فإذا كان هذا فيمن قرب للصنم ذبابا فكيف بمن يستسمن الإبل والبقر والغنم ليتقرب بنحرها وذبحها لمن كان يعبده من دون الله من ميت أو غائب أو طاغوت أو مشهد أو شجر أو حجر أو غير ذلك ؟ وكان هؤلاء المشركون في أواخر هذه الأمة يعدون ذلك أفضل من الأضحية في وقتها الذي شرعت فيه ، وربما اكتفى بعضهم بذلك عن أن يضحي لشدة رغبته وتعظيمه ورجائه لمن كان يعبده من دون الله، وقد عمت البلوى بهذا وما هو أعظم منه. فقف عند هذا وتأمل حكمة الشريعة وسرها في إخلاص العبادة والتعظيم الذي لا ينبغي إلا لله ، ولو بأحقر شيء كالذباب ، فكيف بكرائم الأموال ؟ ( وَقَالُوا لِلْآخَرِ قَرِّبْ ) أي اذبح للصنم أي شيء ؛ لأن الأمر هنا مطلق ، فمقصودهم الصورة الظاهرة، ( فَـ) مباشرة لقوة توحيده وعلمه ، وعظم خوفه من الشرك وعاقبته ( قَالَ مَا كُنْتُ لِأُقَرِّبَ لِأَحَدٍ ) نكرة في سياق النفي فتعم ، أي لا لصنمكم ولا لغيره ( شَيْئًا ) نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء ولو كان ذبابا لما ( دُونَ اَللَّهِ عز وجل ) وقد قطع أطماعهم بهذه الكلمة ، وبين لهم أن هذا الأمر من خصائص الله ، ولا يجوز صرفه لما هو دون الله جل وعلا . فهو بذلك قد دعاهم وأقام عليهم الحجة ؛ ولهذا غضبوا لباطلهم ولآلهتهم الباطلة ، ولما لم يكن لهم من الحجج ما يردون به الحق ؛ اقتفوا آثار إخوانهم من المبطلين تجاه أنبيائهم ( فَضَرَبُوا عُنُقَهُ ) أي قتلوه ( فَدَخَلَ اَلْجَنَّةَ ) أما هم فجزاؤهم كما قال جل وعلا : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ . أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴾ ، وجاء في لفظ : ( فقال أحدهما لصاحبه : ما ترى ؟ قال : لا نشرك بالله شيئا ، فقتل فدخل الجنة ) ولا تعارض لاحتمال أنه قال هذا لصاحبه أولا ثم كررها بوجه هؤلاء المشركين فقتلوه . المسألة الرابعة : مناسبة الحديث للباب : فيه دلالة على أن الذبح لغير الله شرك أكبر ، وفيه جزاء من ذبح لغير الله ، وجزاء من وحّد الله عز وجل وخصه بعبادة الذبح ولم يذبح لغيره . ووجه الدلالة منه على هذه الأمور : 1- أن التقريب للصنم بالذبح كان سببا لدخول النار وذلك لأن من فعله كان مسلما ، وأنه دخل النار بسبب ما فعل ، وهذا يدل على أن الذبح لغير الله شرك أكبر ؛ لأن ظاهر قوله : « دخل النار » يعني : استوجبها مع من يخلد فيها . وإذا كان تقريب هذا الذي لا قيمة له - وهو الذباب - سببا في دخول النار ، فإنه يدل على أن من قرب ما هو أبلغ ، وأعظم منفعة عند أهله وأغلى ، أنه سبب أعظم لدخول النار . 2- أن قوله عن الذي ذبح لغير الله : (( فدخل النار )) ، فيه دلالة على أن من ذبح لغير الله مستوجب للعقاب العظيم وهو دخول النار خالدا فيها . 3- أن قوله عن الذي لم ذبح لغير الله : (( فدخل الجنة )) ، فيه دلالة على أن من لم ذبح لغير الله ، وإنما صرفها لله عز وجل وحده مستحق للنعيم المقيم وهو دخول الجنة خالدا فيها . المسألة الخامسة : كيف دخل الرجل الأول النار مع أن الذي يظهر أنه كان مكرها ؟ لأهل العلم أجوبة عن هذا الإشكال ، أحسنها جوابان : الأول : أنهما كانا مكرهين ، وهذا الحديث وما شابهه مما فيه من عدم إعذار المكرَه ولو بالقتل كان في شرع مَن قبلنا . وأما رفع الإكراه ، أو جواز قول كلمة الكفر ، أو عمل الكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان فهذا خاص بهذه الأمة . قال الإمام الشنقيطي رحمه الله في دفع إيهام الاضطراب : (( إن رفع المؤاخذة مع الإكراه من خصائص هذه الأمة فهو داخل في قوله تعالى: ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾ ويدل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم : (( إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )) . فهو يدل بمفهومه على خصوصه بأمته صلى الله عليه وسلم وليس مفهوم لقب؛ لأن مناط التخصيص هو اتصافه صلى الله عليه وسلم بالأفضلية على من قبله من الرسل واتصاف أمته بها على من قبلها من الأمم. والحديث وان أعله أحمد وابن أبي حاتم فقد تلقاه العلماء قديما وحديثا بالقبول . ومن أصرح الأدلة في أن من قبلنا ليس لهم عذر بالإكراه , حديث طارق بن شهاب في الذي دخل النار في ذباب قربه لصنم مع أنه قربه ليتخلص من شر عبدة الصنم , وصاحبه الذي امتنع من ذلك قتلوه فعلم أنه لو لم يفعل لقتلوه كما قتلوا صاحبه ولا إكراه أكبر من خوف القتل ومع هذا دخل النار ولم ينفعه الإكراه , وظواهر الآيات تدل على ذلك فقوله : ﴿ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذاً أَبَداً ﴾ ظاهر في عدم فلاحهم مع الإكراه ؛ لأن قوله: ﴿ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِم ﴾ صريح في الإكراه وقوله : ﴿ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ مع أنه تعالى قال : (( قد فعلت )) كما ثبت في صحيح مسلم يدل بظاهره على أن التكليف بذلك كان معهوداً قبل, وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ ﴾ مع قوله : ﴿ وَعَصَى آدَمُ رَبَّه ﴾ فأسند إليه النسيان و العصيان معا يدل على ذلك أيضا وعلى القول بأن المراد بالنسيان الترك فلا دليل في الآية . وقوله : ﴿ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ مع قوله : ﴿ كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ﴾ ويستأنس لهذا بما ذكره البغوي في تفسيره عن الكلبي من أن المؤاخذة بالنسيان كانت من الإصر على من قبلنا وكان عقابها يعجل لهم في الدنيا فيحرم عليهم بعض الطيبات )) . الثاني : أن الرجلين في الخبر ليسا بمكرهين ؛ لأنه قال : (( مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا )) ، فظاهر قوله : (( لا يجوزه أحد )) يعني أنهم لا يأذنون لأحد بمجاوزته عن ذلك الطريق حتى يقرب ، وهذا ليس إكراها ؛ إذ يمكن أن يقول : سأرجع من حيث أتيت ولا يجوز ذلك الموضع ويتخلص من أذاهم . فهذا يدل على أن الإكراه بالفعل لم يحصل من أولئك فلا يدخل هذا في قوله : ﴿ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا ﴾ . وقد يرد على هذا أن يقال إن معنى (( لا يجوزه )) : أي حتى يقرب أو يقتل ، وأن هذا عُلم بالسياق ؛ لأنهم قتلوا أحد الرجلين الذي امتنع ، فصار ذلك نوع إكراه . وأجيب : بأنهم ربما قتلوا الذي لم يقرب شيئا ، لأنه أهان صنمهم بقوله : (( ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله )) . والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال كساه ثوب الإجمال وبطل به الاستدلال ، فكيف يُحمل الحديث على شيء مجمل لم يعين . المسألة السادسة : شرح المسائل التي استخرجها المصنف رحمه الله على هذا الحديث : استخرج المصنف رحمه الله على هذا الحديث ست مسائل وهي : اَلثَّامِنَةُ : هَذِهِ اَلْقِصَّةُ اَلْعَظِيمَةُ ، وَهِيَ قِصَّةُ اَلذُّبَابِ . وذلك لما اشتملت عليه من الأمور العظيمة ، والتي منها : 1- عظم تعلق أهل الباطل بباطلهم ونصرتهم للباطل ، وتواصيهم عليه ، وتعاونهم في غرسه والتمكين له بين الناس ، مع أنه على باطل ! ، وهذا يوجب على أهل الحق أن يعظموا الحق الذي عندهم ، ويغرسوه بين الناس . 2- عظم شأن الشرك عند الله جل وعلا بحيث أدنى شيء منه يوجب النار . 3- عظم شأن التوحيد في قلوب الموحدبن ، حيث جاد بروحه ولم يشرك بالله شيئا ولو فقط بالصورة الظاهرة . 4- عظم شأن الآخرة ، وصغر شأن الدنيا ؛ فالذي كان بين دخول هذا النار ودخول ذلك الجنة الموت فقط . 5- عظم عقاب الشرك وهو الخلود في النار . 6- عظم ثواب التوحيد ، وهو الخلود في الجنة ، ومنه بقاء الذكر الحسن في الدنيا . 7- عظم شأن عبادة الذبح حتى عند المشركين ، ولهذا خصوا صنمهم بهذا الأمر . اَلتَّاسِعَةُ: كَوْنُهُ دَخَلَ اَلنَّارَ بِسَبَبِ ذَلِكَ اَلذُّبَابِ اَلَّذِي لَمْ يَقْصِدْهُ ، بَلْ فَعَلَهُ تَخَلُّصًا مِنْ شَرِّهِمْ . قول المصنف رحمه الله : ( اَلَّذِي لَمْ يَقْصِدْهُ ، بَلْ فَعَلَهُ تَخَلُّصًا مِنْ شَرِّهِمْ ) ظاهره يعني أنه كفر بمجرد العمل الظاهر المكره عليه مع أنه لم يقصد التقرب لغير الله بقلبه ، وإنما قصد رفع موجب الإكراه ، وتخريج هذا الحكم من المصنف رحمه الله يحتمل جهتين : الجهة الأولى : أن هذا الحكم خاص بالأمم التي قبلنا ، فعندهم أن من فعل الكفر لداعي الإكراه مع اطمئنان القلب بالإيمان ، فقد خرج من الإسلام إلى الكفر ، ولم يقصد تعميم الحكم على هذه الأمة ، فهذا لا يتعارض مع ما ثبت في شرعنا في قوله تعالى : ﴿ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ﴾ ، وقوله صلى الله عليه وسلم : (( إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه )) . الجهة الثانية : أنه رحمه الله قصد تعميم الحكم على هذه الأمة أيضا ، فمن فعل مكفرا لم يقصده ، وإنما قصد رفع موجب الإكراه ، فإنه يكفر بعد إسلامه . وتخريج هذه الجهة يحتمل أمرين أيضا : الأول : أن المصنف رحمه الله يتبنى قول بعض الأصوليين الذين قالوا : إن الإكراه على الأفعال لا يعد عذرا ، بخلاف الأقوال ؛ فمن فعل شيئا مكفرا أو غيره مكرها لا يعذر . وهذه مسألة خلافية بين علماء الأمة ، وقال الإمام ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد : (( والصواب أيضا : أنه لا فرق بين القول المكره عليه والفعل ، وإن كان بعض العلماء يفرق ويقول : إذا أكره على القول لم يكفر ، وإذا أكره على الفعل كفر ، ويستدل بقصة الذباب ، وقصة الذباب فيها نظر من حيث صحتها ، وفيها نظر من حيث الدلالة ؛ لما سبق أن الفعل المبني على طلب يكون موافقا لهذا الطلب . ولو فرض أن الرجل تقرب بالذباب تخلصا من شرهم ؛ فإن لدينا نصا محكما في الموضوع ، وهو قوله تعالى : ﴿ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ﴾ ، ولم يقل : بالقول ، فما دام عندنا نص قرآني صريح ؛ فإنه لو وردت السنة صحيحة على وجه مشتبه ؛ فإنها تحمل على النص المحكم )) . الثاني : أن المصنف رحمه الله يحكم بكفر من عمل المكفر مطلقا سواء كان قولا أو فعلا ولو لم يقصد ، بل فعله لداعي الإكراه . وقال الإمام ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد : (( هذه المسألة ليست مسلمة ، فإن قوله : قرب ولو ذبابا يقتضي أنه فعله قاصدا التقرب ، أما لو فعله تخلصا من شرهم فإنه لا يكفر لعدم قصد التقرب ، ولهذا قال الفقهاء : لو أكره على طلاق امرأته فطلق تبعا لقول المكره ؛ لم يقع الطلاق ، بخلاف ما لو نوى الطلاق ؛ فإن الطلاق يقع ، وإن طلق دفعا للإكراه؛ لم يقع، وهذا حق لقوله صلى الله عليه وسلم : (( إنما الأعمال بالنيات )) . وظاهر القصة أن الرجل ذبح بنية التقرب ؛ لأن الأصل أن الفعل المبني على طلب يكون موافقا لهذا الطلب . ونحن نرى خلاف ما يرى المؤلف رحمه الله ، أي أنه لو فعله بقصد التخلص ولم ينو التقرب لهذا الصنم لا يكفر ؛ لعموم قوله تعالى : ﴿ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً ﴾ . وهذا الذي فعل ما يوجب الكفر تخلصا مطمئن قلبه بالإيمان )) . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى : (( وَكُلُّ مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ لَا بُدَّ أَنْ يَجِبَ عَلَى الْقَلْبِ فَإِنَّهُ الْأَصْلُ وَإِنْ وَجَبَ عَلَى غَيْرِهِ تَبَعًا فَالْعَبْدُ الْمَأْمُورُ الْمَنْهِيُّ إنَّمَا يَعْلَمُ بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ قَلْبُهُ وَإِنَّمَا يُقْصَدُ بِالطَّاعَةِ وَالِامْتِثَالِ الْقَلْبُ وَالْعِلْمُ بِالْمَأْمُورِ وَالِامْتِثَالُ يَكُونُ قَبْلَ وُجُودِ الْفِعْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ ... وَلِهَذَا كَانَتْ الْأَقْوَالُ فِي الشَّرْعِ لَا تُعْتَبَرُ إلَّا مِنْ عَاقِلٍ يَعْلَمُ مَا يَقُولُ وَيَقْصِدُهُ ... وَالشَّارِعُ لَمْ يُرَتِّبْ الْمُؤَاخَذَةَ إلَّا عَلَى مَا يَكْسِبُهُ الْقَلْبُ مِنْ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ الظَّاهِرَةِ كَمَا قَالَ : ﴿ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ وَلَمْ يُؤَاخِذْ عَلَى أَقْوَالٍ وَأَفْعَالٍ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا الْقَلْبُ وَلَمْ يَتَعَمَّدْهَا ... فَالْمُؤَاخَذَةُ لَمْ تَقَعْ إلَّا بِمَا اجْتَمَعَ فِيهِ كَسْبُ الْقَلْبِ مَعَ عَمَلِ الْجَوَارِحِ فَأَمَّا مَا وَقَعَ فِي النَّفْسِ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْهُ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ أَوْ يَعْمَلْ وَمَا وَقَعَ مِنْ لَفْظٍ أَوْ حَرَكَةٍ بِغَيْرِ قَصْدِ الْقَلْبِ وَعِلْمِهِ فَإِنَّهُ لَا يُؤَاخِذُ بِهِ ... وَأَمَّا إذَا كَانَ يَعْلَمُ مَا يَقُولُ فَإِنْ كَانَ مُخْتَارًا قَاصِدًا لِمَا يَقُولُهُ فَهَذَا هُوَ الَّذِي يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ مُكْرَهًا فَإِنْ أُكْرِهَ عَلَى ذَلِكَ بِغَيْرِ حَقٍّ فَهَذَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ أَقْوَالُهُ كُلُّهَا لَغْوٌ مِثْلُ كُفْرِهِ وَإِيمَانِهِ وَطَلَاقِهِ وَغَيْرِهِ ... وَ " الْمَقْصُودُ هُنَا " أَنَّ الْقَلْبَ هُوَ الْأَصْلُ فِي جَمِيعِ الْأَفْعَالِ وَالْأَقْوَالِ فَمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مِنْ الْأَفْعَالِ الظَّاهِرَةِ فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ مَعْرِفَةِ الْقَلْبِ وَقَصْدِهِ وَمَا أَمَرَ بِهِ مِنْ الْأَقْوَالِ وَكُلُّ مَا تَقَدَّمَ وَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ مِنْ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ إنَّمَا يُعَاقَبُ عَلَيْهِ إذَا كَانَ بِقَصْدِ الْقَلْبِ وَأَمَّا ثُبُوتُ بَعْضِ الْأَحْكَامِ كَضَمَانِ النُّفُوسِ وَالْأَمْوَالِ إذَا أَتْلَفَهَا مَجْنُونٌ أَوْ نَائِمٌ أَوْ مُخْطِئٌ أَوْ نَاسٍ فَهَذَا مِنْ بَابِ الْعَدْلِ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ لَيْسَ هُوَ مِنْ بَابِ الْعُقُوبَةِ )) . قلت : الذي يترجح والله أعلم أن المصنف رحمه يقصد الجهة الأولى من جهتي التخريج ، وهو أن هذا الحكم خاص بالأمم التي قبلنا ؛ ويدل على ذلك كلام المصنف رحمه في موضع آخر من كتبه ، فبعد سرده لنواقض الإسلام في رسالته " نواقض الإسلام العشرة " والتي منها الناقض الأول وهو الشرك ، ومعلوم أن الشرك يكون بالعمل ويكون بالقول أيضا قال رحمه الله: (( ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره )) ، فاستثنى المكره ، وهو من فعل أحد هذه النواقض من غير قصد الكفر ، بل لرفع الإكراه . وكذلك قال في المسألة الثالثة عشرة من مسائل هذا الباب : ( مَعْرِفَةُ أَنَّ عَمَلَ اَلْقَلْبِ هُوَ اَلْمَقْصُودُ اَلْأَعْظَمُ ، حَتَّى عِنْدَ عَبَدَةِ اَلْأَصْنَامِ ) ، فأحال الحكم في هذه المسألة على عمل القلب . تنبيه : استدل بعض من لم ير العذر بالجهل في مسائل التوحيد بحديث طارق بن شهاب رضي الله عنه ، ولا يصح الاستدلال به على عدم العذر بالجهل لأمرين : الأول :أن هذا الحديث موقوف على سلمان رضي الله عنه ولا يعطى له حكم الرفع وإن كان في أمر غيبي ؛ لأن سلمان رضي الله عنه معروف بالأخذ عن أهل الكتاب . وإن ثبت له حكم الرفع فهو شرع من قبلنا ، وهو شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه ، وقد جاء في شرعنا ما يدل عل العذر بالجهل في مسائل التوحيد بشروط وضوابط معروفة ومذكورة في محلها وقد مر ذكر شيء منها . الثاني : لأن هذا الحديث ليس في مسألة العذر بالجهل، و إنما يدخل في العذر بالإكراه ، ولذلك قتلوا من أبى أن يقرب ، ومن قرب دخل النار لأن العذر بالإكراه من خصائص هذه الأمة . وقد يقال إن قول المصنف رحمه الله : ( اَلَّذِي لَمْ يَقْصِدْهُ ) يدل عليه قول الرجل الذي قرب الذباب كما في اللفظ الثالث : ( وإيش ذباب) فكأنه استبعد أن يكون هذا شركا بالله ، وهذا مما يقوي الاستدلال بهذا الحديث على عدم العذر بالجهل حتى عند المصنف رحمه الله . فالجواب من وجهين : الأول : أن مما يدل على أن هذا الذي قرب الذباب لم يكن جاهلا بالحكم اللفظ الثاني للحديث وفيه : (( قالا : لا نشرك بالله شيئا ، فقالوا : قربوا ما شئتم ولو ذباب ، فقال أحدهما لصاحبه : ما ترى ؟ قال : لا نشرك بالله شيئا )) ، فهنا واضح جدا أنه قد علم أن هذا الأمر شرك بالله جل وعلا . الثاني : المصنف رحمه الله فسر قوله : ( اَلَّذِي لَمْ يَقْصِدْهُ ) بقوله : ( بَلْ فَعَلَهُ تَخَلُّصًا مِنْ شَرِّهِمْ ) وهذا ظاهر أنه في الإكراه ، ثم إن المصنف رحمه الله يرى العذر بالجهل بضوابطه المعروفة . قال المصنف رحمه الله في الدرر السنية في الأجوبة النجدية : (( وأما الكذب والبهتان، فمثل قولهم : إنا نكفر بالعموم، ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، وإنا نكفر من لم يكفر، ومن لم يقاتل، ومثل هذا وأضعاف أضعافه ؛ فكل هذا من الكذب والبهتان، الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله . وإذا كنا : لا نكفر من عبد الصنم، الذي على عبد القادر ؛ والصنم الذي على قبر أحمد البدوي، وأمثالهما، لأجل جهلهم، وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله ؟! إذا لم يهاجر إلينا، أو لم يكفر ويقاتل ﴿ سبحانك هذا بهتان عظيم ﴾ )). وقال رحمه الله : (( وأما ما ذكر الأعداء عني، أني أُكَفِّر بالظن وبالموالاة، أو أكفّر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة، فهذا بهتان عظيم ، يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله )) . اَلْعَاشِرَةُ : مَعْرِفَةُ قَدْرِ اَلشِّرْكِ فِي قُلُوبِ اَلْمُؤْمِنِينَ ; كَيْفَ صَبَرَ ذَلِكَ عَلَى اَلْقَتْلِ وَلَمْ يُوَافِقْهُمْ عَلَى طَلَبِهِمْ ، مَعَ كَوْنِهِمْ لَمْ يَطْلُبُوا إِلَّا اَلْعَمَلَ اَلظَّاهِرَ ?!. ( مَعْرِفَةُ قَدْرِ ) أي مقدار الكره والخوف من ( اَلشِّرْكِ ) الذي هو في حقيقته جعل ند لله جل وعلا ( فِي قُلُوبِ اَلْمُؤْمِنِينَ ) الكاملي الأيمان ، فعلى حسب قوة الإيمان والتوحيد ومعرفة العبد بربه ويقينه باليوم الآخر يكون كرهه وخوفه من الشرك بكل أنواعه . روى الإمام احمد وغيره عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله ، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار )) ، قال الإمام السندي رحمه الله في شرح النسائي في شرح قوله : ( وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار ) : (( أَيْ وَأَنْ يَكُون إِيقَاد نَار عَظِيمَة فَوُقُوعه فِيهَا أَحَبّ إِلَيْهِ مِنْ الشِّرْك ، أَيْ: أَنْ يَصِير الشِّرْك عِنْده لِقُوَّةِ اِعْتِقَاده بِجَزَائِهِ الَّذِي هُوَ النَّار الْمُؤَبَّدَة بِمَنْزِلَةِ جَزَائِهِ فِي الْكَرَاهَة وَالنَّفْرَة عَنْهُ ، فَكَمَا أَنَّهُ لَوْ خُيِّرَ بَيْن نَار الْآخِرَة وَنَار الدُّنْيَا لَاخْتَارَ نَار الدُّنْيَا ، كَذَلِكَ لَوْ خُيِّرَ بَيْن الشِّرْك وَنَار الدُّنْيَا لَاخْتَارَ نَار الدُّنْيَا ، وَمَرْجِع هَذَا أَنْ يَصِير الْغَيْب عِنْده مِنْ قُوَّة الِاعْتِقَاد كَالْعِيَانِ ... وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَنْ تَكُون عَقِيدَته مِنْ الْقُوَّة بِهَذَا الْوَجْه، وَمَحَبَّة اللهِ تَعَالَى بِذَلِكَ الْوَجْه، فَهُوَ حَقِيق بِأَنْ يَجِد مِنْ لَذَّة الْإِيمَان مَا يَجِد. وَالله تَعَالَى أَعْلَم )) ، ومن هؤلاء هذا الرجل المذكور في هذا الحديث حيث طلب منه أن يشرك بالله ظاهرا وإلا قتل ، فلم يوافهم واختار القتل فهنيئا له ( كَيْفَ صَبَرَ ذَلِكَ عَلَى اَلْقَتْلِ ) لثبوت إيمانه وتمكنه في جنانه بحيث انشرح صدره والتذ به ( وَلَمْ يُوَافِقْهُمْ عَلَى طَلَبِهِمْ ) لأنه لا شك أن أعظم الذنوب الشرك والكفر، ولذا ورد النهي الشديد عن الوقوع فيه ، وإن ترتب على ذلك إزهاق النفس ، روى ابن ماجه في سننه عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: (( أَوْصَانِي خَلِيلِي أَنْ لَا تُشْرِكْ بِالله شَيْئًا وَإِنْ قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ ، وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا ، فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ ، وَلَا تَشْرَبْ الْخَمْرَ ؛ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ )) . قال الإمام السندي رحمه الله في شرحه : (( قَوْله : «أَنْ لَا تُشْرِك» صِيغَة نَهْي ، وَالْمُرَاد أَنْ لَا تُظْهِر الشِّرْك ، وَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي اِخْتِيَار الْمَوْت وَالْقَتْل دُون إِظْهَار الشِّرْك ، وَالله تَعَالَى أَعْلَم )). ( مَعَ كَوْنِهِمْ لَمْ يَطْلُبُوا إِلَّا اَلْعَمَلَ اَلظَّاهِرَ ?! ) قال الإمام ابن باز رحمه الله في شرح كتاب التوحيد : (( هذا يحتمل أحد أمرين : أ- أن في شريعة من قبلنا ليس فيه العذر بالإكراه ولهذا لم يأخذ بالرخصة ولم يعمل ما يخلصه من شرهم . ب- أنه يمكن أن يكون هناك رخصة ، وعذر بالإكراه ، ولكن لقوة إيمانه وعدم مبالاته بهم لم يأخذ بالرخصة ، وبادر بالإنكار وقال : ( ما كنت لأقرب لأحد شيئاً دون الله عز وجل ) )) ، وقال الإمام ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد : (( هل الأولى للإنسان إذا أكره على الكفر أن يصبر ولو قتل ، أو يوافق ظاهراً ويتأول ؟ هذه المسألة فيها تفصيل : أولاً : أن يوافق ظاهراً وباطناً ، وهذا لا يجوز لأنه رده. ثانياً : أن يوافق ظاهراً لا باطناً ، ولكن يقصد التخلص من الإكراه ؛ فهذا جائز. ثالثاً : أن لا يوافق لا ظاهراً ولا باطناً ويقتل وهذا جائز، وهو من الصبر. لكن أيهما أولى أن يصبر ولو قتل، أو أن يوافق ظاهراً ؟ فيه تفصيل : إذا كان موافقة الإكراه لا يترتب عليه ضرر في الدين للعامة ؛ فإن الأولى أن يوافق ظاهراً ، لا سيما إذا كان بقاؤه فيه مصلحة للناس ، مثل : صاحب المال الباذل فيما ينفع أو العلم النافع وما أشبه ذلك ، حتى وإن لم يكن فيه مصلحة ؛ ففي بقائه على الإسلام زيادة عمل ، وهو خير ، وهو قد رخص له أن يكفر ظاهراً عند الإكراه ؛ فالأولى أن يتأول ، ويوافق ظاهراً لا باطناً. أما إذا كان في موافقته وعدم صبره ضرر على الإسلام ؛ فإنه يصبر ، وقد يجب الصبر؛ لأنه من باب الصبر على الجهاد في سبيل الله، وليس من باب إبقاء النفس، ولهذا لما شكى الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ما يجدونه من مضايقة المشركين؛ قص عليهم قصة الرجل فيمن كان قبلنا بأن الإنسان كان يمشط ما بين لحمه وجلده بأمشاط الحديد ويصبر، فكأنه يقول لهم: اصبروا على الأذى. ولو حصل من الصحابة رضي الله عنهم في ذلك الوقت موافقة للمشركين وهم قلة؛ لحصل بذلك ضرر عظيم على الإسلام. والإمام أحمد رحمه الله في المحنة المشهورة لو وافقهم ظاهراً؛ لحصل في ذلك مضرة على الإسلام )) . الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ : أَنَّ اَلَّذِي دَخَلَ اَلنَّارَ مُسْلِمٌ ; لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَافِرًا; لَمْ يَقُلْ: ( دَخَلَ اَلنَّارَ فِي ذُبَابٍ ). أي أنه كان مسلما ثم كفر بسبب تقريبه الذباب للصنم ، وهذا دل عليه الأثر والنظر ، فأما من الأثر : فعند البيهقي في شعب الإيمان ، وابن الأعرابي في معجمه ورد التصريح بأن كلا الرجلين كانا مسلمين . وأما من النظر : فلأنه لو كان كافراً لم يقل : دخل النار في ذباب ؛ لأنه في الأصل من أهل النار في أعماله ، ولو كان كافراً قبل أن يقرب الذباب ؛ لكان دخوله النار لكفره أولى ، لا بتقريبه الذباب. لكن هنا قال: (دخل النار في ذباب) يعني بسببه ، إذن هو كان مسلما ، وانتقل من الإسلام إلى الكفر بماذا ؟ بسبب الذباب ، فكان تقريبه هو السبب في دخوله النار. وقد يرد على هذا ما رواه البخاري وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : (( دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض )) ، وورد أيضا عن أبي هريرة مثله كما ذكر البخاري رحمه في صحيحه . وقد جاء هذا الحديث في رواية أخرى عند الطيالسي في مسنده ومن طريقه عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند عن علقمة قال كنا عند عائشة فدخل عليها أبو هريرة فقالت : يا أبا هريرة أنت الذي تحدث أن امرأة عذبت في هرة لها ربطتها لم تطعمها ولم تسقها ؟ فقال أبو هريرة : سمعته منه يعني النبي صلى الله عليه وسلم . فقالت عائشة : أتدري ما كانت المرأة ؟ قال : لا .قالت : إن المرأة مع ما فعلت كانت كافرة ؛ إن المؤمن أكرم على الله من أن يعذبه في هرة . فإذا حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر كيف تحدث. فمع كفر المرأة قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((دخلت امرأة النار في هرة )) ، ولم يقل دخلت بسبب كفرها ، فكذلك قول سلمان (( دخل النار رجل في ذباب )) لا يمنع من أن يكون الرجل كافرا في الأصل . والجواب عن هذا : أن الحديث الذي ذكر فيه أن هذه المرأة كافرة إسناده ضعيف ؛ لضعف صالح بن رستم أبي عامر الخزاز . قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على مسلم : (( فظاهر الحديث أنها كانت مسلمة وإنما دخلت النار بسبب الهرة وذكر القاضي أنه يجوز أنها كافرة عذبت بكفرها وزيد في عذابها بسبب الهرة واستحقت ذلك لكونها ليست مؤمنة تغفر صغائرها باجتناب الكبائر هذا كلام القاضي والصواب ما قدمناه أنها كانت مسلمة وأنها دخلت النار بسببها كما هو ظاهر )) . والمصنف رحمه الله قصد بهذه المسألة والله أعلم الرد على الذين قالوا إن المسلم لا يمكن أن يحكم عليه بالكفر إذا أتى بمثل هذه الأعمال الشركية ، كالذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله والنذر لغير الله وما شابه ، وهذه الشبهة روجها كثير من المعارضين لدعوة التوحيد في عصر المصنف رحمه الله ومن بعده ، وحاولوا أن يشوهوا بها دعوة المصنف رحمه الله ، ورموه بأنه يكفر المسلمين . والصواب في هذه المسألة : أن المسلم إذا فعل الشرك ، فإنه بعد قيام الحجة عليه من معتبر ، وتوافر الأسباب والشروط في حقه ، وانتفاء الموانع وزوال الشبه ؛ فإنه يحكم عليه بالكفر بعد إسلامه ، وهذا ما عليه السلف وجميع أهل العلم المعتبرين ، ولهذا يعقد الفقهاء في كتبهم : ( باب حكم المرتد ) ، ويقصدون به المسلم الذي يكفر بع إيمانه . وقد ذكر هذه الشبهة وأجاب عنها المصنف رحمه الله في كتابه " كشف الشبهات " . اَلثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: فِيهِ شَاهِدٌ لِلْحَدِيثِ اَلصَّحِيحِ : ( اَلْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ ). وحتى يتضح كيفية شهادة هذا الحديث لابد من بيان معنى الحديث المستشهد له ، وهذا خلاصة ما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري ،والمناوي في فيض القدير ، والعثيمين في شرح رياض الصالحين رحمهم الله : 1- هذا الحديث يتضمن ترغيباً وترهيباً . يتضمن ترغيباً في الجملة الأولى ، وهي قوله صلى الله عليه وسلم : ( الجنة أقرب إلى أحدكم من سراك نعله ) ، و يتضمن ترهيباً في الجملة الثانية في الحديث ، وهي ، وهي قوله صلى الله عليه وسلم : ( والنار مثل ذلك ). فإذا علم العبد أن الجنة أقرب إليه من شراك النعل ؛ فإنه ينشط على السعي ، فيقول : ليست بعيدة ، وكذلك النار إذا قيل له : إنها أقرب من شراك النعل يخاف ، ويتوقى في مشيه لئلا يزل فيهلك . 2- أن القرب هنا معنوي وإلا فالجنة فوق السماوات السبع قال تعالى ﴿ عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى ﴾ وثبت أن سدرة المنتهى فوق السماء وفي خبر رواه أبو نعيم وغيره أن الجنة في السماء وروى ابن مندة عن مجاهد قلت لابن عباس : أين الجنة قال : فوق سبع سماوات قلت : فأين النار قال : تحت سبعة أبحر مطبقة . 3- ضرب القرب مثلا بالشراك لأن سبب حصول الثواب والعقاب إنما هو سعي العبد ومجرى السعي بالأقدام وكل من عمل خيرا استحق الجنة بوعده ومن عمل شرا استحق النار بوعيده وما وعد وأوعد منجزان فكأنهما حاصلان ، وقد يراد أن سبب دخول الجنة والنار مع صفة الشخص وهو العمل الصالح والسيء وهو أقرب إليه من شراك نعله إذ هو مجاوز له والعمل صفة قائمة به ، وقد يراد أن يسيرا من الخير قد يكون سببا لدخول الجنة وقليلا من المنكر قد يكون سببا للنار ؛ فينبغي للمرء أن لا يزهد في قليل من الخير أن يأتيه ولا في قليل من الشر أن يجتنبه فإنه لا يعلم الحسنة التي يرحمها الله بها ولا السيئة التي يسخط عليه بها ، روى الإمام أحمد وغيره عن بلال بن الحارث المزني أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : (( إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة و إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة )) . وقد يراد أن تحصيل الجنة سهل بتصحيح القصد وفعل الطاعة والنار كذلك بموافقة الهوى وفعل المعصية . فإذا تبين هذا فالشاهد من حديث سلمان لهذا الحديث من وجوه : 1- أنه تضمن ترغيبا وترهيبا ؛ ترغيبا في قوله : ( دخل الجنة رجل ) حتى تعتبر بعمله ، وترهيبا في قوله : ( دخل النار رجل ) حتى تعتبر بعمله . 2- فيه بيان قرب الجنة والنار من الرجلين المذكورين ؛ حيث لم يكن بينهم وبين دخول الجنة إلا الموت ، وهذه مدة يسرة جدا ، وأشار إلى قلة هذه المدة بالفاء التي تدل على التعقيب والترتيب بلا مهلة ، فقال في كل منها ( فدخل ) . 3- يسر وسهولة العمل الذي دخل بسببه كل واحد مهما الجنة والنار ، فالأول دخل النار بسبب تقريبه الذباب الحقير الشأن لغير الله جل وعلا ، والثاني دخل النار بسبب امتناعه من تقريب الذباب الحقير الشأن لغير الله . اَلثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: مَعْرِفَةُ أَنَّ عَمَلَ اَلْقَلْبِ هُوَ اَلْمَقْصُودُ اَلْأَعْظَمُ ، حَتَّى عِنْدَ عَبَدَةِ اَلْأَصْنَامِ. ( مَعْرِفَةُ أَنَّ عَمَلَ اَلْقَلْبِ ) وأعمال القلب هي تحركاته ؛ كالحب ، والخوف ، والرجاء ، والتوكل ، والاستعانة ، وما أشبه ذلك ( هُوَ اَلْمَقْصُودُ اَلْأَعْظَمُ ) عند الله عز وجل والذي عليه مدار الثواب والعقاب ، قال الله جل وعلا : ﴿ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾، وقال سبحانه : ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ ، وقال سبحانه : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ ، وقال سبحانه : ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ . وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم و أموالكم و لكن إنما ينظر إلى قلوبكم و أعمالكم )) ، وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب )) . وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة : (( فإن أعمال القلوب مقصودة ومراده لذاتها بل في الحقيقة أعمال الجوارح وسيلة مرادة لغيرها ؛ فإن الثواب والعقاب والمدح والذم وتوابعها هو للقلب أصلا وللجوارح تبعا ، وكذلك الأعمال المقصودة بها أولاً صلاح القلب واستقامته وعبوديته لربه ومليكه ، وجعلت أعمال الجوارح تابعة لهذا المقصود مرادة ، وإن كان كثير منها مرادا لأجل المصلحة المترتبة عليه فمن اجلها صلاح القلب وزكاته وطهارته واستقامته )) . وقال رحمه الله في مدارج السالكين : (( أن أعمال الجوارح تضاعف إلى حد معلوم محسوب ، وأما أعمال القلوب فلا ينتهي تضعيفها ؛ وذلك لأن أعمال الجوارح لها حد تنتهي إليه وتقف عنده فيكون جزاؤها بحسب حدها ، وأما أعمال القلوب فهي دائمة متصلة وإن توارى شهود العبد لها )) . وقال الإمام ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد : (( ولا شك أن ما قاله المؤلف رحمه الله حق بالنسبة إلى أن المدار على القلب. والحقيقة أن العمل مركب على القلب ، والناس يختلفون في أعمال القلوب أكثر من اختلافهم في أعمال الأبدان ، والفرق بينهم قصداً وذلاً أعظم من الفرق بين أعمالهم البدنية ؛ لأن من الناس من يعبد الله لكن عنده من الاستكبار ما لا يذل معه ولا يذعن لكل حق، وبعضهم يكون عنده ذل للحق، لكن عنده نقص في القصد؛ فتج عنده نوعاً من الرياء مثلاً. فأعمال القلب وأقواله لها أهمية عظيمة، فعلى الإنسان أن يخلصها لله. وأقوال القلب هي اعتقاداته ؛ كالإيمان بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر ، والقدر خيره وشره. وأعماله هي تحركاته ؛ كالحب ، والخوف ، والرجاء ، والتوكل ، والاستعانة ، وما أشبه ذلك . والدواء لذلك : القرآن والسنة ، والرجوع إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بمعرفة أحواله وأقواله وجهاده ودعوته، هذا مما يعين على جهاد القلب. ومن أسباب صلاح القلب أن لا تشغل قلبك بالدنيا )) . تنبيه : لا يعني بيان أهمية أعمال القلوب ، وأنها أشرف من أعمال الجوارح أن نهمل أعمال الجوارح . قال الإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان : (( وقصر بقوم حتى أهملوا أعمال القلوب ولم يلتفتوا إليها وعدوها فضلا أو فضولا وتجاوز بآخرين حتى قصروا نظرهم وعملهم عليها ولم يلتفتوا إلى كثير من أعمال الجوارح وقالوا : العارف لا يسقط وارده لورده )) . وقال رحمه الله في بدائع الفوائد : (( أن لله على العبد عبوديتين : عبودية باطنة ، وعبودية ظاهرة ؛ فله على قلبه عبودية ، وعلى لسانه وجوارحه عبودية ، فقيامه بصورة العبودية الظاهرة مع تعريه عن حقيقة العبودية الباطنة مما لا يقربه إلى ربه ولا يوجب له الثواب وقبول عمله ؛ فإن المقصود امتحان القلوب وابتلاء السرائر ، فعمل القلب هو روح العبودية ولبها ، فإذا خلا عمل الجوارح منه كان كالجسد الموات بلا روح ، والنية هي عمل القلب الذي هو ملك الأعضاء ، والمقصود بالأمر والنهي ، فكيف يسقط واجبه ويعتبر واجب رعيته وجنده وأتباعه اللاتي إنما شرعت واجباتها لأجله ولأجل صلاحه ؟ وهل هذا إلا عكس القضية وقلب الحقيقة ؟ والمقصود بالأعمال كلها ظاهرها وباطنها إنما هو صلاح القلب وكماله وقيامه بالعبودية بين يدي ربه وقيومه وإلهه ، ومن تمام ذلك قيامه هو وجنوده في حضرة معبوده وربه ، فإذا بعث جنوده ورعيته وتغيب هو عن الخدمة والعبودية فما أجدر تلك الخدمة بالرد والمقت ، وهذا مثل في غاية المطابقة . وهل الأعمال الخالية عن عمل القلب إلا بمنزلة حركات العابثين ؟وغايتها أن لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب ! ولما رأى بعض أرباب القلوب طريقة هؤلاء ؛ انحرف عنها إلى أن صرف همه إلى عبودية القلب وعطل عبودية الجوارح ! وقال : المقصود قيام القلب بحقيقة الخدمة والجوارح تبع ، والطائفتان متقابلتان أعظم تقابل ؛ هؤلاء لا التفات لهم إلى عبودية جوارحهم ؛ ففسدت عبودية قلوبهم ، وأولئك لا التفات لهم إلى عبودية قلوبهم ؛ ففسدت عبودية جوارحهم ، والمؤمنون العارفون بالله وبأمره قاموا له بحقيقة العبودية ظاهرا وباطنا ، وقدموا قلوبهم في الخدمة ، وجعلوا الأعضاء تبعا لها فأقاموا الملك وجنوده في خدمة المعبود وهذا هو حقيقة العبودية . ومن المعلوم أن هذا هو مقصود الرب تعالى بإرساله رسله وإنزاله كتبه وشرعه شرائعه فدعوى المدعي أن المقصود من هذه العبودية حاصل وإن لم يصحبها عبودية القلب من أبطل الدعاوي وأفسدها والله الموفق . ومن تأمل الشريعة في مصادرها ومواردها علم ارتباط أعمال الجوارح بأعمال القلوب ، وأنها لا تنفع بدونها ، وأن أعمال القلوب أفرض على العبد من أعمال الجوارح . وهل يميز المؤمن عن المنافق إلا بما في قلب كل واحد منهما من الأعمال التي ميزت بينهما ؟ وهل يمكن أحد الدخول في الإسلام إلا بعمل قلبه قبل جوارحه ؟ وعبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح وأكثر وأدوم فهي واجبة في كل وقت ؛ ولهذا كان الإيمان واجب القلب على الدوام ، والإسلام واجب الجوارح في بعض الأحيان ، فمركب الإيمان القلب ومركب الإسلام الجوارح )) . وقول المصنف رحمه الله : ( حَتَّى عِنْدَ عَبَدَةِ اَلْأَصْنَامِ ) أي لكونهم قالوا : (( قرب ولو ذبابا )) فقصدوا استمالة قلبه ولو لم يريدوا ذلك لما اكتفوا بالذباب ؛ لأنه لا فائدة فيه لأكل ونحوه . فالمهم هو قصد القلب ، وفي كثير من الأحيان هناك أمارات قوية تدل على القصد لا يمكن دفعها بمجرد القول بأنه لم يقصد ، فكثير من الذين ينحرون لغير الله وقد يذكرون اسم الله على الذبيحة ، لكنهم يقصدون في الحقيقة التقرب بها إلى غير الله ، وعندما يبين لهم وتقام عليهم الحجة بأن هذا شرك لا يرضاه الله يسارع ويقول لم أقصد يذلك التقرب إلى هذا المخلوق وعبادته وهذا لا يغير من حقيقة الأمر شيئا . قال الإمام الشوكاني رحمه الله في الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد : (( وكذلك النحر للأموات عبادة لهم ، والنذر لهم بجزء من المال عبادة لهم ، والتعظيم عبادة لهم ، كما أن النحر للنسك وإخراج صدقة المال والخضوع والاستكانة عبادة لله عز وجل بلا خلاف ، ومن زعم أن ثم فرقا بين الأمرين فليهده إلينا ، ومن قال أنه لم يقصد بدعاء الأموات والنحر لهم والنذر عليهم عبادتهم ، فقل له فلأي مقتض صنعت هذا الصنيع ؟ فإن دعاؤك للميت عند نزول أمر بك لا يكون إلا لشيء في قلبك عبر عنه لسانك ، فإن كنت تهذي نزول بذكر الأموات عند عروض الحاجات من دون اعتقاد منك لهم فأنت مصاب بعقلك ! وهكذا إن كنت تنحر لله فلأي معنى جعلت ذلك للميت وحملته إلى قبره ؟ فإن الفقراء على ظهر البسيطة في كل بقعة من بقاع الأرض ، وفعلك وأنت عاقل لا يكون إلا لمقصد قد قصدته أو أمر قد أردته وإلا فأنت مجنون قد رفع عنك القلم ، ولا نوافقك على دعوى الجنون إلا بعد صدور أفعالك وأقوالك في غير هذا على نمط أفعال المجانين ، فإن كنت تصدرها مصدر أفعال العقلاء فأنت تكذب على نفسك في دعواك الجنون في هذا الفعل بخصوصه فرارا عن أن يلزمك ما لزم عباد الأوثان الذين حكى الله عنهم في كتابه العزيز ما حكاه بقوله : ﴿ وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا ﴾ ، وبقوله : ﴿ ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ﴾ )) . وقال الإمام الصنعاني رحمه الله في تطهير الاعتقاد : (( فإن قال: إنَّما نحرتُ لله وذكرتُ اسمَ الله عليه. فقل: إن كان النَّحرُ لله فلأيِّ شيء قَرَّبت ما تنحرُه مِن باب مَشهد مَن تفضله وتعتقد فيه؟ هل أردت بذلك تعظيمه؟ إن قال: نعم! فقل له: هذا النَّحر لغير الله، بل أشركت مع الله تعالى غيره، وإن لَم تُرد تعظيمه، فهل أردت توسيخ باب المشهد وتنجيس الداخلين إليه؟ أنتَ تعلمُ يقيناً أنَّك ما أردت ذلك أصلاً، ولا أردت إلاَّ الأول، ولا خرجتَ من بيتك إلاَّ قصداً له، ثم كذلك دعاؤهم له )). وقال رحمه الله أيضا : (( فإن قلتَ: هذه النذورُ والنحائرُ ما حكمها ؟ قلتُ : قد عَلِمَ كلُّ عاقل أنَّ الأموالَ عزيزةٌ عند أهلها، يَسعون في جَمعها ولو بارتكاب كلِّ معصية، ويَقطعون الفيافِيَ مِن أدنى الأرض والأقاصي، فلا يبذلُ أحدٌ مِن ماله شيئاً إلاَّ معتقداً لِجلب نفعٍ أكثرَ منه أو دفع ضرٍّ، فالنَّاذرُ للقبر ما أخرَج مالَه إلاَّ لذلك، وهذا اعتقادٌ باطل، ولو عرَفَ النَّاذرُ بطلانَ ما أراده ما أخرَجَ درهماً، فإنَّ الأموالَ عزيزةٌ عند أهلها، قال تعالى: ﴿ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ . إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ ﴾ )) . والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .
|
 |
|
|
 |
 |